عربيةDraw : بحسب بيانات شركة ( HKN إينرجي) الاميركية: ارتفعت الايرادات في حقل( سرسنك) النفطي في النصف الاول من عام 2022 بنسبة ( 80%) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وبسبب زيادة حجم الانتاج في الحقل بنسبة ( 3%) بلغ حجم الانتاج في النصف الاول من عام 2022 (29.7 ) الف برمیل يوميا في حين بلغ حجم الانتاج في نفس الفترة من عام 2021 نحو (28.9 الف) برمیل يوميا بلغ حجم الانتاج الكلي لحقل ( سرسنك) منذ بدء العمل فيه وحتى 30 حزيران 2022 نحو(47.6 ملیون) برمیل. حقل سرسنك النفطي يقع حقل( سرسنك) في محافظة دهوك، يبلغ مساحة الحقل نحو (420) کیلومتر مربع، ينقسم الحقل الى قسمين مختلفين ( منطقة سوارة توكة وشرق سوارة توكة) وتوجد في هاتين المنطقتين ( 3) مستودعات نفطية مستقلة.الحقل يستثمرمن قبل شركتين أجنبيتين، أحداهما أميركية وهي شركة ( HKN إينرجي) وتملك نسبة ( 62%) من الحقل، والشركة ألاخرى المستثمرة هي شركة ( توتال) الفرنسية وتملك نسبة ( 18%) من الحقل، وتملك حكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%) من الحقل وفق البيانات الاخيرة التي كشفت عنها الشركة الاميركية، فأن القدرة الانتاجية لحقل ( سرسنك) بالشكل التالي: اولا- منطقة (سوارة توكة)، تقع في هذه المنطقة( 6) أبارنفطية، ويبلغ القدرة الانتاجية لهذه الابار نحو( 29) الف برميل يوميا، يتم نقل الانتاج عبرالصهاريج الى معبر( فيشخابور) ثانيا- منطقة شرق سوارة توكة، توجد في هذه المنطقة ( بئر نفطي واحد)، وتصل القدرة الانتاجية للبئر نحو( 2 الف و 500) برميل نفط يوميا. تأسست شركة( HKN إينرجي) الاميركية في عام 2007 من قبل ( روس بيروت جونيور) وهي شركة خاصة تعمل في مجال الطاقة والاستكشافات النفطية ، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ( دالاس) الاميركية ولها فروع في تكساس و أربيل بإقليم كوردستان. وحسب البيانات الاخيرة للشركة في النصف الاول من عام 2022: ارتفعت الايرادات في حقل ( سرسنك) النفطي في النصف الاول من عام 2022 بنسبة( 80%) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وذلك بسبب أرتفاع أسعار النفط وبسبب زيادة حجم الانتاج في الحقل بنسبة ( 3%)، حصلت الشركة في هذه الفترة على أرباح من بيع النفط تقدر بنحو ( 178) مليون دولار، وحصلت أيضا في شهر تموز الماضي فقط على أرباح تقدر بنحو (33.6 ملیون) دولار. تقدر قيمة المجموع الكلي للاستثماراتها منذ عام ( 2007) أكثر من (1.9 ملیار) دولار. ساهمت الشركة بنحو ( 4) مليار دولار في تنمية الانتاج المحلي لإقليم كوردستان خلال ( 15) عاما الماضية. وساهمت الشركة أيضا في توفير( 59) الف فرصة عمل حتى نهاية عام 2021.
عربيةDraw : كشفت مصادر سياسية مطلعة في بغداد، عن بدء تحالف الإطار التنسيقي مناقشات داخلية لاستبدال مرشحه الحالي لتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني، تماشيا مع الأجواء الإيجابية التي سادت في الساعات الأخيرة. وثمّن تحالف الإطار التنسيقي الموقف الأخير لتحالف "السيادة"، أكبر التكتلات السياسية للعرب السنة في العراق، والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، ، حيال موقفهما الجديد بشأن ضرورة تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة، والذي صدر عقب اجتماع الطرفين في أربيل الأول من أمس الأحد. وفي هذا السياق، قال مصدران سياسيان في بغداد، إن تحالف "الإطار التنسيقي" بدأ فعليا بمناقشة استبدال مرشحه الحالي محمد شياع السوداني في تشكيل الحكومة الجديدة، على اعتبار كونه مرفوضا من مقتدى الصدر، وإمكانية أن يفهم الإصرار عليه محاولة كسر إرادات موجهة للتيار الصدري، الذي أعلن صراحة عن رفضه له في وقت سابق. وقال أحد المصدرين، إن استئناف عمل البرلمان "سيكون قريبا بعد الانتهاء من مراسم الزيارة الدينية.. الأسبوع المقبل سيتضح ذلك، لكن هذا الشهر ستكون هناك جلسات للبرلمان". وأكد أن "التحفظ على محمد شياع السوداني ليس من التيار الصدري فقط، لكن هناك أطراف سياسية سنية وكردية، وأيضا من داخل تحالف الإطار التنسيقي، لا ترغب بوجوده على رأس الحكومة المقبلة، كونه محسوبا على رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي". كما كشف المصدر الآخرعن "تداول أسماء بديلة عن السوداني، من بينها حيدر العبادي، وعدنان الزرفي محافظ النجف السابق، وأسعد العيداني محافظ البصرة الحالي، وهناك أسماء أخرى، بعضها مطروح بصفتهم خيارا وسط وغير محسوبين على أي من أطراف الأزمة، وكذلك هناك طرف يرحب بمصطفى الكاظمي لبقائه في الحكومة عاما آخر، وهذا كله سيحسم خلال اجتماعات لقوى الإطار التنسيقي مقررة هذا الأسبوع". وعن موقف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أوضح المصدر ذاته أنه "يواصل رفض فتح أي حوار مع أي طرف، وهو ما يعزز مخاوف إمكانية عدم استقرار أي اتفاق يجري التوصل إليه"، وفقا لقوله. في السياق ذاته، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي عن عزم عدد من قادة القوى السياسية تشكيل وفد لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف في الأيام المقبلة. وأوضح المندلاوي، في تصريحات للصحافيين اليوم الثلاثاء، أن "الإطار يجب أن يكون متساهلا في ملف اختيار رئيس الحكومة، وأن وفدا قياديا كبيرا سيتوجه إلى الحنانة للقاء الصدر وإيجاد تفاهم مشترك، من ضمنهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، وزعيم كتلة الفتح هادي العامري"، معتبرا أن الحكومة العراقية هي "حكومة تصريف أعمال لا يمكنها الإشراف على الانتخابات، لذلك يجب أن يتم تشكيل حكومة بصلاحيات واسعة". المصدر: العربي الجديد
عربيةDraw : بغداد - أثار استقبال رجل الأعمال العراقي ورئيس تحالف السيادة السني خميس الخنجر لرئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان في العاصمة بغداد جدلا واسعا على الساحة السياسية في العراق، لاسيما وأن الخنجر لا يملك أي صفة رسمية تخول له عقد مثل هذه اللقاءات. وتقول دوائر سياسية إن استضافة الخنجر لفيدان في مقر إقامته بحضور عدد من نواب وقيادات ائتلاف السيادة، يشي بتنامي النفوذ السياسي لأنقرة في العراق من خلال توثيق روابطها مع المكون السني بالتوازي مع علاقتها القوية بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يدير إقليم كردستان في شمال العراق، وبالجبهة التركمانية التي يتركز نفوذها في كركوك والموصل. وتوضح الدوائر أن اللقاء المعلن بين الخنجر وفيدان هو رسالة من تركيا للخارج بأنها باتت تملك اليد الطولى في قرار المكون السني في العراق، وتشير الدوائر نفسها إلى أن هذه الزيارة تقدم النقيض لما يروج له الائتلاف السني وحلفاؤه لاسيما التيار الصدري عن الدفاع عن سيادة البلاد المهدورة. ولا تستبعد الدوائر أن يكون اللقاء جرى بعد تفاهمات تمت بين أنقرة وطهران لناحية إقناع ائتلاف السيادة بضرورة مراعاة مطالب الإطار التنسيقي بشأن إتمام الاستحقاقات الدستورية، خصوصا وأن قيادات الإطار، وعلى خلاف العادة، لم تعلّق على هذه الزيارة. وتوضح الدوائر أنه من المرجح أن يطرح الطرفان خيار إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة، وأن هذا المقترح لا يلقى تحفظات من إيران، كما أنه قد يمثل حلا وسطا بالنسبة إلى الأزمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. وأجرى رئيس الاستخبارات التركية زيارة إلى بغداد السبت هي الأولى لمسؤول تركي رفيع المستوى إلى العراق بعد الهجوم التركي الذي استهدف في يوليو الماضي قرية سياحية في محافظة دهوك شمال العراق، وأدى إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى، وكاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين أنقرة وبغداد. والتقى فيدان خلال الزيارة برئيس حكومة تصريف الأعمال، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعدد من المسؤولين العراقيين، قبل أن يخص زعيم ائتلاف السيادة بزيارة لم يتم الكشف عن فحواها. وسبق أن التقى الخنجر بفيدان خلال الأشهر القليلة الماضية في أنقرة، وقبل ذلك حظي مع شريكه في رئاسة ائتلاف السيادة رئيس مجلس النواب باستقبال لافت من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير الماضي، وكان ذلك الاستقبال جرى بحضور رئيس الاستخبارات التركية الذي بات الممسك بالملف السياسي العراقي. وذكرت مصادر مقربة من ائتلاف السيادة حينها أن لقاء أردوغان بالخنجر والحلبوسي كان الغرض منه حينها بحث الحصة السنية من الحكومة العراقية المقبلة لاسيما في علاقة بوزارة الدفاع، قبل أن يتم تجميد هذا الملف على ضوء عدم اتفاق الفرقاء العراقيين ولاسيما الشيعة على كيفية إدارة العملية السياسية. وكانت تركيا ممثلة في رئيس الاستخبارات قد لعبت دورا أساسيا في إنهاء الخصومة بين الخنجر والحلبوسي ودفعهما إلى التحالف لضمان التحكم في القرار السياسي للمكون السني. ويرى مراقبون أن الغرض من استضافة الخنجر لفيدان هو بحث الأزمة السياسية المستفحلة في العراق، وسبل تعاطي ائتلاف السيادة معها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع الضغوط المتزايدة التي يواجهها الأخير من الفريقين الشيعيين المتضادين. ويطالب التيار الصدري ائتلاف السيادة بالانسحاب من البرلمان العراقي في محاولة لضرب شرعية المجلس، في المقابل يضغط الإطار التنسيقي، الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، على رئيس مجلس النواب باتجاه استئناف جلسات البرلمان بعد الاحتفال بالزيارة الأربعينية لاستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية الممثلة في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. ويرى المراقبون أن الموقف التركي سيكون محددا في قرار ائتلاف السيادة، والأقرب أن يكون موازنا بين الإطار والتيار. وعقب الزيارة المثيرة للجدل لرئيس الاستخبارات التركية، قام رئيس ائتلاف السيادة وشريكه رئيس مجلس النواب بزيارة الأحد إلى أربيل، حيث اجتمعا بحليفهما زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. وذكر بيان لمقر بارزاني أن الجانبين “استعرضا الوضع السياسي في العراق وتداعياته السلبية على البلاد وضرورة اعتماد لغة الحوار البناء لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة”. وأضاف البيان أن “الطرفين أكدا على أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بع وأبدى الجانبان استعدادهما للمساهمة البناءة في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف واستعدادهما لتبني أي خطوة تخدم المصلحة الوطنية وتساهم في السلم المجتمعي والحفاظ على أمن المواطنين ومصالحهم. كما أكد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني على استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتبني مواقف مشتركة تخدم المصالح الوطنية العليا، وفقا للبيان. وأظهرت تركيا منذ العام 2014 رغبة في تعزيز حضورها في المشهد السني العراقي من خلال الرهان على الحزب الإسلامي العراقي الذي يشكل الواجهة السياسية لجماعة الإخوان، لكن هذا الرهان أثبت عقمه، فتوجهت أنقرة نحو استقطاب العديد من وجهاء العشائر والشخصيات السياسية من مختلف التلوينات الفكرية والأيديولوجية. ويرى المراقبون أن الحرص التركي على المكون السني يندرج في سياق مساعي أنقرة لتركيز نفوذ يوازي نفوذ طهران على المكون الشيعي، لكن دون أن يصل الأمر حد التصادم بين الجانبين. واعتبر المحلل السياسي رياض الوحيلي الأحد، أن تواجد رئيس المخابرات التركية السبت في العراق في ظل القصف التركي المستمر انتهاك واضح للسيادة، معتبرا أن “تواجده مع شخصيات سياسية يدل على التدخل في الشأن السياسي العراقي”. وقال الوحيلي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “زيارة رئيس المخابرات التركية إلى العراق ولقاءه مع رؤساء كتل سياسية مثل خميس الخنجر تجاوز واضح للأعراف الدبلوماسية المعمول بها في العلاقات الدولية بين البلدان”. وأوضح أن “وجود الشخصيات التركية داخل العراق يمثل انتهاكا صريحا للسيادة في ظل القصف المستمر من قبل الطائرات التركية للقرى والأقضية العراقية مستغلة الضعف الواضح لدى الحكومة العراقية”. وأضاف أنه “مع وجود الأزمة السياسية في انعقاد البرلمان والمناكفات بين الكتل السياسية، فإن وجود رئيس الاستخبارات التركية يدل على تدخلهم بالشأن العراقي من خلال التأثير على بعض الكتل السياسية ومحاولة عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة”.مله إلى حين موعد الانتخابات”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية
عربية Draw: العالم الجديد/ أيلول 2022 عباس علي موسى وفريق من الصحفيين السوريين تقضي نور (28 سنة) عامها الثالث مع طفلها وأمها في مخيم الهول جنوب شرق محافظة الحسكة السورية، وتحلم على الدوام بالعودة إلى حياتها الأسرية الهانئة وبيتها الذي لا يفارق مخيلتها في مدينة “حديثة” بمحافظة الأنبار غربي العراق .لكنها تخشى، مثل نحو ثلاثين الف عراقي آخر يعيشون في المخيم الذي يصفه مراقبون بأنه حاضنة الجيل الجديد لمقاتلي التنظيم، ان ذلك سيظل حلماً بعيد المنال، بسبب شقيقين لها انتميا لتنظيم داعش وتسببا باعتقال والدها وزوجها وشقيقها الأصغر في العراق، وتخلي جميع الأقارب عنهم، ولم يعد مسموحاً لعائلتها الصغيرة العودة إلى “حديثة” بموجب قرار عشائري. “نعيش في هذا الجحيم، ولا نعرف خلاصا” تقول بعيون دامعة وهي تفترش الأرض قرب خيمتها في القسم الرابع من المخيم، ثم تمسك بكم ردائها الأسود وتروي كيف أن هذا اللون لم يكن معروفاً في منطقتها قبل أن يصل مقاتلو تنظيم داعش براياتهم السود ويتحكموا بمصير المدينة ويقلبوا حياتها وباقي أفراد أسرتها، رأساً على عقب. "انضم شقيقي الأكبر إلى التنظيم في 2015، فتحول بيتنا إلى حلبة صراع بسبب غضب أبي منه ورفضه لما فعله، وبعد سنة لحق به أخي الصغير، فخشي أبي على حياتي، ووافق على شاب لا علاقة له بالتنظيم تقدم لخطبتي وزوجني إياه حتى دون أن يستشيرني” تقول نور ذلك، وكأنها تقرأ جزءاً من سيرتها الذاتية مكتوباً أمام عينيها بكلمات غير مرئية. في 2016 اعتقلت القوات العراقية والدها وزوجها وشقيقها الأوسط بتهمة الانتماء للتنظيم، فيما كانت هي مع أمها قد انتقلت إلى الباغوز برفقة عشرات العوائل الاخرى، حيث استخدمهم التنظيم كدروع بشرية أو رهائن وفقاً لما تقوله نور، وهناك سمعت بأن شقيقاها المنتمين للتنظيم قتلا خلال المعارك “كنت حاملاً، وأمي مريضة وشهراً بعد شهر تضيق علينا الحياة دون أن نعرف ما يتوجب علينا فعله حتى اندلعت حرب تحرير الباغوز في 2019 ولجأنا أنا وطفلي مع أمي الى مخيم الهول”. وبسبب صعوبة الحياة وقلة السلال الغذائية التي تصلهم، ولكونها المعيلة الوحيدة لأمها وطفلها، اضطرت نور للعمل مع إحدى المنظمات العاملة بالمخيم، وتلقت بإثر ذلك الكثير من التهديدات بالتصفية من قبل نساء أو رجال متشددين من مختلف أقسام المخيم متهمين إياها بالعمل لدى “جهات كافرة”. ويشهد مخيم الهول الذي يصفه ناشطون بدولة داعش الصغيرة، عمليات قتل متوالية، تستهدف عادة اشخاص يتهمون بالتعاون مع ادارة المخيم أو أناس لا تتوافق توجهاتهم مع الفكر التكفيري الذي يسود في المخيم. وشهد الهول، بحسب مصادر الادارة الذاتية لشمال سوريا، مقتل 44 شخصا خلال الأشهر الثمان الاولى من العام 2022، بينهم 14 امرأة. وتم في الخامس من أيلول سبتمبر الكشف عن تحرير ثلاث نساء مكبلات بالسلاسل وعليهن آثار تعذيب، فضلا عن تحرير فتاة ايزيدية كانت محتجزة. "كلما أشرقت الشمس، أشكر الله لأنني مازلت حية، المخيم مرعب وموحش جداً حين يهبط الظلام ويغرق كل شيء بالعتمة” تقول بامتنان ممزوج بالخوف، مؤكدة أن عليها مواصلة العمل وتحمل كل شيء لإعالة طفلها ووالدتها التي تحاول باستمرار مواساتها وبث الأمل في نفسها بإخبارها أن والدها وشقيقها وزوجها سيخرجون قريباً وسيقومون بنجدتهم، مع أنها تدرك في قرارة نفسها بأن ذلك قد لا يحدث أبداً. نهضت من مكانها سريعا وكأنها تذكرت شيئا مهما، وسارت بضع خطوات قبل ان تنحني لالتقاط دلو ماء بلاستيكي أحمر اللون، سقت به مجموعة من شتلات الباقلاء واللوبياء زرعتها في علب حليب معدنية ورصتها بواجهة الخيمة، تقول بترنيمة تشبه لحن أغني عراقية حزينة” يا ليت الآمال تنمو بداخل الإنسان مثلما تنمو هذه الشلات” مثل مئات العائلات العراقية اللاجئة في المخيم، تحيط نور نفسها وعائلتها بأسوار عديدة، وتتجنب مخالطة معظم جيرانها، وتحرص ان تظل صامتة، خوفا من أن ينقل أي كلام لها لا يعجب المؤمنين بفكر داعش، الى مسؤولين يحكمون المخيم باسم التنظيم ويصدرون فتاوى التكفير وأوامر الانتقام والقتل. ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حزيران يونيو الوضع في المخيم بأنه “كارثي”، مشددة على توفير “مساحة آمنة” إضافية لحماية النساء والفتيات من الهجمات. يؤكد موظف اداري في الهول، رفض ذكر اسمه، أجواء الرعب التي يشهدها المخيم، خاصة في بعض أجنحته. ويقول انها بمثابة واحة لنمو الفكر المتشدد “هنا كل شيء يغذي غول العنف الذي يتغلغل في نفوس الأطفال. يجب ان يتوقف ذلك، وأن يتم تفكيك المخيم، لكن كيف والدول الأخرى بما فيه العراق ترفض استقبال مواطنيها”. ويضيف: “العراقيون يشكلون ثلاثة أضعاف السوريين هنا، وهم يعيشون تحت ضغوط خسارة أحبتهم، وفقدان حريتهم، وفقر حالهم، والفكر المتشدد المحيط بهم، والانتقام الذي يسري في دم الكثيرين منهم، وهم ينقلونه الى الجيل الجديد”. حاضنة التنظيم ودولة أشباله يعيش في مخيم الهول المترامي الاطراف والذي يقع في البلدة التي تحمل ذات الاسم وتقع على بعد 40كم جنوبي شرق الحسكة ونحو 10 كلم عن الحدود العراقية، 56 ألف شخص، من اللاجئين والنازحين الفارين من داعش وكذلك المحتجزين من نساء وأطفال عناصر التنظيم. أكثر من نصف العدد الكلي عراقيون وغالبية هؤلاء من الفتيات والنساء. ونحو ثلثي مجموع العراقيين هم دون الثامنة عشرة من العمر. ويُعد واحداً من أكبر وأشهر مخيمات اللاجئين في العالم بحسب موظفين بمنظمات دولية، لارتباطه بأحداث كبيرة وقعت في سوريا والمنطقة بنحو عام، أنشأته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة السورية في أعقاب حرب الخليج سنة 1991 وسكنه في حينها 15 ألف عراقي وفلسطيني. واستخدم كذلك لاستقبال النازحين العراقيين في 2003 بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإسقاط النظام العراقي السابق، وليستخدم لاحقاً لايواء الفارين من المعارك بدءاً من 2016 خلال عمليات تحرير مناطق الرقة ودير الزور من سيطرة تنظيم داعش من قبل التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية. وذاعت شهرته بنحو أكبر بسبب ارتباطه بالمعارك التي ترافقت مع إنهاء وجود تنظيم داعش العسكري في الباغوز في آذار 2019، حيث نقلت نساء وأطفال عناصر التنظيم إليه، ولاسيما العرب والأجانب الذين رفضت بلدانهم استقبالهم ليبقوا عالقين هناك في قسم خاص بهم ترتيبه التاسع في المخيم، يطلق عليه أسم أنيكس/ Annexes ويضم 10000 امرأة وطفلاً.تقام الذي يسري في دم الكثيرين منهم، وهم ينقلونه الى الجيل الجديد”. يسكن المخيم حالياً بحسب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، 56 ألف شخص، 50% منهم أطفال دون 12 سنة. وتبلغ مساحته 3,100,00 مترا مربّعا ويحيط به سياجٌ خارجي بامتداد 12.100 متر وتقدّر متوسط مساحة الفرد فيه 40 مترا مربّع. والمخيم مكوّن من 635 قطّاعاً ومُقسّم إلى 9 أقسام أو ما تسمّى بالـ فيزات/ Phases اثنان منهما (فيزان) منفصلان عن الأقسام الأخرى بسياج، يصنف التاسع بأنه الأخطر بسبب عوائل عناصر داعش الذين تعرف عنهم العدوانية. وقد تم مؤخراً إنشاء قسم إضافي مستقل، أطلق عليه(مخيم السلام) تقوم الإدارة بنقل الأشخاص المهدّدين أمنياً إليه أو المطلوبين لحالات الثأر وسواها. تبلغ أعداد العراقيين المتواجدين حالياً في مخيم الهول 28956 وهم بمجملهم نازحون ومهجرون من نينوى وديالى والأنبار، ويتوزعون على الأقسام الأول والثاني والثالث والسابع وجزء من الرابع. فيما تبلغ أعداد السوريين 10868 شخص. وبحسب عمران رضا فأن أكثر من 2500 عراقياً عادوا إلى العراق من خلال عمليات تسليم ونقل جرت حتى مطلع حزيران يونيو 2022، واصفاً الخطوات التي اتخذتها حكومة العراق بالمهمة للغاية على طريق إيجاد حلول، ودعا إلى اتخاذ إجراءات من قبل الدول الأعضاء الأخرى التي يتواجد مواطنوها في المخيم. "لكن الطريق مازال طويلا، فالذين عادوا لا يشكلون الا أقل من 10% من الباقين، ربما سيتطلب الامر سنوات من العمل والتأهيل، فالاجراءات تسير ببطء شديد وهناك اطفال يكبرون سريعا في بيئة مليئة بالمخاطر”، يقول الناشط المدني علي حسين. ويضيف “أتفهم معاناة ضحايا التنظيم بما فيهم الايزيديين، وأتفهم قلق المجتمع المحلي من عودتهم، لكن ما ذنب زوجات وشقيقات وأبناء مقاتلي التنظيم، هم ضحايا لفكر أو لنزوات أزواجهم.. كيف يمكن الاستمرار بمعاقبتهم بجرائم لم يرتكبوها”. وتحذر الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، من ذات الأمر، فقد ذكرت أن “إبقاء الناس في ظل ظروف مقيّدة وسيئة يؤدي في نهاية المطاف إلى مخاطر على مستوى الحماية والأمن أكثر من إعادتهم بطريقة منضبطة.” وتواجه عودة العراقيين من مخيم الهول إلى مناطقهم السابقة في العراق، عادة برفض شعبي واسع سواء في المناطق التي كانت خاضعة للتنظيم مثل نينوى والأنبار وديالى وتكريت او حتى سواها في بغداد أو المحافظات والمدن العراقية الأخرى. والسبب وفقاً لما عبر عنه نواب وناشطون، هو عدم الوثوق بهم، ويقولون بان العائلات العائدة قد تكون محطات يختبئ فيها عناصر التنظيم وتشكل خلاياه النائمة، فضلا عن أن وجود أقرباء عناصر داعش في مناطق كانت قد تضررت من التنظ خلال تقصينا عن واقع المخيم وتقسيماته وتوزيع الأفراد فيه، علمنا أن القسم التاسع المخصص للأجانب (الرجال والنساء)، لا يسمح بتجاوز أعمار الأطفال الذكور فيه، عن 12 سنة، لذا لا يوجد هنالك رجال بالغون أو مراهقون حتى. إدارة المخيم لا تحبذ الخوض في تفاصيل هذا القسم لأسباب تتعلق بحساسية الموجودين فيه، لكن من خلال تواصلنا مع موظفين يعملون لصالح منظمات دولية هناك، أخبرونا أن الأطفال الذين تصل أعمارهم 12 سنة يتم نقلهم إلى مكان آخر لأسباب عديدة أهمها: “عدم السماح بتزويجهم، وعدم إبقائهم في بيئة تحرض على العنف، وتلقنهم افكار متشددة، إذ أن النساء يربّون الأطفال على فكرة أنّهم أشبال الخلافة”. احصائيات الأمم المتحدة تؤكد بأن المتواجدين في الهول ينحدرون من 51 جنسية، عربية وأوربية وآسيوية وأمريكية واكثرهم من(العراق وسوريا ومصر والسعودية وتونس والجزائر ولبنان وتركيا وإيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية وأندونيسيا وتركستان وقيرغستان وطاجيكستان).يم، ستثير مشاكل أمنية وتؤدي إلى اعمال عنف إنتقامية. تحذيرات وأجواء رعب يحذر مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، من خطورة الوضع في مخيم الهول، قائلا ان “جيل جهادي” جديد يسعى لاحياء “دولة داعش”، وانه جيل يجري غسل دماغه بأيديولجية التنظيم ما يشكل خطرا كبيرا على المنطقة والعالم. ويصف الشامي المخيم بأنه أشبه بقنبلة موقوتة “لا نقول ذلك لمجرد عثورنا على بعض الأسلحة والذخيرة ومواقع التأهيل، بل لوجود عدد كبير من عناصر التنظيم الذين يسعون لفرض فكر داعش في المخيم”. ويستطرد المسؤول في الادارة الكردية بسوريا: “نحن نتحدث عن الجيل الثالث للتنظيم. الجيل الأول كان قبل داعش ويتمثّل بالقاعدة التي شكّلت أساساً لانطلاقة داعش، والجيل الثاني الذي أسّس دولة داعش، أمّا الجيل الثالث فهم الأطفال الذين ينشؤون اليوم في الهول.هؤلاء ولدوا عندما قدمت أسرهم إلى المخيم عام 2019، وخلال الفترة الممتدة بين عام 2019 وعام 2022 وُلد ألف و800 طفلاً وطفلة لداعش، بحسب الأرقام يولد هنا شهرياً 60 طفلاً هؤلاء يربون على الحقد والانتقام لآبائهم وأقاربهم وأمرائهم”. ويشهد مخيم الهول بشكل مستمر عمليات عنف وقتل، وارتفعت معدلات الجريمة في العام الجاري مقارنة بالاعوام السابقة، وهو ما دفع قوات الأمن التابعة للادارة الذاتية في 25 آب أغسطس الى تنفيذ حملة ضد ما تصفه بـ”الخلايا النائمة للتنظيم” في المخيم. كانت الحصيلة خلال اسبوعين القاء القبض على أكثر من 100مشبته بانتمائهم للتنظيم، وازالة 110 خيمة كانت تستخدمها خلايا «داعش» لاجتماعاتها او لتنظيم "دورات شرعية" وأكدت بيانات لقوى الأمن في الادارة الذاتية اكتشاف “ثمانية مواقع للاعتقال والتعذيب وسبعة خنادق للاختباء، الى جانب القبض على 23 عنصرا لخلايا داعش وضبط أسلحة كلاشينكوف وذخيرة عسكرية، واجهزة اتصال وحافظات ملفات الكترونية ولابتوبات مدفونة تحت الأرض”. وأشارت الى عثورها على: خيمة مخصصة للاحتجاز والتعذيب، كانت تحتجز فيها 3 نساء تتراوح اعمارهن بين 20 الى 23 عاما وكنّ مقيدات بسلاسل حديدية مربوطة بجدار إسمنتي. وذكرت اثنتان منهن إنهما من العراق، وبدت على أيديهما آثار تعذيب وجروح متشققة. كما تم تحرير فتاة إيزيدية تدعى وفاء علي عباس. الى جانب العثور على كتب ودفاتر وسجلات حملت دروس وأفكار دينية متشددة، تستخدم لتلقين أيديولوجية داعش، اضافة الى عملات نقدية تعود “لدولة الخلافة”. وقال مسؤول أمني ان الخلايا الموالية لداعش نشطت بشكل غير مسبوق في الأشهر الأخيرة وقامت بعمليات قتل وتعذيب وترهيب باستخدام السكاكين والسيوف، ولجأت في بعض العمليات الى مسدسات مزودة بكواتم صوت او بنادق حربية، وهي تقوم برمي جثث الضحايا في أقنية الصرف الصحي في محاولة لإخفاء جرائمها. المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي علي الحسن، قال تعليقا على تزايد عمليات القتل، بينما أشار الى مجرى للصرف الصحي عثر فيه على جثث، ان الضحايا بدت عليهم آثار “تعذيب وحشي” وانهم قُتلوا على الأرجح بمسدسات كاتمة للصوت أو بنادق، منوها الى ان عمليات العنف ارتفعت بعد محاولة الهروب الكبيرة من سجن الغويران في شباط فبراير الماضي. وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، قد ذكر ان ثلاثة أشخاص قتلوا في الهول خلال شهر تموز الماضي، ليصل عدد المقتولين بين كانون الثاني وتموز الى 27 شخصا 6 منهم عراقيون وبينهم امرأتان، والضحايا الآخرون هم 11 من الجنسية السورية بينهم 8 سيدات، و8 نساء مجهولات الهوية، بالإضافة إلى مسعف ضمن نقطة خدمية، ورجل آخر مجهول الهوية”. وغالباً ما تتم عمليات القتل بواسطة مسدس أو نحر الضحية وإلقائها في مجاري الصرف الصحي. ووصفت وحدات حماية الشعب الكردية، في بيان مخيم الهول “ببيئة تتخفّى فيها الخلايا الإرهابية وتستغلها للقيام بعملياتها”. وذكر سيامند علي، وهو مسؤول بتلك الوحدات انهم أزالوا الخيم الفارغة ضمن المخيم والتي يعتقد ان التنظيم كان يستخدمها خلال هجماته، وبدأوا “بتسجيل أسماء القاطنين.. وأخذ البصمات”. وسط تلك الأجواء المشحونة بقصص القتل وأخبار “العنف والجهاد”، وفي خيم تحولت الى مدارس لترويج فكر تنظيم داعش، حيث تنتشر كتاتيب لتنمية عقائد تكفر الآخر وتغذي روح الانتقام، يكبر الأطفال الذي يشكلون نحو ثلثي سكان المخيم. فراغ كبير وعمالة اطفال الناشطة المدنية غيداء حسين، تصف واقع الطفولة في المخيم بالسيء جداً، وأنهم جميعاً يعيشون نفس الحياة والروتين “الكثير منهم يذهبون إلى المدارس، رغم ذلك هناك نسبة أمية كبيرة بين الأطفال، حيث ينقطعون عن الدراسة لأسباب عديدة”. وتذكُر بأن بعض النساء في المخيم وبهدف الحصول على مردود مالي، يبعن مخصصات الأطفال من الألبسة الشتوية التي تقيهم البرد، وكذلك مخصصات الأطفال من مرضى سوء التغذية (الزبدة والبسكويت) وكذلك أحذيتهم. وتضيف “لذلك نجد باستمرار ان هناك أطفالاً حفاة وشبه عراة يتجولون في المخيم”. وتسجل غيداء من ضمن ملاحظاتها عن حياة الأطفال، أن غياب الوالدين أو أحدهما يؤثر سلباً عليهم وحتى بوجود من يكفلهم كالعمة والخالة فإن الاهتمام بهم يكون قليلاً، وهؤلاء يعانون من مشاكل أكبر”. وتوضح :”عدم الاهتمام بهم يتسبب بانتشار الأمراض بينهم، أو تفاقم حالتهم المرضية بعد اصابتهم بمرض بسيط، لا سيما أن بعض المعتقدات المنتشرة بين لاجئي المخيم ترى في الذهاب إلى المنظمات الصحية أو أي منظمة أخرى داخل المخيّم نوعاً من الإذلال، وربما البعض يعتبرها مد اليد لجهة كافرة”. وتنبه الناشطة إلى أن عمالة الأطفال شائعة وخاصة تلك التي تُجر بواسطة عربات كالتي تحمل عليها الخضروات والفواكه وغيرها في سوق المخيم مقابل أجور زهيدة. ويعيش الأطفال بنحو عام فراغاً كبيراً فلا يتوفر لهم شيء يشغلون به أنفسهم، كما تؤكد غيداء “تجد الأطفال يطاردون العاملين في المنظمات الانسانية، أو يرشقون سيارات المنظّمات بالحجارة، أو يتعلّقون بخلفيات صهاريج المياه وسيارات الحمل العابرة التي تنقل المواد الغذائية التموينية، أو تراهم يتجمعون حول عمال المقاولات كالحفريات وأعم مية متفشية وحرب ضد التعليم موظف يعمل في منظمة دولية بمخيم الهول، أخبرنا بأن نسبة كبيرة من الأطفال العراقيين أميون، لم يتعلّموا الكتابة والقراءة على الرغم من أنهم جاوزوا سن المرحلة الابتدائية، وكذلك الحال بالنسبة للأطفال الأجانب في القسم التاسع. البعض لم يتعلم لأنه تأخر عدة سنوات بين الاعوام (2014 و2019) في دخول المدرسة، وكما ان الكثير من العائلات أو الأمهات بالنسبة لعائلات داعش، يرفضن إرسال أبنائهن الى المدارس التي تديرها المنظمات وفق المناهج التعليمية الرسمية المقدمة. ويتابع: “هنالك بالفعل من يريدون لأطفالهم تلقي العلم للخلاص من الجهل الذي يولد الحروب، بينما هنالك أيضاً من يعتقد بأن التعليم في المخيم ضحك على الذقون وهو جزء من حرب موجهة ضدهم وضد أطفالهم لقلب معتقداتهم، لذلك يبقونهم داخل الخيم، وهم في أحسن الأحوال يُرسلونهم إلى الكتاتيب التي أسسوها ويدرسونهم فيها القرآن والمذاهب والأفكار الخاصة بهم”. وينقسم التعليم في المخيم، بحسب الموظف الدولي إلى قسمين، الأول قام بتأسيسه الأهالي ويقومون فيه بتدريس أطفالهم القرآن والعقائد الخاصة بمذاهبهم، والثاني مراكز تعليمية منهجية من الصف الأول وحتى الصف السادس الابتدائي وهي تابعة لمنظمة إنقاذ الطفل/ Save The Children. وكان لهذه المنظمة مركزان تعليميان، مرتبان من الصف الأول إلى الصف السادس وكانت تدرس فيهما اللغة العربية واللغة الإنكليزية والرياضيات (المبادئ الأساسية للحساب). الأول يقع في القسم الأول من المخيم، أما الثاني فكان يقع في القسم الثالث، وقد قام بعض الأهالي بتدميره. ورجح الموظف الدولي أن تكون مادة العلوم هي السبب، إذ رفض الأهالي تدريسها لأن فيها موضوعاً عن جسم الإنسان وهددوا بعدم إرسال أبنائهم إذا تم تدريسها. وقد تم رفعها من المنهج بعد الحادث. ويقول عن ذلك “هذا كان دليلاً على رغبة قاطني المخيّم الاكتفاء بالكتاتيب لضمان تدريسهم القرآن والعقيدة، وعدم تلويث عقولهم وفقاً لما يعتقدون بثقافة أخرى غربية وغريبة”. الأهالي المتشددون رفضوا أيضاً اختلاط التلاميذ الذكور بالإناث، ولهذا تم فصلهم عن بعض في الصفوف، ويقوم مدرسون ذكور بتعليم الفتيان ومدرسات إناث بتعليم الفتيات، ووصل الأمر على حد قول الموظف الدولي، إلى تهديد إدارة المركز التعليمي الوحيد العامل حالياً بعدم الاختلاط بين الكوادر التدريسية أيضاً، ولا يستبعد أن يكون ذلك سبباً إضافياً لتدميرهم المركز التعليمي في القسم الثالث. ويضيف على ذلك: “هم يمنعون أيضاً أية أنشطة يشكون أن لها علاقة بثقافة غربية كالأنشطة التي تحد من التطرّف ويوجهون تهديدات باستمرار لوقفها، ولا تمتلك المنظمات أي طرق أو وسائل للضغط عليهم، إذ أنّهم يخشون على حياتهم من التهديدات، كما لا يريدون ان ينقطع الأطفال عن التعلم تحت أي ذريعة”. وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ان المنشآت التي تقيمها المنظمات الإنسانية تتعرض للتخريب ونهب معداتها والى الإغلاق المتكرر بسبب الحوادث الأمنية في المخيم، وهذا يصعب مساعدة المحتاجين. في القسم الثالث من المخيم، كانت سيدة تدعى عائشة مع طفلتيها تراقبان المارة، أخبرتنا أنها تقضي نهارها هنا بالجلوس “بانتظار لا شيء”، فقط تتبادل أحيانا الحديث مع المارة! قلبت كفيها ورفعتهما عاليا في إشارة إلى الفراغ الذي تعيشه مع صغيرتيها (8 و6 سنوات). ذات الحياة تعيشها شقيقتين لها مع صغارهما. أشارت اليهما بيدها، كانت تقفان على بعد بضعة امتار من خيمة مجاورة. لم تجب عائشة في البداية على سؤالنا عن سبب عدم ارسال ابنتيها الى المدرسة. لكنها كانت مستعدة لرواية قصتها وكيف انتهى بها المطاف الى الهول. زوجها الذي تقول بأنه إتهم ظلماً بالانتماء إلى داعش، قتله مجهولون في الأنبار في العام 2017، أما زوجا شقيقتيها فمعتقلان في سوريا لأنهما كانا مع التنظيم. تسرد محطات من قصة وصولها مع شقيقتيها الى سوريا، والأهوال التي شهدتها بسبب انتماء عائلتها لداعش قبل ان ينتهي بهم المطاف في الهول الذي وصفته بالسجن الكبير. تشكك عائشة بجدوى تعليم ابنتيها في المدرسة “ماذا ستصبحان في المخيم، طبيبتان؟” تقول ساخرة وهي تضمهما إليها. وتتابع بنبرة السخرية ذاتها: “لم تفدنا المدارس بشيء ونحن أحرار، لتفيدنا الآن ونحن مساجين وبلا مستقبل، لذلك أعلمهما القرآن والأحاديث النبوية بنفسي، وكذلك الخياطة والتطريز وصناعة الخبز، شيء يفيدهما اذا تزوجتا”. مقايضة لتأمين حاجاتهم قلة قليلة من سكان المخيم يحصلون على المال، مقابل عملهم لدى المنظمات الناشطة هناك أو بواسطة مشاريعهم الصغيرة التي افتتحوها لأنفسهم كمحال بيع الخضار او الأغذية في سوق المخيم، أو بواسطة حوالات مالية تصلهم من خارج المخيم ونسبتها قليلة جداً. فضلاً عن قيام البعض ببيع ما يخصص لهم من مساعدات، ويختلف الأمر من مخيم الى آخر، والعمل مقابل المال يكون موجودا في الأقسام التي فيها رجال فقط دون غيرها. فيما عدا ذلك فان الغالبية الساحقة ولا سيما العراقيون والأجانب يعتمدون في قوت يومهم على السلال الغذائية المقدّمة لهم من قبل المنظمات العاملة هناك كـ(مفوضية اللاجئين وبرنامج الاغذية العالمي ولجنة الانقاذ الدولية وبلومونت)وغيرها من المنظمات المدنية. ونظراً لعدم احتواء هذه السلال على الخضار أو الفواكه أو البروتينات الحيوانية، يلجأ قاطنو المخيم إلى أسلوب المقايضة، بتبادل الفائض عن حاجتهم من مفردات السلال كالأرز والسكر بالخضار. يؤكد العديد من سكان المخيم ان السلال الغذائية تقلصت في الأشهر الأخيرة وصارت تتضمن فقط الزيت والسكر والأرز. ذلك يزيد من معاناة آلاف العوائل ممن لا يملكون اي مورد آخر لمعيشتهم. تقول (ح. ج) وهي عراقية لم تبلغ بعد الخامسة عشرة من عمرها، تتطلع للعودة قريبا الى جنوب الموصل حيث كانت تعيش، ان الوضع الغذائي يتراجع وان ذلك بات يشكل أكبر مخاوفهم “نخشى ان تنقطع السلات، لا نعرف كيف سنتدبر أمورنا، الكثيرون مثلي وأخوتي الصغار لا يملكون معيلا هنا”. وتتساءل “الى متى تتطلع عيوننا الى المساعدات؟”. ولتأمين حاجاتهم من المياه يعتمد سكان الهول على مياه الصهاريج التي توفرها المنظمات العاملة هناك، كما توجد مراكز لمياه الآبار التي فيها نسب متفاوتة من الملوحة. وفي هذا المجال يشهد المخيم أيضا شحة في المياه بسبب تحديد وتقليص دخول صهاريج المياه وأيضاً لوجود نقص في عدد خزانات الماء المنتشرة فيه. ويوصف الواقع الخدمي في المخيم، سواء من قبل اللاجئين او المنظمات بـ”السيء جداً”. ممثل أحد المنظمات الصحية العاملة بالمخيم قال: “نعم الواقع الخدمي سيء، لأن الامكانات محدودة، مياه الصرف الصحي تنتشر في المخيم على شكل مجاري سطحية تمر عبر الخيم، وهي مشكلة قائمة تجلب مختلف أنواع الحشرات والأمراض معها”. كما ان خدمات الرعاية الصحية محدودة، رغم وجود العديد من المنظمات المعنية بالصحة، وهي الهلال الأحمر الكردي والهلال الأحمر العربي السوري، ومشفى الصليب الأحمر الدولي، إضافة إلى بعض المنظّمات التي تختصّ بتقديم الرعاية لفئة عمرية معيّنة من الأطفال كجمعية مار افرام وجمعية المودة الخيرية وأطباء بلا حدود وجمعية مار آسيا. ولا تتوفر أدوية لجميع الحالات لدى هذه المنظمات ويحدث أن يتم نقل بعض المرضى إلى المستشفيات التخصصية في مدينة الحسكة في حال كان الأمر مقتضياً، ويتم في العادة إخراج أولئك المرضى بناءً على إحالات طبية يتم اعدادها من قبل إدارة المخيّم. في القسم السابع من المخيم، قابلنا عماد (36 سنة) من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، الذي تحمل بعد وفاة والديه عبء الاهتمام بشقيقه الأكبر الذي يعاني من الصمم وإعاقة ذهنية مع شلل في طرفيه السفليين منذ ولادته. يقول عماد بأنه كان موظفاً في وزارة الاتصالات العراقية، يعيش حياة هادئة بلا منغصات يستمتع بممارسة كرة القدم ومتابعة الدوريات الكبرى، واكتملت سعادته بزواج رتبته والدته “كان ذلك قبل تنقلب حياتنا في 2014”. يقول وهو يتلفت متجنباً ذكر داعش بالاسم. ويتابع ويده على جبهته “فرضوا عادات دخيلة علينا وعلى نسائنا، منعوا كل شيء، وطلبوا منا إطالة اللحى ولبس النقاب”. تناول سيكَارة من جيب دشداشته العلوي، قال وهو يضعها في زاوية فمه اليسرى “حتى هذه حرّموها علينا”، أخذ نفساً عميقاً من ثم أطلق الدخان إلى الأعلى بنحو مطول. وأضاف: “كنّا في خوف دائم من أن يقوموا بتجنيدنا بين صفوفهم رغما عنّا، لقد نجانا الله منهم، ولكن عند اشتداد المعارك حول مدينة الرمادي اقتادونا تحت التهديد إلى الباغوز، استخدمونا دروعا لانسحابهم”. يتابع: “كان على كلّ من يفكر في الهرب أن يفكر قبلها بموته قتيلاً، رأينا هناك مالم يره بشر؛ حالات قتل وعنف وتعذيب وخوف لا يمكن للسان وصفه، وأثناء الهدنة في بداية 2019 خرجنا إلى مخيم الهول، وها نحن هنا منذ ذلك الحين”. يمسك السيكارة بإصبعين ويستغرق في لحظة شرود، ثم هز رأسه كأنه يتحرر من فكرة رادوته، وقال:”لن أنسى أول يوم في هذا المخيم، خاصة مع صعوبة تأمين احتياجات أخي المعاق، كما أنّ بعض الخصوصية التي يحبها لا يجدها في المخيّم، ولأنني لا أستطيع فعل شيء فقد وضعت سوراً حول خيمتي، هذا كل ما أستطعت” ويشير ملتفتاً إلى سياج غير منتظم من قطع الخشب. ينقل السيكارة الى فمه مجدداً ويشرح حالة شقيقه المعاق، والمعناة التي يتكبدها هو وأسرته الصغيرة “حين كنا في العراق كان أبي وامي يبذلان جهد إمكانهما لمساعدته، لكن بعد وفاتهما وتحملي وزوجتي لمسؤوليته بات الأمر أكثر صعوبة خصوصاً أنه يكبر ومعه يكبر همه، وأبسط ما نواجهه مثلاً، أنه يبكي مثل طفل صغير إذا لم أجلب له الحلوى”. يلقي بعقب السيكارة بعيداً “سنبقى هنا، لا أدري ربما لسنوات أخرى، فلم يعد لدينا منزل هناك نعود إليه، ولا أظنني سأكون قادراً في العراق على توفير متطلبات السكن والحياة لعائلتي والاعتناء بشقيقي”. برنامج العودة في 11 آب اغسطس سلمت الإدارة الذاتية بسوريا، الحكومة العراقية 150 عائلة تضم 670 عراقيا، بينهم 620 من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش، اضافة الى 50 من قيادات التنظيم وعناصره المعتقلين. وكانت السلطات العراقية، أعلنت في مطلع حزيران يونيو تسلمها 50 عنصرا من التنظيم، من قوات سوريا الديمقراطية التابعة للادارة الذاتية السورية. في وقت تقدر مصادر امنية عدد العراقيين المعتقلين هناك بنحو 3500 معتقل. وفي ايار الماضي أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، انها ستتسلم 500 عائلة من مخيم الهول خلال العام الجاري غالبيتهم من الاطفال والنساء، وفي عدة دفعات. وفعلا كانت قد تسلمت أكثر من 150 عائلة في ذات الفترة. وتقول الوزارة انها تستطيع استقبال 150 عائلة تضم بين 650-700 شخصا كأعلى معدل، لضمان النقل الآمن وتأمين الغذاء والخيام لهم. وكان مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى، خالد عبد الكريم إسماعيل، قد ذكر في تصريحات صحفية في 24 تموز يوليو الماضي، أن دائرة الهجرة استقبلت أكثر من 5 وجبات، بما يعادل 660 عائلة عراقية، في مركز الجدعة للتأهيل النفسي والمجتمعي بهدف اعادة دمجهم بالمجتمع. واوضح ان الافراد الذين دخلوا في مراحل تأهيلية تستمر شهرين الى ثلاثة، بمشاركة عدد من المنظمات المحلية والدولية، بمجرد انتهاء تأهيلهم النفسي يغادرون إلى بيوتهم، مشيرا الى ان أكثر من 394 عائلة عادت إلى مناطقها، وان أكثر العائدين هم من محافظة الانبار ومن ثم نينوى تليها صلاح الدين. وتقوم الجهات الأمنية العراقية بتدقيق السجلات الأمنية للعوائل الراغبة بالعودة، للتأكد من سلامة وضعها وعدم وجود افراد منتمين لداعش بينها. وتؤكد وزارة الهجرة أن أكثر من 90% من العائدين لا يحملون أي مؤشرات أمنية، ولكنهم اختلطوا مع الموجودين في مخيم الهول الذي يضم عوائل التنظيم، وخوفا من تأثير اولئك عليهم يتم تأهيلهم قبل دمجهم بالمجتمع. ويقول علي عباس، المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، ان خطط الوزارة لإعادة المواطنين والعائلات العراقية من سوريا “لا تشمل بأي شكل دواعش إرهابيين”، مبينا أنه بعد انطلاق برنامج العودة تراجع عدد العراقيين في الهول من 30 ألف الى حدود 27 ألف عراقي. متخوفون من الوطن الى جانب عدم تسوية ملفاتهم الامنية من قبل الحكومة العراقية، ورفض المجتمعات المحلية عودة بعضهم بسبب الجرائم التي ارتكبها أبناؤهم مع خوفهم من ان يجلب رجوعهم العنف وعدم الأمان لمناطقهم، يعدد الخبير والباحث مقدام خالد عزيز، أسباب اخرى تقف وراء رفض بعض العراقيين المتواجدين في مخيم الهول العودة الى مناطقهم، بينها ما هو أمني، إذ أن الكثيرين واقعون تحت تأثير ما يصفه بالإشاعة والخوف من الانتقام. "يزعم من يرفض العودة والمغادرة وحتى التسجيل على الرحلات التي خصّصت للعراقيين للرجوع إلى بلدهم بأنّهم يتخوّفون من ملاحقة السلطات لهم قانونياً ومصيرهم سيكون السجن أو القتل وبعضهم يتحدث عن فصائل في الحشد الشعبي كتهديد أساسي”. ويذكر أيضاً بان هنالك أسباباً اقتصادية، لأن من الصعب عليهم ولاسيما النساء اللاتي فقدن معيلهن، بناء حياة جديدة في العراق من ناحية تأمين المعيشة اليومية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن صعوبة توفير السكن والمأكل “لذلك يفضلن البقاء في المخيّم طالما أنّ هناك خيمة تأويهن وأطفالهن وأنّ هناك سلال غذائية وطبابة للحالات الضرورية”. ويؤشر الخبير مقدام أسباباً أخرى لرفض العراقيين المقيمين في مخيم الهول العودة، وهو خوفهم من الثأر والتصفيات الجسدية تطبيقاً لأحكام عشائرية، وبعضهم يخشى على نفسه حتى في المخيم ذاته “وهو ما دفع إدارة المخيم إلى إنشاء (مخيّم السلام) لحماية هؤلاء وغيرهم من المتخوفين من قضايا مشابهة”. وينقل الباحث، عن الأمم المتحدة تأكيدها في حزيران/يونيو 2022 مقتل 100 شخص في مخيم الهول خلال 18 شهراً، بينهم الكثير من النساء. ويقول بأن هنالك من ينتظر تسويات لأوضاع أبنائهم أو أقرباء لهم، المتواجدين في السجون والمعتقلات العراقية ويربطون عودتهم بخروجهم منها، كما أن هنالك من دمرت مساكنهم أو أصبحت قراهم خالية من السكان. منى أو “أم محمود” كما تحب أن تنادى، سيدة عراقية في عقدها السابع من أهالي مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وهي أمٌ لثلاثة أبناء ومثلهم من البنات، كانت تقضي حياة كريمة في ظل زوج يعمل في مجال المقاولات ويساعده اثنان من أبنائهما، بينما الأبن الأكبر محمود يعمل ممرضاً في مستشفى حكومي ومحط فخر العائلة واعتزازها، كل ذلك قبل أن يسيطر تنظيم داعش على المدينة في 2014. "في أحد الأيام، جمعنا محمود وأخبرنا بانتمائه لداعش، وطلب من أخويه الانضمام إليه، الخبر الصادم وما خلفه من غضب وجدل شديد أصاب والده بنوبة دماغية أدت إلى شلل في أطرافه، توفي بعدها بأشهر قليلة جراء الحزن” تسرد أم محمود الحكاية وهي بالكاد تغالب دموعها. لاحقا اعتقلت القوات العراقية الشقيق الأوسط وهو حالياً في سجن الناصرية، بينما الأصغر وعائلته مع أم محمود لحقوا بمحمود وعائلته الذين انتقلوا إلى تلعفر، لكن هناك قُتل محمود، فانتقلوا جميعا مع آخرين من عوائل مقاتلي التنظيم إلى الباغوز، وبعد تحريرها في 2019 تم اعتقال الأبن الأصغر وهو في سجن الحسكة حالياً، بينما نقلت أم محمود مع زوجات أولادها و12 حفيداً إلى مخيم الهول. تعمل أم محمود لإعالتهم في محل صغير لبيع الخضار في سوق المخيم، فما تستلمه من برنامج الأغذية العالمي وفقاً لما تشتكي، غير كافٍ، وتخشى أن يتفاقم سوء وضعها الصحي بشكل لا تكون فيه قادرة على تأمين قوت من تتكفل بهم “عندي ماء أبيض في عيني، وارتفاع دائم في ضغط الدم”. تفكر قليلاً بإمكانية العودة الى العراق، فتقول موجهة يدها جهة شمال شرق المخيم “إذا قدر لنا العودة يوما الى العراق، سأختار أربيل، لأنها آمنة ولا أحد يعرفنا هناك، ولن يعاقبوننا نحن النساء والأطفال لأن أبناً عاقاً لي انتمى دون ارادتنا الى داعش”. أنجز التحقيق من قبل “العالم الجديد” تحت اشراف شبكة “نيريج” للتحقيقات الإستقصائية.
عربية Draw: صلاح حسن بابان أرتفع جسد محمد الزيدي نحو نصف متر عن الأرض في أحد أيام عام 2014، الذي بات الأسوأ بين أيام حياته بعدما أيقظه صوت انفجار هزّ أركان منزله الذي كان ينام فيها مع إخوته. وبعد ساعات من الهزّة، علم الزيدي (29 عاما) الناشط المدني أنها وقعت نتيجة استهداف مجاميع مسلحة مخزنا للأسلحة والعتاد تابعا للحشد الشعبي بالقرب من منزله في قضاء المحمودية (جنوبي العاصمة بغداد)، وأسفر عن مقتل 11 شخصا، وإصابة 29 آخرين من بينهم الزيدي، فضلا عن أضرار جسيمة لحقت بمنازل وسيارات المواطنين. وينتقد الزيدي في حديثه للجزيرة نت الحكومة العراقية لعدم تعويضه ماديا أو تحمل تكاليف علاجه بعد الإصابة نتيجة الانفجار، وعدم منع انتشار المخازن داخل الأحياء السكنية. ومنذُ ذلك اليوم، أضحى الرعب جاثما على قلوب سكان منطقتهم، وهي حال كثير من العراقيين ممن تنتشر في مناطقهم مخازن الأسلحة والعتاد بمختلف الأنواع، بالإضافة إلى الصواريخ الكبيرة وحتى الطائرات المسيّرة، في ظلّ عدم اكتراث الجهات المعنية -لا سيما الحكومية منها- بحياة السكان. وبين فترة وأخرى، تهتزّ بعض المناطق نتيجة انفجار مخازن الأسلحة فيها، كما حدث الاثنين الماضي مع سكان منطقة الصويرة في محافظة واسط (جنوبي البلاد)، بعد أن وقع انفجار لم تكشف الجهات المعنية عن أسبابه في مخزن كبير ضمّ أسلحة متوسطة وثقيلة، ومنها صواريخ تعود لأحد الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي. وخلال الشهر الماضي فقط، انفجرت 3 مخازن للأسلحة؛ اثنان في بغداد وواحد في النجف، تابعة لفصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي؛ وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من المواطنين، بالإضافة إلى خسائر مادية من دون معرفة الأسباب والكشف عن التفاصيل والتكتم عليها من الجهات المعنية. أبرز مناطق انتشار المخازن وفي بغداد، تعدّ مناطق: قرب الجسر الفرنسي والكمالية وشهداء العبيدي وشارع فلسطين وأجزاء من منطقة الزيونة وصدر القناة والدورة وشهداء السيدية بالقرب من الشرطة الرابعة وأبو غريب؛ من أبرز المناطق في العاصمة التي تنتشر فيها مخازن الأسلحة والعتاد، بالإضافة إلى مخازن للسيارات المصفحة والطائرات المسيّرة، وتعود لتشكيلات منضوية في الحشد الشعبي. وفقًا لمسؤول أمني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه لحساسية وظيفته. وبالإضافة إلى العاصمة، تعدّ محافظات البصرة وبابل وميسان (جنوب) وكركوك ونينوى وصلاح الدين (شمالا) من أكثر المحافظات العراقية التي تنتشر في أزقتها السكانية مخازن السلاح والعتاد، حسب المصدر الأمني، وأغلبها تعود لفصائل الحشد الشعبي. وتوصف عادة هذه المستودعات والمخازن "بقنابل موقوتة ومخازن موت"، وهذا ما أدى إلى موجة من النزوح والهجرة من تلك المناطق إلى غيرها، بالإضافة إلى تسبّبها في أضرار اقتصادية في أسعار العقارات؛ مما دفع كثير من المواطنين إلى بيع منازلهم ومحلاتهم بأسعار زهيدة أقل من سعرها الحقيقي "خوفًا من تكرار الانفجارات فيها، التي تنهي حياة العديد من سكانها". 30انفجارا وتتعرّض هذه المخازن والمستودعات لانفجارات متكرّرة، إما نتيجة أخطاء عسكرية أو لارتفاع درجات الحرارة، أو جراء قصفها من القوات الأميركية.وخلال فترات مُتفاوتة، أطلق عراقيون وسوما لجعل المدن خالية من مستودعات الأسلحة، أبرزها وسم "بغداد منزوعة العتاد"، خوفا من وقوع كوارث إنسانية بسبب انفجار أي منها. وفي مراجعة سريعة أجراها موقع الجزيرة نت لإحصاء عدد الانفجارات التي حصلت لمخازن الأسلحة والعتاد في بغداد وغيرها من المحافظات الأخرى، تبيّن أن أكثر من 30 انفجار وقع بين عامي 2016 و2022، ولأسوكان أبرزها انفجار مخزن للسلاح في منطقة العبيدي (شرقي بغداد) في سبتمبر/أيلول 2016، والانفجار الذي هزّ مدينة الصدر (شرقي العاصمة) في يونيو/حزيران 2018 في حسينية الإمام الحسين، حيث وقع الانفجاران نتيجة تخزين كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما فيها الصواريخ، وتسببا في أضرار مادية وبشرية جسيمة. ويعدّ العراق من أكثر بلدان الشرق الأوسط إنفاقا على التسليح، وفقا لتقارير سابقة؛ إذ خصص 18.7 مليار دولار للإنفاق العسكري عام 2021 فقط، ويشمل ذلك النفقات التشغيلية وتسليح الجيش وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية بجميع مؤسساتها الأمنية. وتعدّ الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي يستورد العراق منها الأسلحة بـ41% من أسلحة الجيش العراقي، كما يعد العراق ثالث أكبر مستورد للأسلحة من كوريا الجنوبية في السنوات الخمس الماضية، واحتل المرتبة 11 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بين 2017 و2021. قنابل موقوتة الخبير الأمني مخلد حازم يصف مستودعات الأسلحة في الأحياء السكنية "بقنابل موقوتة" تُهدّد السلم الأمني والمجتمعي. ويتفق بذلك إلى حدٍ كبير مع الآراء التي تقول إن تلك المخازن تعود لفصائل تابعة للحشد.وعن سبب وضع تلك الفصائل مخازنها داخل الأحياء السكنية، يُجيب حازم بإشارته إلى أن وجود مخازن السلاح في الأحياء السكنية قد يمنع القوات الأميركية من استهدافها. ويصف ذلك "بالخطأ"؛ إذ إن أميركا إذا أرادت أن استهداف مخازن السلاح ستقوم بذلك من دون الاكتراث بحياة الناس، في إشارة منه إلى الرد على الهجمات الصاروخية التي تنفذها بعض فصائل الحشد ضد القواعد الأميركية. ومن الصفات الواجب توافرها في مخازن ومستودعات الأسلحة والذخائر كما يحدّدها الخبير الأمني في حديثه للجزيرة نت أن تكون ضمن أماكن تهيئ لها درجات حرارة معينة وأرضية مناسبة بآلية تخزين صحيحة وحديثة بحيث لا يؤثر ارتفاع الحرارة أو العوامل الجوية الأخرى على القنابر والصواريخ. ضعف الدولة ويرى الخبير الأمني أن ضعف الحكومة العراقية -لا سيما الجهاز الأمني والاستخبارات- وعدم تطبيق القانون بالشكل الصحيح خلال الفترات السابقة أدت كلها إلى انتشار هذا النوع من المخازن والمستودعات داخل الأحياء، وهذا ما يتفق معه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب وعد القدّو.إلا أن القدو (قائد عسكري سابق في الحشد الشعبي) يُخالف حازم ويفنّد الآراء القائلة إن هذه المخازن تابعة للحشد، ويؤكد أن الأسلحة التابعة للحشد مؤمّنة في معسكراتٍ خاصّة بها، وأن هذه الاتهامات يراد منها تشويه سمعته بعد أن أسهم في تخليص العراق من تنظيم الدولة الإسلامية.وعن سبب انتشار مخازن السلاح في الأحياء، يرى القدو إلى انتشار الدكة العشائرية في البلاد -لا سيما أن المجتمع العراقي عشائري- ومن خلال هذه المخازن تحاول العشائر الحفاظ على أسلحتها للدفاع عن نفسها أثناء نزاعها مع أي عشيرة أخرى.ويوسع القدو في حديثه للجزيرة نت رقعة عدم تطبيق القانون الذي أدى إلى انتشار مخازن الأسلحة بشكل كبير وعدم سيطرة الدولة عليها بتساؤله: هل من الممكن أن يهجرة وأضرار اقتصادية وبعيدًا عن الجوانب الأمنية والسياسية في هذه الظاهرة، وبالانتقال إلى أضرارها الاقتصادية، يؤكد الخبير الاقتصادي داؤود الحلفي أن تلك المناطق تصبح غير مرغوب فيها للسكن، بالإضافة إلى زيادة الهجرة والنزوح منها إلى مناطق أخرى. ويضيف إلى تلك الأضرار انخفاض أسعار العقارات والأملاك وتراجعها في المناطق التي تنتشر فيها مخازن الأسلحة والعتاد، عازيّا السبب إلى أنها تصبح أشبه ما تكون "بثكنة عسكرية"، وتتراجع فيها فرص الحياة مع عدم توفر الخدمات الترفيهية وغياب البيئة الصحية للعيش الكريم والأمان، وتكون طاردة للجذب الاجتماعي.طبق القانون على جميع الأراضي العراقية ومن ضمنها إقليم كردستان؟ هجرة وأضرار اقتصادية وبعيدًا عن الجوانب الأمنية والسياسية في هذه الظاهرة، وبالانتقال إلى أضرارها الاقتصادية، يؤكد الخبير الاقتصادي داؤود الحلفي أن تلك المناطق تصبح غير مرغوب فيها للسكن، بالإضافة إلى زيادة الهجرة والنزوح منها إلى مناطق أخرى. ويضيف إلى تلك الأضرار انخفاض أسعار العقارات والأملاك وتراجعها في المناطق التي تنتشر فيها مخازن الأسلحة والعتاد، عازيّا السبب إلى أنها تصبح أشبه ما تكون "بثكنة عسكرية"، وتتراجع فيها فرص الحياة مع عدم توفر الخدمات الترفيهية وغياب البيئة الصحية للعيش الكريم والأمان، وتكون طاردة للجذب الاجتماعي. المصدر : الجزيرة
عربيةDraw تكتفي دول العالم بمشاهدة ما يجري في العراق من أزمة سياسية حادة ومواجهات طائفية محدودة قد تتحول إلى حرب طويلة الأمد بسبب رغبة كل طرف في السيطرة على السلطة بميليشيات مدربة وجاهزة لخوض صراع طويل. ويعزو مراقبون عراقيون امتناع الدول المؤثرة، والتي لها مصالح في العراق، عن التدخل إلى أن مصلحتها الرئيسية في الحصول على النفط العراقي لم تمسّ، وأن النفط يتدفق دون أيّ تعطيل من أيّ جهة، ما يوحي بأن المجموعات الطائفية تضع للصراع في ما بينها ضوابط حمراء لتتجنب أيّ صدام مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، وأهم هذه الضوابط هو عدم الاقتراب من النفط. وكان لافتا أن الدول الغربية عملت على التدخل في ملفات كثيرة للمساعدة على حلحلة الخلافات الداخلية مثل لبنان، حيث مارست فرنسا والولايات المتحدة ضغوطا على الطبقة السياسية من أجل حوار لبناني – لبناني يفضي إلى تفاهمات بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل تقديم مساعدات وقروض للبنان للخروج من الأزمة الحادة التي يعيشها. وتقوم الولايات المتحدة بوساطة بين لبنان وإسرائيل بشأن حل الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية المشتركة مما سيساهم في تحديد انتماء موارد النفط والغاز لكل دولة ويمهد الطريق أمام المزيد من عمليات الاستكشاف. ويطلب الرئيس اللبناني ميشال عون في أن تدخل شركة النفط والغاز الفرنسية توتال طرفا ثالثا يساعد لبنان في حل مشكلة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وهذه عينة من تدخل الدول الكبرى في ملفات أخرى بهدف السعي لحل الخلافات الداخلية مثلما يحصل في ليبيا واليمن وإثيوبيا، في الوقت الذي يختفي فيه أيّ دور لهذه الدول في العراق بالرغم من أهميته الإستراتيجية وخاصة للولايات المتحدة. وفي ما يقرب من تسعة أشهر، بين الانتخابات وانسحاب نواب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من البرلمان ونزول أنصاره للاعتصام في المنطقة الخضراء ثم المواجهات مع الإطار التنسيقي، زار كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي العراق مرتين فقط، وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن عددا قليلا من المكالمات مع صناع القرار العراقيين في محاولة للتأثير على التطورات على الأرض. ووجه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى انتقادات شديدة لطريقة اللامبالاة التي تعتمدها إدارة الرئيس جو بايدن في العراق مما مهد الطريق أمام إيران لتكون لها ولحلفائها من الميليشيات اليد العليا في بغداد. واعتبر شينكر أن غياب التأثير الأميركي في الحراك العراقي حول المناورات والضغوط والتحالفات بشأن تشكيل الحكومة لم يكن سهوا بل قرارا مقصودا، مستشهدا بقول مسؤول بارز في إدارة بايدن في ديسمبر بأن خطتهم كانت ترك الأمر ويقول مراقبون إن ما يهم واشنطن أن قطاع النفط لم يمس في العراق الذي يحتل وفق آخر تقرير لوكالة الطاقة الأميركية الترتيب الرابع كأكثر الدول تصديرا للنفط إلى الولايات المتحدة. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في يوليو الماضي، أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت خلال الأسبوع الأول من يوليو أكثر من 300 ألف برميل يوميا. وناشدت شركات نفط عاملة في كردستان الولايات المتحدة التدخل لنزع فتيل التوتر بين الحكومة المركزية العراقية والإقليم لضمان استقرار إنتاج النفط في شمال العراق. لكن إدارة بايدن لم تحرك ساكنا. وتقول فيليسيتي برادستوك الكاتبة المتخصصة في الطاقة والتمويل في مقال بموقع “أويل برايس” إن مزيج الاضطرابات السياسية في بغداد، والصراع المكثف على موارد البلاد بين الدولة العراقية وإقليم كردستان، يضعان صناعة النفط العراقية في وضع متقلب. وبينما يجب على الدولة معالجة وضعها السياسي لضمان استقرار صادراتها النفطية، يسعى إقليم كردستان إلى الحصول على الدعم السياسي والمالي من القوى الخارجية لضمان استمرارية صناعة النفط. ولازمت فرنسا بدورها الصمت عدا تصريح للرئيس إيمانويل ماكرون دعّم فيه تصريحات لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حث فيها على التهدئة واللجوء إلى الحوار. وعُد الموقف الفرنسي أقرب إلى تسجيل الحضور منه إلى تحرك لوقف تدهور الوضع في العراق. للعراقيين. وكان الرئيس الفرنسي قد نجح قبل عام في الحصول على عقد سخي من الكاظمي لفائدة مجموعة “توتال إينيرجيز” الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط واستغلال الطاقة الشمسية تبلغ قيمته 27 مليار دولار. وغاب تصريح من الصين بشأن الوضع السياسي المتدهور في العراق بالرغم من أنها أكبر مستثمر في العراق، وتصدر تحذيرات غربية من أن بكين تضع يدها على النفط العراقي من خلال زيادة الاستثمارات. وكانت بغداد أكبر مستفيد العام الماضي من مبادرة الحزام والطريق الصينية، إذ تلقت تمويلا قدره 10.5 مليار دولار لمشروعات في البنية الأساسية، منها محطة توليد كهرباء ومطار. وسجلت صناعة النفط العراقية اتجاهات إيجابية في الأشهر الأخيرة، حيث بلغت مستويات الإنتاج حوالي 4.4 مليار برميل يوميا من النفط الخام، وبلغت الصادرات أعلى مستوياتها في 50 سنة، بقيمة 11.07 مليار دولار. وترجع الزيادة في الصادرات إلى حد كبير إلى التحول في الاعتماد العالمي بعيدا عن روسيا نحو قوى نفطية أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية. ويمتلك العراق حوالي 145 مليار برميل من النفط، مما يجعله خامس أكبر دولة نفطية في العالم. ويمثل النفط الخام أهمية حيوية لاقتصاد العراق، حيث تساهم عائدات النفط بنحو 90 في المئة من دخل البلاد. وفي حين أن صناعة النفط في العراق لم تتأثر إلى حد الآن بحالات الاضطرابات السياسية السابقة، فإن التصعيد الأخير في الصراع يشكل تهديدا للقطاع. وقال فرناندو فيريرا، وهو مدير في مجموعة “رابيدان إينيرجي”، “في حين أن الإنتاج العراقي عادة ما يكون مرنا إلى حد ما في مواجهة الاضطرابات، فإن البيئة السياسية الحالية سامة بشكل غير عادي وتشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط”. واقترحت رئيسة السلع في “آر بي سي” حليمة كروفت هذا الأسبوع أن الاحتجاجات قد تؤدي إلى سحب مليون برميل من النفط من السوق إذا تصاعد الصراع. صحيفة العرب
عربية:Draw إعداد :أنور كريم بلغت إيرادات حكومة إقليم كوردستان خلال شهر اب الماضي بعد إحتساب النفقات النفطية نحو( 970) ملياردينار، وكانت الإيرادات قد بلغت( ترليون و 480) مليار دينار، المبالغ التي صرفت كنفقات نفطية تقدر بـ( 830) مليار دينار، أما المبالغ التي دخلت خزينة الحكومة فإنها تقدر بنحو( 650 ) ملياردينار. الخلاصة: بلغت الإيرادات غيرالنفطية لحكومة إقليم كوردستان في شهر اب 2022 =( 287) مليار دينار،"بحسب تصريح وزيرالمالية في حكومة إقليم كوردستان". المنحة المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 ملیون) دینار حصة حكومة إقليم كوردستان من موازنة الحكومة الاتحادية= (0) دینار. الإيرادات النفطية ( تصديرالنفط عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي): قامت حكومة إقليم كوردستان بتصدير( 11 مليون و 560الف) برميل نفط عن طريق ميناء جيهان التركي خلال شهراب المنصرم. بلغ معدل سعر برميل خام برنت في الاسواق العالمية خلال شهر اب الماضي نحو (100.45) دولار. تقوم حكومة الإقليم عادتا ببيع نفطه بأقل من أسعار الاسواق النفطية العالمية بنحو( 12) دولار، بلغ معدل سعر البرميل المباع من قبل الإقليم نحو (88.45) دولار. أذا: (11 ملیون و 560 الف) برمیل (88.45) X دولار = (1 ملیار و 22 ملیون و 482 الف ) دولار. ويكون بالديناربالشكل التالي : (1 ملیار و 22 ملیون و 482 الف) دولار X (1450) دینار= (1 ترلیون 482 ملیار و 598 ملیون و 900 الف) دینار. حسب التقرير الاخير لشركة ديلويت فان نسبة ( 56%) من الإيرادات النفطية للاقليم تذهب كنفقات نفطية وتتبقى من هذه الإيرادات نسبة( 44%) وتدخل في خزينة الحكومة. أذا:(1 ملیار و 22 ملیون و 482 الف) دولار (56%) X = 572 ملیون و 589 هەزارو 920) دولار، تذهب كنفقات نفطية. ويساوي المبلغ بالدينار(572 ملیون و 589 الف و 920) دولار 1450 X دینار = (830 ملیار و 255 ملیون و 384 الف). ( 1ملیار و 22 ملیون و 482 الف) دولار (44%) X = 499 ملیون و 892 الف و 80) دولار . الايرادات النفطية المتبقية للحكومة بالدينار= (449 ملیون و 892 الف و 80) دولار (1450) X= (652 ملیار و 343 ملیۆن و 516 الف) دینار. إجمالي الإيرادات المتحققة لحكومة إقليم كوردستان في شهرأب 2022 ( دينار): (652 ملیار و 343 ملیون و 516 الف ) إيراداتنفطية + (287 ملیار) إيرادات غير نفطية + (31 ملیار 500 مليون) منحة دول التحالف المقدمة لدعم قوات البيشمركة = (970 ملیار و 843 ملیون و 516 الف) دینار.
تقرير: Draw منذ 3 سنوات وحكومة إقليم كوردستان عاجزة عن توزيع النفط الابيض على مواطنيها، وتسبب ذلك بمعاناة ومشاكل جمة للعوائل الكوردستانية، فيما أخذ سعر برميل النفط الابيض يسجل أرقاما قياسية يوما بعد يوم. اصبح المواطن في الاقليم غير قادر على شراء هذه السلعة الضرورية التي تقيه برد الشتاء القارس... نسلط في هذا التقرير الضوء على أعداد العوائل في إقليم كوردستان والكميات التي يحتاجونها من النفط الابيض، والطاقة الانتاجية للمصافي المتواجدة في الإقليم، والدعم الحكومي لسد النقص الحاصل في هذه السلعة الحيوية. يبلغ عدد العوائل في إقليم كوردستان أكثرمن ( مليون و 200 الف) عائلة، هذه العوائل بحاجة الى ( 240 مليون و 200) الف برميل من النفط الابيض سنويا، هذا في حال اذا تم توزيع برميل واحد لكل عائلة. لو استمرت وزارة الثروات الطبيعة في الاقليم بتزويد المصافي بنفس الكميات والاحجام التي تقوم حاليا بتزويدها لهم ، فان تلك المصافي بإستطاعتها انتاج (44 مليون و 455 الف) لتر من النفط الابيض، أي تستطيع سد(19%) من حاجة الإقليم من هذه السلعة فقط ، وتكون هذه الكمية المنتجة أقل من حاجة الإقليم بنحو(195 ملیون و 744 الف) برميل أولا- عدد العوائل في إقليم كوردستان والكميات التي يجب توفيرها من النفط الابيض: كشفت هيئة الاحصاء في إقليم كوردستان وفق التقريرالاخير لها في شباط 2102 ان،"عدد سكان الاقليم يبلغ نحو (6 ملیون و 171 الف و 83) نسمة، بحسب التقرير، الزخم السكاني الاكثر يقع في محافظة أربيل حيث بلغ عدد سكانها (2 ملیون و 254 الف و 422) نسمة، وبلغ عدد سكان محافظة السليمانية نحو(2 ملیون و 152 الف و 595) نسمة، أما محافظة حلبجة فبلغ عدد سكانها نحو(115 الف و455) نسمة، وبلغ عدد سكان محافظة دهوك بحسب التقرير نحو(ملیون و 648 الف و 611) نسمة. بحسب الارقام التي كشفت عنها هيئة الاحصاء، يبلغ عدد العوائل في محافظة أربيل نحو(442 الف و 44)عائلة، وهذه العوائل تحتاج (442 الف و 44) برمیل من النفط الابيض سنويا، أي مايعادل (88 ملیون و 408 الف و 706) لتر" البرميل الواحد يساوي 200 لتر"، يبلغ عدد العوائل في محافظتي السليمانية وحلبجة معا وفق هذا الاحصاء، نحو (493 الف و 54) عائلة، هذه العوائل بحاجة (493 الف و 54) برمیل من النفط الابيض سنويا، أي مايعادل (98 ملیون و 610 الف و 870) لتر.أما محافظة دهوك فقد أشار الاحصاء الى وجود (265 الف و 905) عائلة وهم بحاجة الى ( 265الف و 905) برميل من النفط الابيض سنويا، أي مايعادل (53 ملیون و 181 الف) لتر. ثانيا- الطاقة الانتاجية للمصافي النفطية في إقليم كوردستان يوجد في إقليم كوردستان( 4) مصافي نفطية رسمية، تبلغ الطاقة الانتاجية لهذه المصافي مجتمعتا بنحو(256 الف) برمیل من النفط الخام: مصفى( كار) في محافظة أربيل، مملوكة لشركة ( كاركروب) النفطية، تقدرالطاقة الانتاجية للمصفى بنحو( 110 الف ) برميل يوميا. مصفى (بازيان)، في محافظة السليمانية، تبلغ القدرة الانتاجية للمصفى، بنحو ( 40) الف برميل يوميا. مصفى( لاناز) يعتبر من المصافي العملاقة في إقليم كوردستان ويقع في محافظة أربيل، تقدر الطاقة الانتاجية للمصفى بنحو( 100) الف برميل يوميا. مصفى ( طاوكي) في محافظة دهوك، تقدرالطاقة الانتاجية للمصفى بنحو( 6) الاف برميل من النفط يوميا. وفق هذه الارقام، لو قامت هذه المصافي بتشغيل كامل طاقاتهتا الانتاجية بتصفية مايقارب ( 240) الف برميل، سيكون بإمكانهم وفق هذه الالية تصفية مايقارب( 93 مليون و 440 الف) برميل سنويا من النفط الخام ، وحسب القياسات العالمية يقدر سعة البرميل الواحد بـ( 159) لترا، أي أن بإمكان هذه المصافي تصفية نحو( 14 مليار و856 مليون و 960 الف) لتر، لو فرضنا أن (3.14%)من هذا الانتاج سيخصص لانتاج النفط الابيض ،يتضح لنا ان بإمكان هذه المصافي توفير نحو(446 ملیون و 508 الف و 544) لیتر من النفط الابيض، أي ضعف حاجة مواطني إقليم كوردستان ثالثا – الدعم الحكومي للمصافي النفطية بهدف سد الطلب المحلي وفق التقريرالاخير لشركة ( ديلويت) قامت حكومة إقليم كوردستان في الفترة مابين( الاول من كانون الثاني 2022 حتى 31 أذار 2022)، أي خلال الربع الاول من العام الحالي بتزويد المصافي النفطية بـ(2 ملیون و 226 الف و 83) برمیل من النفط الخام، لو استمرت الحكومة في هذا الدعم وبنفس الكمية والاحجام، ستصل الكميات حتى نهاية هذا العام الى (8 ملیون و 904 الف و 332) برمیل من النفط الخام ، اذا تم احتساب سعة البرميل الواحد وفق القياسات العالمية بـ( 159) لتر للبرميل الواحد، ستكون الكميات المنتجة في حال حسابها باللتر قرابة ( مليار و415 ملیون و 788 الف 788)، لوفرضنا أن (3.14%)منها ستخصص لانتاج النفط الابيض، يتضح لنا انه بإمكان هذه المصافي توفير (44 مليون و 455 الف 768) لیتر من النفط الابيض ، لو استمرت وزارة الثروات الطبيعة في الاقليم بتزويد المصافي بنفس الكميات والاحجام التي تقوم حاليا بتزويدها لهم ، فان تلك المصافي بإستطاعتها انتاج (44 مليون و 455 الف) لتر من النفط الابيض، أي تستطيع سد(19%) من حاجة الإقليم من هذه السلعة فقط ، وتكون هذه الكميات المنتجة أقل من حاجة الإقليم بنحو(195 ملیون و 744 الف) برميل.
تقرير: Draw تأسس برلمان إقليم كوردستان منذ (30) عاما، مدد البرلمان خلال هذه المدة عمره التشريعي لـ( 6) مرات ولاسباب مختلفة منها "الإقتتال الداخلي" الذي اندلع في تسعينيات القرن الماضي بين الحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي" وبسبب الصراعات والخلافات، يستعد برلمان إقليم كوردستان حاليا لتمديد عمره التشريعي للمرة (السابعة) بحجة عدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد في مطلع شهر تشرين الأول القادم. 3 اجتماعات غير مثمرة اجتمعت الاطراف السياسية الكوردستانية خلال الاشهر (3) الماضية (3) مرات للتباحث حول الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان: الاجتماع الاول: عقد في أربيل بتاريخ 26 أيار بمقر البعثة الاممية و برعاية بلاسخارت، الاجتماع لم يفضي الى أي نتائج. الاجتماع الثاني : عقد في أربيل بتاريخ 9 حزيران وبرعاية رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنينين بلاسخارت، وفريق خبراء الانتخابات التابع للأمم المتحدة، خصص لموضوع الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة في إقليم كوردستان والسعي للتقريب بين وجهات نظر الأطراف السياسية بشأن قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء وعدد من المسائل المتعلقة بالانتخابات، وفق معلومات( Draw)،" أعلنت الاطراف المشاركة في الاجتماع رغبتها في تأجيل الانتخابات، الا ان الممثلة الاممية أبلغتهم بأن الانتخابات البرلمانية يجب أن تجرى قبل "نوروز" المقبل. وشكلت لجنة في رئاسة الاقليم برئاسة نائب رئيس الاقليم مصطفى سيد قادر وبعضوية مستشاري رئيس الاقليم ( جعفر إمينكي و دلشاد شهاب) و بمشاركة قسم شؤون الانتخابات بممثلية الامم المتحدة في العراق.على أن تقدم اللجنة المشكلة تقريرها النهائي في الاول من تموز الى رئاسة الإقليم حول رؤية الاحزاب السياسية بخصوص الانتخابات المقبلة، وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني حدد الأول من(تشرين الأول) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، أعقبه إعلان للحكومة عن تخصيص الأموال المطلوبة لإجرائها في موعدها، لكن مفوضية الانتخابات أعلنت أنها لا تملك "الشرعية القانونية" للمضي بالإجراءات والاستعدادات لحين تشريع قانون جديد للمفوضية، أو التجديد للمفوضية السابقة عبر البرلمان. أردت رئاسة الإقليم عبر هذه اللجنة تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية الكوردستانية وأزاحة المعوقات أمام مسار إجراء العملية الانتخابية. تشير المعلومات أن،" هناك تفاهم بين الديمقراطي والاتحاد الوطني على تأجيل الانتخابات لمدة (عام) وفق المعلومات التي حصل عليها ( Draw ) ،"شددت المبعوثة الاممية خلال الاجتماع على ضرورة إجراء الانتخابات قبل "نوروز" المقبل 2023. الاجتماع الثالث: عقد في 10 أب الماضي، حضر الاجتماع رؤساء الاحزاب السياسية الكوردستانية بحضور رئيس الاقليم والمبعوثة الاممية في العراق جينين بلاسخارات، تخلل الاجتماع نوع من التشنج وخاصة عندما صرح رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني للمجتمعين عن تعرضه الى محاولة إغتيال، حيث قال،" بعد لقائي بمسعود بارزاني، وفي طريق العودة الى السليمانية تعرضت الى محاولة إغتيال، حاولوا اطلاق النارعلى طائرة الهليكوبتر التي كنت استقلها".وفق المعلومات التي حصل عليها Draw ) ) من مصادر مطلعة داخل الاجتماع،" طالباني أفصح خلال الاجتماع وأمام رئيس إقليم كوردستان والمبعوثة الاممية في العراق وقادة الاحزاب الكوردستانية عن تعرضه الى محاولة إغتيال أثناء عودته من أربيل، عقب انتهاء لقائه بمسعود بارزاني، حيث أبلغ الحضور بأن أحد "العملاء" كان يراقب طائرة الهليكوبترالتي كان يستقلها بـ(بندقية قنص) وكان يرد إسقاط الطائرة، أثار تصريح طالباني حول محاولة إغتياله، غضب رئيس الإقليم والمبعوثة الاممية كثيرا، وطلبوا منه أن يفصح عن اسم الشخص الذي حاول إغتياله، اضطر طالباني الى تدوين اسم ذلك الشخص في قصاصة ورقية ودفع بها الى رئيس الإقليم". وعلم (Draw) ايضا، أن" المبعوثة الاممية جينين بلاسخارت هددت الحضور بعدم المشاركة في أي اجتماع أخر، اذا لم يتمخض عنه نتائج حاسمة، وربطت مشاركتها في الاجتماع القادم المزمع إنعقادة في شهر(أيلول) الحالي، بشرط توصل الاطراف السياسية الكوردستانية الى اتفاق نهائي وحاسم بخصوص تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يشارك زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في هذه الاجتماعات واكتفى بإرسال ممثل عنه وشارك حراك الجيل الجديد فقط في الاجتماع الاول، ولم يشارك في الاجتماعين الاخيرين. الاجتماع الرابع والتوصل إلى اتفاق من المقرر ان تعقد الاطراف السياسية الكوردستانية إجتماعها الرابع بخصوص الانتخابات التشريعية الاسبوع المقبل، ووعد رئيس الاقليم بلاسخارات بأن تتوصل الاحزاب السياسية الى تحديد موعد لاجراء الانتخابات. تتركز خلافات الاطراف السياسية الكوردستانية حول الانتخابات على ألية أجرائها، فمنهم من يدعم أجراء الانتخابات و فق (نظام الدوائر المتعددة)على شاكلة الانتخابات العراقية ( كالاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد وجماعة العدل الكوردستانية والاتحاد الاسلامي، في المقابل يدعم الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إجراء الانتخابات و فق نظام (الدائرة الواحدة). لماذا يمدد برلمان إقليم كوردستان عمره التشريعي؟ وقعّ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في 24 شباط أمراً إقليمياً حدد فيه يوم إجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان وتم تحديد الأول من شهر تشرين الأول العام 2022 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw هناك اتفاق مسبق بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني لتأجيل الانتخابات البرلمانية الى أذار 2023، بحجة أن المفوضية بحاجة الى ( 6) أشهر لاجرائها، في حال تأجيل الانتخابات الى أذار المقبل، سيضطر البرلمان الى تمديد عمره التشريعي لكي لايقع في فراغ قانوني، حيث أن العمر التشريعي للدورة الخامسة لبرلمان الإقليم سينتهي في 6 تشرين الاول 2022 تمديد عمر البرلمان يبلغ عمر برلمان إقليم كوردستان ( 30) عاما، مدد برلمان الإقليم خلال هذه المدة عمره التشريعي لـ( 6) مرات ولاسباب مختلفة منها "الإقتتال الداخلي" بين " البارتي و اليكيتي" في تسعينيات القرن الماضي وبسبب الصراعات والخلافات المستمرة بينهما، يستعد برلمان إقليم كوردستان حاليا لتمديد عمره التشريعي للمرة( السابعة) بحجة عدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد في مطلع شهر تشرين الأول القادم. مدد برلمان الإقليم في الدورة التشريعة الاولى فقط، عمره لـ( 4) مرات من (27 أيار1995 حتى 4 تشرين الاول 2002) أما المرة الخامسة الذي ممد فيه البرلمان عمره كانت في عام 2013 حيث تقرر تمديد عمرالدورة التشريعية لمدة ( 3) اشهر، المرة السادسة كانت في عام 2017 مدد البرلمان عمره التشريعي لمدة عام.
عربية Draw روينا إدواردز (رويترز) - طلبت شركات نفطية تعمل في كردستان العراق من الولايات المتحدة المساعدة في نزع فتيل التوتر بين الحكومة المركزية بالعراق والمنطقة ذات الحكم الذاتي، حسبما أفادت ثلاثة مصادر وأظهر خطاب اطلعت عليه رويترز.وذكرت المصادر أن الأمر يستلزم تدخلا لضمان استمرار تدفق النفط من شمال العراق إلى تركيا، حتى لا تضطر أنقرة إلى زيادة وارداتها النفطية من إيران وروسيا.وقالت إن اقتصاد إقليم كردستان عرضة للانهيار إذا فقد إيراداته النفطية. وشاب التوتر الأجواء في فبراير شباط عندما قضت المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون ينظم قطاع النفط في كردستان. وفي أعقاب صدور الحكم كثفت الحكومة الاتحادية، التي طالما عارضت السماح لحكومة كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل، جهودها للسيطرة على عائدات تصدير النفط من أربيل، عاصمة الإقليم.وقبل صدور الحكم، وفقا لنسخة من الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز، كتبت شركة (إتش.كيه.إن إنرجي) ومقرها دالاس لسفيري الولايات المتحدة في بغداد وأنقرة في يناير كانون الثاني تطلب الوساطة في قضية أخرى تعود لعام 2014 وتتعلق بخط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا.وتتهم بغداد تركيا بانتهاك الاتفاقية الخاصة بالخط بسماحها بمرور صادرات كردستان، والتي تعتبرها غير قانونية، عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي. ولم ترد وزارة الطاقة التركية على طلب التعليق. وعُقدت الجلسة الأخيرة في القضية بباريس في يوليو تموز، وستُصدِر غرفة التجارة الدولية قرارا نهائيا خلال الأشهر القادمة حسبما ذكرت وزارة النفط العراقية. ولا يزال من غير الواضح الخطوات التي قد تتخذها تركيا إذا صدر حكم لصالح العراق، وهو أمر مرجح، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر اطلاعا مباشرا. وأجرت شركة نفطية واحدة أخرى على الأقل اتصالات رفيعة المستوى مع أربع حكومات معنية بشكل مباشر أو غير مباشر، لحثها على التدخل، حسبما صرح لرويترز ممثل للشركة طلب عدم الكشف عن هويته.وأحجمت شركات أخرى عاملة في كردستان العراق مثل جينيل إنرجي وشيفرون عن التعليق على قضية التحكيم، ولم ترد شركتا دي.إن.أو وجلف كيستون حتى الآن على طلب التعقيب. إمدادات في خطر من شأن أي توقف لتدفق النفط عبر خط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا أن يقود لانهيار اقتصاد كردستان إضافة إلى دفع تركيا للحصول على المزيد من الخام من إيران وروسيا، وفقا لرسالة (إتش.كيه.إن) لممثلين عن الولايات المتحدة.ولم ترد وزارة الثروات الطبيعية في كردستان ولا وزارة النفط في بغداد على طلب للتعليق.ولم يحقق العراق استفادة كاملة من ارتفاع أسعار النفط التي قفزت إلى أعلى مستوى في 14 عاما بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط ولا تزال قرب المئة دولار للبرميل.وخط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا، تمثل تقريبا واحدا في المئة من إجمالي الطلب العالمي اليومي، من كل من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وحكومة كردستان العراق.إلا أنه يجري حاليا ضخ 500 ألف برميل من حقول شمال العراق، الذي سيجد صعوبة في زيادة الإمدادات ما لم تكن هناك استثمارات جديدة.ويتوقع محللون أن تنسحب شركات من كردستان إذا لم تتحسن الأوضاع.وقد فقدت الكثير من الشركات الأجنبية اهتمامها بالفعل.كانت هذه الشركات قد قدِمت إلى كردستان في عهد الرئيس السابق الراحل صدام حسين، عندما كان يُنظر إلى المنطقة على أنها أكثر استقرارا وأمنا عن بقية مناطق العراق.ومع تدهور الأمن، سعت أيضا الشركات القليلة المتبقية، وهي في أغلبها صغيرة ومتوسطة الحجم، لوجود دور أمريكي للمساعدة في ردع الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة فضلا عن تعزيز الأمن بشكل عام. ووفقا لمصادر مطلعة اطلاعا مباشرا، دعمت الشركات خطابات أرسلها أعضاء في الكونجرس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أغسطس آب. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.وطالبت الخطابات بإجراء مشاورات رفيعة بين أربيل وبغداد تأمينا لاستقرار كردستان ودرءا للتدخل الإيراني في العراق. خفوت الاهتمام الأمريكي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في 16 أغسطس آب إن الخلافات بين بغداد وأربيل خلافات تخص الجانبين، لكن الولايات المتحدة يمكن أن تشجع على الحوار. واستدعت الخارجية الأمريكية في يوليو تموز شركة الاستشارات القانونية الأمريكية (فنسون اند إلكنز) التي تمثل وزارة النفط العراقية في بغداد، لتقديم إحاطة في واشنطن بشأن الخلاف الخاص بخط أنابيب العراق-تركيا.
عربية:Draw صلاح حسن بابان حين عاد هزار حمه (25 عاما) خائبا إلى مدينة السليمانية بعد ثلاث محاولات فاشلة للوصول إلى بريطانيا عبر شبكات المهربين التقليدية التي تنطلق من تركيا، تلقف فكرة صديق بشراء جنسية إحدى دول الكاريبي كطريقةٍ سهلة وآمنة لتحقيق ما يطمح إليه "الإقامة في بلد مستقرّ وجواز يُتيح له السفر إلى 146 دولة بما فيها دول منطقة شنغن والمملكة المتحدة". يقول هزار، الذي خاطر بحياته عدة مرات خلال محاولاته عبور البحر من تركيا الى اليونان أو تجريب الطرق البرية: "كنتُ مصابا بالإحباط، قبل أن يتناهى إلى سمعي إمكانية تحقيق حلمي من خلال الحصول على جنسية وجواز سفر دومينيكا، كانت المعلومات المقدمة مُشجّعة والطريقة سهلة وقانونية تماما". عقب اقتناعه بالفكرة، عاد هزار مُجدّداً إلى دائرة الخيبة بعد أن علم من أحد مكاتب الترويج لتلك الجوازات، أن ذلك يُكلفه نحو 140 ألف دولار أمريكي متضمنة تكاليف الحصول على الجواز (100 ألف دولار) والإجراءات الروتينية سيما أنه أعزب، فذلك يُكلفهُ مبلغًا إضافياً. إمكانية تحقيق حلمه رغم التكلفة العالية، دفع الشاب الكردي الذي عمل في مجال التصوير وبات شغفه، إلى الضغط على والديه بل والتهديد بالانتحار، لدفعهما لبيع منزل العائلة في منطقة كوردسات وسط السليمانية، مُتعهدًا بتعويضهما والعمل ليل نهار حين يصل الى وجهته.سنويا يحاول عشرات آلاف المواطنين الكرد، أغلبهم شبان، الوصول الى الدول الأوروبية عبر مسارات تهريب البشر التي يذهب ضحيتها العشرات سنويًا غرقًا في البحر أو اختناقًا داخل الشاحنات. محددو ومتوسطو الدخل يدفعون في المتوسط 10 آلاف دولار في رحلتهم تلك، في حين يسلك الأثرياء طرقًا أخرى تكلف أضعاف ذلك الرقم. يقول مهربون وشركات شراء جنسيات ومستثمرون، إن مليارات الدولارات خرجت من الاقليم في السنوات الأخيرة، وان كردستان خسرت فرص استثمار وتنمية كبيرة نتيجة "الفساد وغياب العدالة والخوف من المستقبل". الهروب إلى العالم الآخر بعد نحو ستة أشهر وصل هزار إلى بريطانيا، لكن ليس كعازبٍ بل كابنٍ لعائلة ثانية، حيث زوّر له صاحب المكتب الذي تعامل معه وثائقه وجعله فردًا من عائلة كردية متكوّنة من أربعة أشخاص، قدمت أيضاً أوراقها. سافر الشاب الطامح لبناء مستقبله بجوازه الجديد من مطار أربيل الدولي إلى فرنسا، ومن مدينة دونكيرك إلى لندن عبر القطار، وبعدها سلّم نفسه إلى الشرطة البريطانية التي وضعته رهن الاعتقال لمدة يومين، ومن ثم نقلتهُ إلى فندقٍ بعد أن حقّقت معه عن معلومات حياته الشخصية ومن أين قدمَ إليها. مازال هزار يعيش في ذلك الفندق منذ أكثر من عام ونصف مثل عشرات اللاجئين القادمين من بلدان مختلفة، ويحصل اسبوعياً على مساعدة مالية صغيرة (8 جنيهات) معها اضطر للعمل في "السوق السوداء" في ماركيت لتأمين مصاريفه، رغم أن الحكومة البريطانية تؤمن له تكاليف المعيشة من مأكل ومشرب وضمان صحي. مصادر متعددة بمكاتب شركات تأمين "الجنسية الثانية" التي نشطت بكردستان وباتت تستخدم وسائل متعددة للإعلان عن أعمالها، تؤكد أن آلافا من مواطني الإقليم الكردي خاصّة من الطبقة حديثة الثراء، يسعون للحصول على جواز دومينيكا وجوازات دول أخرى عبر الاستثمار المالي أو شراء عقار. وحظيت فكرة شراء جواز سفر دومينيكا، وهي جزيرة صغيرة يبلغ عدد سكانها 72 الف نسمة، رواجاً واسعاً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لدى من يبحثون عن طريقة آمنة وسهلة لبلوغ بلدان الاتحاد الأوروبي، لاسيما في العام الأخير بعد تراجع مسار الهجرة عبر بيلاروسيا وتعقده عبر تركيا لبلوغ دول الاتحاد الأوروبي، رغم التكلفة العالية لتأمين جواز دول الكاريبي التي تبلغ في حدّها الأدنى 110 آلاف دولار. وتروج تلك الشركات لسهولة الحصول على الجنسية عبر اعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك وإنستغرام" بالإضافة إلى الكروبات السياحية التي تحوّلت إلى سوق نشطة لترويج تلك الإعلانات. ويتم ذلك بشكل قانوني تماما عبر برامج "الجنسية الاستثمارية" أو "المواطنة الإقتصادية"، ففي دومينيكا وهي دولة جزرية في البحر الكاريبي تعرف بشواطئها الجميلة، يوجد أرخص برنامج للحصول على الجنسية والذي أعلنته الحكومة في العام 1993 "لتعزيز المساهمات الاقتصادية الأجنبية من أجل تطوير البنية التحتية للدولة، ودعم خلق وظائف جديدة، وتحقيق نمو وازدهار اقتصادي مستدامين".ويعطي البرنامج للمستثمرين الأجانب، حق الحصول على الجنسية القانونية الدائمة وجواز السفر الثاني في غضون 3 إلى 4 أشهر، وفق ما يتم الترويج له. وهو جواز يتيح لحامليه السفر بحرية إلى الدول الأوروبية التي يقصدها العراقيون عادةً كمحطةٍ للاستقرار.وتضع حكومة دومينيكا خيارين أمام من يريد الحصول على جواز سفر بلادها، الأول أن يكون على مقدم الطلب الفردي للحصول على الجواز قد دفع 100 ألف دولار، بينما يصل المبلغ واجب الدفع لمقدم الطلب الرئيسي مع زوجته إلى 150 ألف دولار، ولايشمل ذلك تكاليف وأجور المكاتب والشركات التي تتولى عملية تقديم الطلب، فضلاً عن مبالغ تضاف إلى كل فرد في العائلة وفق الأعمار المختلفة. وأمّا الخيار الثاني، فيكون عن طريق الاستثمار العقاري، إذ يجب على مقدم الطلب الاستثمار في مشروع عقاري معتمد من قبل الحكومة داخل دومينيكا بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي. ويجب على المستثمر الاحتفاظ بملكية العقار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على الجنسية، ويمكن للمستثمر إعادة بيع العقار بموجب برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار بعد مرور 5 سنوات، دون أن تُسحب منه الجنسية أو يخسر أيّا من امتيازاتها. اعتماد تلك الإجراءات السهلة نسبيًا، ساهم كثيرًا في ازدياد الطلبات، خاصة ان دومينيكا لا تشترط على المتقدمين إجراء أي إختبار للغة، كما أنهم ليسوا مضطرين إلى زيارة الدولة أو الإقامة فيها. ويتمتع حاملو جوازها بمزايا السفر دون تأشيرة إلى 146 دولة وإقليم حول العالم، بينها دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. ومن المزايا الأخرى أن المواليد الجُدد تكتسب الجنسية بالوراثة، ويُسمح بالجنسية المزدوجة، وسهولة الوصول إلى الولايات المتحدة وكندا، وحق الإقامة الدائمة، ولايتم فرض ضرائب على غير المُقيمين.هذه المزايا الرئيسية شجّعت الكثير من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال كما السياسيين الجُدد ممن لم تعيش عوائلهم في أوروبا، على التقديم للحصول على جنسية تلك الدولة، ليتمتعوا بالسفر بسهولة، ولكي يضمنوا الخروج من العراق والإقامة في دولةِ مستقرّة عند اضطراب الأوضاع أو حصول انهيار في نظامه السياسي الذي يُعاني من أزماتٍ مستفحلة. تؤكد مصادر عديدة تم التواصل معها، أن طلبات التقديم على جنسية دومينيكا تصاعدت في كردستان، بدءاً من العام 2019، ووصلت الى الذروة في العام 2021، حتّى أصبحت أعداد الحاصلين عليها ومن قاربت ملفاتهم على الاكتمال أكثر من 15 ألف شخص. الرقم الأخير ذكره مصدر أمني مُطلع لـ"العالم الجديد"، أشار الى أن آلافا آخرين يجهزون أوراقهم للحصول على جنسية ثانية. لعدة مرات تواصلنا هاتفيا مع شركة (MontReal Management Consultants) وهي الشركة الرسمية التي تروج في الشرق الأوسط طلبات الحصول على جنسية دومينيكا، ومقرّها في دبي، للاستفسار عن أعداد العراقيين التي روّجت معاملاتهم وأعداد الذين حصلوا على هذه الجنسية، لكنّ الشركة امتنعت عن الإجابة. مصدر مطلع بمُجريات عمل الشركة قال: "هكذا إحصائيات تبقى سرية لدى الأجهزة الأمنية في دومينيكا بالإضافة إلى وزارة خارجيتها، ولايسمح لأحد الاطلاع عليها". السؤال ذاته طرحناه على مصادر عديدة تعمل في ذلك المجال، أملا في الحصول على رقم، اكتفى إحداها بالإشارة الى أن الشركة الرئيسية تعتمد بشكل أساسي على العراقيين في عملها "فهم يشكلون الجزء الأكبر من مواطني بلدان الشرق الاوسط المقدمين للجنسية". عوائل المسؤولين تتصدر الأرقام رغم عدم توفر إحصائيات رسمية عن أعداد المواطنين الحاملين لجواز سفر دومينيكا في إقليم كردستان وعدد الساعين للحصول عليه، إلا أن ثلاثة مصادر التقيناها في أربيل (اثنان أمنيان وثالث صاحب مكتب للسفر والسياحة) أكدت أن الشخصيات السياسية والحزبية الكردية وعوائلهم تتقدم أعداد المتقدمين.يقول عضو في برلمان إقليم كردستان -طلب عدم ذكر اسمه لأسبابٍ خاصّة- إن أكثر من 1500 شخص من الفئة الأخيرة باتوا يحملون جواز سفر دومينيكا، من ضمنهم نحو 600 مسؤول يعملون في الدوائر الأمنية الحكومية والحزبية في كردستان. تزايد الطلبات على جواز دومينيكا ودول أخرى، من قبل المسؤولين الحزبين والحكومين يُفسّره عضو برلمان كردستان سيروان بابان، بأنه نتيجة شعورهم بالقلق من مستقبل الأوضاع واحتمال انقلابها ضدهم، وتحسبًا لأي طارئ قد يحدث، فجوازاتهم تلك ستكون جاهزة ليهربوا بها مع عوائلهم. ويقول بابان، إن طبقة من المسؤولين والسياسيين جمعت ثروات كبيرة من خلال استغلال السلطة، فهم متيقنون أن سلطتهم لن تدوم، وهو ما يجعلهم يشعرون بالقلق، لذلك يسعون للحصول على جنسية دولة أخرى للجوء اليها وقت الحاجة. ويشير الى سبب آخر يدفع أعدادا كبيرة من المسؤولين لشراء جنسية دولة ثانية، ويتمثل بضمان حرية السفر لعوائلهم وقتما شاؤوا بقصد الترفيه أو السفر بهدف العلاج "لانعدام الخدمات الطبية والصحية المتقدمة في إقليم كردستان". وتتصدر محافظة السليمانية مناطق الإقليم في أعداد الأشخاص الحاصلين على جواز دومينيكا والساعين للحصول عليه. وتبلغ أعداد المُتقدمين نحو أربعة أشخاص شهريًا على الأقل لدى الشركة الواحدة، من مجموع سبع شركات محلية خاصّة تُروّج هذه المعاملات. وتتلقى بعض الشركات طلبات تقديم أكبر، وتتضاعف الطلبات في فترة اشتداد الأزمات في كردستان. وتأتي أربيل في المرتبة الثانية بعدد الأشخاص الحاملين لجواز السفر، لكنّها تتصدر محافظات كردستان بأعداد الشركات وعددها عشرة، إحداها تستحوذ على العدد الأكبر من المعاملات، وفقاً لأحد العاملين في هذا المجال. وتلي أربيل محافظة دهوك بالمرتبة الثانية بأعداد الشركات (9 شركات)، وثالثة على مستوى الإقليم في أعداد الحاملين والمقدمين على الجنسية. يؤكد (ش، ن) وهو صاحب إحدى الشركات المعروفة في أربيل المروجة لجواز دومينيكا، ما يتم تناقله بشأن أعداد المسؤولين الذين يحملون جنسية الدولة المذكورة. ويضيف إلى ذلك بالمرتبة الثانية رجال الأعمال الكبار وأصحاب رؤوس الأموال الذين بدأوا يدفعون أموالاً كبيرة للحصول على هذه الجنسية لعوائلهم. ويتفق صاحب الشركة مع المصادر الثلاثة بأن محافظة السليمانية تتصدّر محافظات كردستان في الترويج لهذه المعاملات، وأن أفراد الطبقة الغنية الجديدة يسعون للحصول على الجنسية وتحويل جزء من أموالهم وأعمالهم إلى الخارج، خوفًا من حصول انتكاسات اقتصادية أو هربًا من احتكار الاستثمارات من قبل الشخصيات الحزبية. وترتبط جميع الشركات التي تروج للحصول على جواز سفر دومينيكا سواء في كردستان بشكل خاصّ أو العراق عموماً بشركة واحدة (أ، إ) ومقرّها الرئيسي في مدينة السليمانية، والتي ترتبط بالشركة الرئيسية المخوّلة من وزارة خارجية دومينيكا في منطقة الشرق الأوسط (MontReal Management Consultants) . تزوير يوقف المعاملات ويُتهم مسؤولون في شركة (أ،إ) بتزوير وثائق والقيام بعمليات احتيال على مواطنين قدّموا معاملاتهم لدى الشركة للحصول على الجواز والجنسية، لكن "حلمهم" لم يتحقق أو تعطل بسبب ارتكاب مُخالفات في تجهيز أوراقهم وفي دقة تفاصيلها وصلاحيتها. حدث ذلك نتيجة تقديم وثائق مزورة من بعض المُتقدّمين، أو دمجهم مع عوائل أخرى مقابل أموال.يقول مصدر مطلع، ان مسؤولا في الشركة (د.س) "كسب ملايين الدولارات عبر عمليات تلاعب بالأوراق"، مبيناً أن العديد من الشكاوى بعمليات احتيال وتزوير وثائق رُفعت ضدّه، وهذا ما جعله مطلوبًا للجهات الأمنية، دون أن يُعرف مكانه عقب اختفائه قبل أشهر وإغلاقه هواتفه.لا يتوقف كارزان كمال (48 عاماً) عن التردد على مقرّ شركة (أ،إ) أملاً في الحصول على خبر يثلج صدره عن (د. س) الذي وعدهُ بالحصول على جواز سفر دومينيكا له ولعائلته المؤلفة من أربعة أشخاص (زوجته وولدان) مقابل (150 ألف دولار أميركي) دفعه في كانون الثاني يناير الماضي كدفعةٍ أولى. بحسب مصدر قريب من الشركة، راح العشرات من الساعين للحصول على الجواز الدومينيكي مثل كارزان بهدف الهجرة السهلة، ضحايا عمليات احتيال المُتهم الرئيسي فيها هو (د. س)، لتنتهي أحلامهم بصدمات قاسية خاصة وأن العديد منهم باعوا منازلهم أو محالهم التجارية وممتلكات أخرى من أجل تأمين المبلغ المطلوب، وخسروا أعمالهم وهم يسكنون اليوم في بيوت مؤجرة.يقول المصدر، إن (د.س) كان يشترط الحصول على أكثر من 100 ألف دولار أمريكي كدفعةٍ أولى لإجراء أية مُعاملة طلب من المواطنين العاديين والشباب العزاب للترويج لمعاملاتهم، وهرب بعد الكشف عن عمليات تزوير وثائق لمواطنين وصلوا إلى أوروبا وآخرين وقعوا في كمين إحتياله عليهم ولم يتم الرد على طلباتهم الى الآن بعد ان قررت حكومة دومينيكا تعليق معاملات حصول المتقدمين من كردستان على جنسيتها عبر الاستثمار.في العام 2020 دفع ازدياد أعداد المواطنين المتمكنين وأصحاب رؤوس الأموال الساعين للحصول على جنسية ثانية، برلمان كردستان ومن خلال لجنة العلاقات الخارجية والجالية الكردية، إلى اتخاذ خطوات بهدف منع شيوع شراء جواز ثانٍ، خاصة من قبل الشخصيات الحزبية والسياسية والطبقة الثرية. واستضافت اللجنة وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، وناقشت معهما أضرار ذلك بما فيه خروج مئات ملايين الدولارات من الإقليم بما يحمله من انعكاسات سلبية على اقتصاد كردستان، والخطوات الممكنة لوضع حدٍ لها. يقول عضو في اللجنة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه طرح شخصيًا على وزير الداخلية فكرة منع عمل الشركات والمكاتب التي تروّج لمعاملات الجنسية الثانية لمنع تحولها الى ظاهرة، ولأنها تتسبب بخروج أموالٍ طائلة من كردستان، إلا أن الوزير أكد عدم قدرته على ذلك لعدم وجود وسيلة للتكيف تحصل على الجواز الخطوة الأولى من إجراءات الحصول على جواز دومينيكا تبدأ بالاتفاق مع احدى الشركات العاملة لتقديم المستمسكات الثبوتية (هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة، البطاقة الخضراء، البطاقة التموينية، الجنسية العراقية) الخاصة برب العائلة وأفراد أسرته، وكذلك الحال مع العازب، لكن الأخير يكون المبلغ أعلى من الشخص المتزوج.وبحسب موظفين في شركات الترويج، تتبع خطوة تقديم الوثائق سلسلة إجراءات أمنية تتعلق بالشخص المُتقدّم، منها رفع البصمات من قبل شرطة الأدلة والجريمة وإرسالها الى مقرّ الشركة الرئيسية المعتمدة في الشرق الأوسط من خلال المكتب الوسيط، وتقوم الشركة بدورها بإرسالها الى الشرطة الدولية الإنتربول لغرض التأكيد فيما إذ كان الشخص سليم من الناحية الأمنية أو لا. المرحلة الثانية، تقوم الشركة المعتمدة ومقرّها في دبي بإرسال ملف الأشخاص المُتقدمين إلى وزارة خارجية دومينيكا التي تطلب دفع مبلغ مالي للاستثمار في ذلك البلد، وهو في حدّه الأدنى 100 الف دولار."لكن تلك الإجراءات لاتتضمن التأكد من مصدر الأموال، وفيما إذا كانت شرعية أم لا" يقول موظف في احدى الشركات، رفض ذكر اسمه.وبحسب سنوات العمر، فإن أسعار الأشخاص المُتقدّمين للجنسية ضمن العائلة الواحدة تختلف من شخصٍ إلى آخر، فمثلا تؤخذ نحو 5000 دولار أمريكي للأعمار ما بين (12-16 سنة)، ويزداد السعر إلى نحو 7000 دولار للأعمار ما بين (16-20 سنة)، ويصل السعر إلى نحو 10 آلاف دولار أمريكي لمن هم فوق 20 سنة. وتستغرق مدة الحصول على جواز السفر في حال كانت الإجراءات سليمة من (4- 6 أشهر)، وتصل أحيانًا إلى عام كامل للشخص الأعزب الذي يواجه صعوبات بسبب الإجراءات الروتينية الخاصة المُتبعة بحقهم. ويؤكد الموظف، أن "صعوبة الإجراءات الخاصّة بالأشخاص غير المتزوّجين، دفعت الكثير منهم إلى تزوير وثائقهم ودمجهم مع عوائل أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة تدفع لأصحاب المكاتب". ومن ضمن هؤلاء هاوكار جمال (26 عاماً)، الذي يقول بأنه تواصل مع صاحب إحدى الشركات المعروفة في أربيل وبعد مناقشة الاجراءات والمتطلبات، بدأ من الصعب جدا أن يحقق ما يريده، لأن المبلغ كبير بسبب كونه غير متزوّج، وحينها اقترح عليه صاحب الشركة تزوير وثائقه الثبوتية، وجعله فردًا ضمن عائلة أخرى قدمت أوراقها للحصول على الجواز والإقامة هناك. صاحب الشركة لم يجد عائلة توافق على تلك الفكرة، فاقترح أن يجعله فردًا ضمن إحدى العوائل الكردية الساكنة في أربيل دون علمها ولا علم الشركة الرئيسية بتلك الخطوة، وأكد له أن أوراق معاملاتها سترسل إلى دبي دون أي مشكلة تذكر. لم يكُ أمام هاوكار سوى الرضوخ لذلك المقترح الذي تضمن تزويراً واحتيالا وكان فيه شيء من المُغامرة، والذي كلّفه 12 ألف دولار أمريكي، ما عدا التكاليف والأتعاب الأخرى التي تتعلق بمستحقات الشركة التي قد تصل إلى 5 آلاف دولار أميركي في أقصى حدّ. بفضل هذا التزوير، استطاع هاوكار أن يحصل على الجواز ويُسافر به إلى بريطانيا ومن ثم يقدم نفسه كلاجئ هناك .يقول هاوكار، إن الحكومة البريطانية لا تُعيد أي شخص يقدم نفسه كلاجئ لديها حتى وإن كان قد وصل إليها بجواز سفر دومينيكا، لكنه يُشير إلى أن هذه الحالة تواجه فقط القادمين إلى بريطانيا من ألمانيا، فالكثير من المواطنين الأكراد والعرب أعادتهم السلطات البريطانية إلى ألمانيا رغم أنهم دخلوا إليها بجواز دومينيكا. حالة هاوكار ومئات غيره دفعت الحكومة البريطانية إلى تقديم شكوى لدى حكومة دومينيكا رداً على تسليم المئات من مواطني كردستان العراق أنفسهم كلاجئين بعد وصولهم إلى البلاد باستخدام جواز دومينيكا.استفّز ذلك حكومة دومينيكا، وعلقت على إثره وزارة خارجيتها معاملات الحصول على جواز السفر للمُتقدمين من كردستان العراق، بالإضافة الى مناطق كركوك وسنجار، وفقاً لحديث مدير برنامج (CBI) الدومينيكي إيمانويل نانتن لإحدى القنوات الكردية. وأكد المسؤول الدومينيكي تعليق إجراءات الحصول على جنسية بلاده دون تحديد مدة التعليق، مشيرا إلى تدقيق جميع الطلبات المقدمة لهم في الوقت الحاضر لمراجعتها والتأكد من صحّتها، ومن ثم البتّ فيها مجددا دون أن تأخذ أي مبلغ من مقدمي طلبات الحصول على الجواز. وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، لا تشمل الإجراءات الجديدة لحكومة دومينيكا، أولئك الحاصلين على جنسيتها أو حتى مراجعة ملفاتهم، لكونهم اجتازوا جميع مراحل التدقيق، ولاتوجد أي مخاطر باحتمالية سحب الجنسية من الذين زوّروا وثائقهم الثبوتية.ويكشف صاحب مكتب سفر في أربيل، نجح في الحصول على جنسية دومينيكا للعشرات من المواطنين في كردستان، وجود مئات الطلبات التي تم استرجاع ملفاتها لحين صدور القرارات والإجراءات الجديدة لحكومة دومينيكا حيال طلبات مواطني الإقليم.في انتظار ذلك، يشعرأصحاب المعاملات المقدمة بالقلق من ضياع الأموال التي دفعوها في حال رفض طلباتهم.ويتوقع صاحب الشركة، أن ترفع حكومة دومينيكا التعليق على طلبات التقديم نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل كحدٍ أقصى، ويؤكد من خلال معلومات حصل عليها من مصادر حكومية دومينيكية أن "الاجراءات ستكون مُشدّدة هذه المرّة، منها طلب حضور الأشخاص كلهم سويةً بأنفسهم في حال كان المتقدمون من عائلة واحدة لغرض التأكد من عدم وجود تزوير في الأوراق المقدمة، بالإضافة إلى اجراءات أخرى". ويبدي أصحاب شركات ترويج معاملات الحصول على الجواز الثاني، ثقتهم بعودة العمل، لاستحالة وقف البرنامج الذي يؤمن مبالغ كبيرة لتلك الجزيرة الصغيرة محدودة السكان التي تعتمد في جزء من موازنتها وتنميتها الاقتصادية على هذا النوع من الاستثمارات. وتم إنشاء صندوق التنوع الاقتصادي (EDF) في دومينيكا، وهو أحد طرق الحصول على الجنسية، بهدف توفير الأموال اللازمة لدعم نمو الاقتصاد وتطوير مشاريع القطاعين العام والخاصّ، ومنها بناء المدارس وترميم المستشفيات وبناء الملاعب الرياضية والنهوض بالزراعة وتشجيع السياحة، ما يؤمن لها نحو 16 بالمائة من ميزانيتها السنوية (من خلال البرنامج المذكور)، حسب تقارير حكومية وصحفية، وتُخطط لتوسيع ذلك بعد ازدياد الطلب على جواز سفرها خلال الأعوام الأخيرة.وهناك دول أخرى بمنطقة الكاريبي تحاول منافسة دومينيكا على استقطاب استثمارات "المال مقابل الجواز والجنسية"، حيث تقوم شركات ومكاتب سفر بالترويج للاستثمار المالي والعقاري في تلك الدول، خاصة وأن الغالبية الساحقة من الراغبين بالحصول على جوازات تلك الدول لا ينوون الإقامة والعيش فيها. ويلاحظ تزايد كبير لإعلانات دولة (سانت كيتس ونيفيس) على صفحات التواصل الاجتماعي في العراق، ويتم الترويج عبر شخصيات فنية معروفة في المنطقة.حقق من عمل تلك المكاتب. مليارات خرجت من كردستان يؤكد مستثمرون وتجار في إقليم كردستان، أن بحث المواطنين العراقيين عن دول تمنح الإقامة والجنسية لهم تسبب بخروج مليارات الدولارات من البلاد خلال العقدين الماضيين، ما مثل خسارة لفرص اقتصادية كبيرة. ويقول المُتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري كردستان ياسين محمود رشيد، إن أعداد المواطنين الكرد الذين قدموا طلبات للحصول على جنسية دول مثل دومينيكا وتركيا وإسبانيا واليونان وغيرها بات يقترب من 100 ألف بمبالغ باهظة تتفاوت بين (110- 400) ألف دولار أمريكي. يُقدّر رشيد مُجمل الأموال التي خرجت من الإقليم عبر هذا الباب بنحو 10 مليارات دولار أمريكي، وتسبّب ذلك بتراجع تنمية الاستثمار والاقتصاد في كردستان، مقابل زيادتهما في الدول التي تُقدّم هكذا عروضا، نتيجة فقدان الثقة من المستثمرين والأغنياء بالاستثمار في الاقليم. ويرى أن السعي للحصول على الجنسية أو الجواز الثاني لا ينحصر بالطبقة السياسية أو رجال الأعمال والأثرياء فحسب، بل هناك توجه كبير من فئات أخرى لاسيما الأطباء والقضاة والمحامين وغيرهم، هؤلاء يبحثون عن بيئات أخرى للاستثمار فيها غير بيئتهم الأصلية. يؤيد طبيب عراقي يقيم في أربيل، فضل عدم ذكر اسمه، كلام رشيد، مبينًا أنه يعرف أطباء وتجاراً حصلوا على جوازات دول مثل تركيا وقبرص وغيرها "لضمان مستقبل أبنائهم، فلا شيء مضمون في العراق". ويضيف "يحصلون على الجنسية ويسافرون باستخدام جواز تلك الدولة، ويؤمنون لأبنائهم الدراسة في جامعات أوروبية وربما العمل والإقامة فيها لاحقا". وينتقد المتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري كردستان غياب الإجراءات الحكومية لإيقاف أو تحجيم هذا التوجه الذي بدأ بالتزايد عامًا بعد آخر، لاسيما بين الطبقة السياسية والحزبية. ويؤكد، أن الكثير من المسؤولين الذين تسنّموا مناصب حكومية في حكومات سابقة في كردستان، بدأوا بنقل أموالهم وثرواتهم إلى دول أخرى من أجل الاستثمار. وهذا ما أثر على عجلة الاستثمار في الإقليم "كان مِن المُحتمل أن يتغيّر واقع الاقتصاد والاستثمار في كردستان كثيرا لو استثمرت الـ10 مليار دولار فيه". ويقدر رشيد أن ما يقرب من 200 ألف عراقي حصلوا على الاقامة والجواز والجنسية التركية مقابل دفعهم 250 ألف دولار أمريكي لتملك عقار أو عبر الاستثمار. ومع تزايد طلبات الحصول على الجنسية التركية رفعت حكومتها المبلغ إلى 400 ألف دولار في شهر أيار مايو المتركيا على خط خروج الأموال تشير أرقام معهد الاحصاء التركي (TUIK) الى أن عدد العقارات التي اشتراها العراقيون منذ بداية العام 2015 إلى النصف الأول من العام الحالي بلغ 46230 منزلاً. ويشير المعهد ان الأجانب الذين اشتروا أكبر عدد من المساكن في تركيا خلال 7.5 سنة كانوا عراقيين، فيما جاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بشراء 33404 منزلاً، بينما اشترى الروس 24877 منزلاً.واشترى العراقيون أكثر من 8 آلاف عقار في العام الماضي، وكان يرجح تسجيل رقم مماثل في العام الجاري، إلا أن رفع أسعار العقار للحصول على الجنسية، ربما سيمنع ذلك، مع توجه العراقيين لشراء عقارات في دول اخرى. يقول جميل حاجي، الذي يعمل في مكتب عقاري بتركيا، إن "السنوات الأخيرة شهدت بيع نحو 600 عقار شهريًا لعراقيين، وأن تلك الأرقام تصعد أو تهبط حسب الظروف الأمنية والاقتصادية داخل العراق"، مشيرا إلى تراجعها في العامين الأخيرين.ويرجع حاجي السبب الى "تراجع الثقة بتركيا كدولة مستقرة ذات اقتصاد جيد، حيث يواجه الاقتصاد التركي أوقات صعبة بفعل تزايد التضخم والانخفاض السريع لليرة، لكن ربما الأمر يرتبط أيضا بقيام آلاف العراقيين بالاستثمار وشراء عقارات في دول منطقة الكاريبي حيث المبالغ التي يتطلبها الحصول على الجنسية أقل مقارنة بتركيا". وبلغ عدد العراقيين الذين حصلوا على اقامات في تركيا بحسب احصاءات العام 2021 نحو 117 الف شخص. وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد ذكر في نهاية العام 2020، أن 114 ألف عراقي يتواجدون على الأراضي التركية. "غياب البيئة الآمنة للاستثمار" في كردستان، بسبب التدخلات، دفعت رجل الأعمال الكردي (ه. أ) إلى نقل 80 بالمئة من ثروته في نهاية عام 2017 إلى دومينيكا وتركيا على حدّ سواء، بعد حصوله على جنسية الدولتين نتيجة تعرضه لمساومات إثر افتتاحه فندقا من فئة 5 نجوم في أربيل كلّفه أكثر من 6 ملايين دولار. إذ يقول بأنه اضطر بعد نحو 3 أعوام من افتتاحه إلى بيعه بـ4 ملايين دولار "لرفضه دفع نسبة من الواردات الشهرية للفندق الى شخصية حزبية"، دون ذكر الجهة التي ينتمي إليها.اضي. بيئة طاردة لرؤوس المال يصف (ه.أ) الذي بات يزور الإقليم بجوازه التركي والدومينيكي في العام مرتين أو ثلاث بعد مغادرته كردستان أن البيئة الخارجية تُشجع على الاستثمار وهي "آمنة" جدا بخلاف ما موجود من مُساومات وأخذ أتاوات من الأثرياء هنا، وفي ظل غياب الدعم الحكومي، ما يهدد بهروب مزيد من رؤوس الأموال.ويؤكد أنّ الكثير من رجال الأعمال، وخاصة بعد الحرب على تنظيم داعش عام 2014 نقلوا رؤوس أموال كبيرة إلى تركيا بالدرجة الأولى ودول الخليج بالدرجة الثانية من أجل الاستثمار فيها.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة بإقليم كردستان في آب أغسطس 2022، أن نحو 300 مصنع توقف عن العمل في السليمانية بسبب مشاكل ضريبية واخرى متعلقة بالكهرباء والوقود وضعف البنية التحتية الصناعية، فيما ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية سيروان محمد، مطلع الشهر ذاته من أن 100 مصنع مهدد بالإغلاق في الإقليم إذا لم تحصل على دعم حكومي لمواصلة الانتاج.وفي نيسان أبريل الماضي، ذكر محمد عطا عبدلله نائب رئيس اتحاد الصناعيين الكردستانيين فرع السليمانية، أن أكثر من 800 شركة أفلست من أصل 1280 شركة في محافظة السليمانية، وتوقف قرابة 1000 مشروع بسبب الأزمة المالية التي بدأت في 2017، واستمرت حتى بداية العام الحالي. ووفق إحصاء لوزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان، أغلق أكثر من 700 مصنع في الإقليم خلال العام 2021 فقط، بينها 325 في السليمانية.توقف الفرص الانتاجية في الاقليم، نتيجة قلة الدعم أو الفساد والاحتكار، يعني ان أصحابها سيبحثون عن بيئات جديدة للعمل والاستثمار فيها. البحث عن حياة جديدة يحلم ملايين العراقيين بفرص للسفر الى خارج البلاد، بقصد الدراسة أو العمل أو السياحة أو الهجرة، لكن جواز السفر العراقي الذي يصنف منذ عقود كأحد أسوأ جوازات العالم، يحبط تطلعاتهم. بحسب مؤشر "هينلي" لجوازات السفر (شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة) فان الجوازين الياباني والسنغافوري يتصدران قائمة أفضل الجوازات في العالم ويتيحان السفر إلى 192 دولة من دون تأشيرة دخول، في حين، يقبع الجواز العراقي في المرتبة ما قبل الأخيرة، ويسمح بالسفر إلى 28 دولة فقط، ولا يأتي بعده غير الجواز الأفغاني الذي يسمح بالسفر الى 26 دولة، ويسبقه الجواز اليمني 33 دولة، والباكستاني لـ31 دولة، والسوري لـ29 دولة. هذا الواقع هو ما يدفع مئات آلاف العراقيين لمحاولة الحصول على جواز وجنسية دول أخرى تفتح لهم أبواب العالم، سواء عبر الهجرة غير الشرعية بكل مخاطرها، أو عبر الشراء القانوني، وهو ما تأمل خيرية كمال (32 عاما) أن تحققه. خيرية، يأست من تحسن أوضاع البلاد ومن إمكانية أن تحقق طموحاتها. هي تحملُ شهادة جامعية في الهندسة، لكن انعدام فرص التعيين أو الحصول على وظيفة مُستقرّة في محافظة السليمانية، دفعتها للتخطيط إلى الهجرة من خلال شراء جنسية دولة أجنبية لها ولزوجها وابنها البالغ عامين، بعد أن ورثت مبلغا من المال عن أبيها.تقول خيرية، إنها اضطرت للعمل كموظفة إدارية في مؤسسة إعلامية بعد أن فشلت في الاستمرار بوظائف أخرى في شركات عامة ضمن اختصاصها، وهي تتقاضى راتباً شهريًا لايتجاوز 500 دولار: "هو بالكاد يُغطي مع راتب زوجي تكاليف معيشة العائلة، فأنا أدفع نصفه لإيجار المنزل، فيما يذهب النصف الآخر لمواصلات العمل". السيدة التي تحلم بتأمين حياة مستقرة لعائلتها في إحدى الدول الأوروبية، تجادل بثقة "سأصرف هذا المبلغ الكبير، وأعيش في الغُربة لسنوات بكل ما ستحمله من صعوبات. يبدو الأمر غريبًا، إلا أنه الخيار الأفضل.. هنا لا راحة بال، لا مساواة، لا عمل يحفظ لك كرامتك".يقول زوجها الذي يؤيدها في ما تخطط له "الأثرياء لهم دوافعهم لشراء جنسية دولة ثانية كما متوسطي الدخل. والكل يدفع للنجاة بعائلته".يصمت لبرهة وكأنه يستذكر الكلفة الكبيرة: "هنا تجد كثيرين يبيعون كل ما يملكونه للحصول على جواز يفتح أبواب العالم في وجوههم، بصورة قانونية أو بأوراق مزورة، نعم هناك مغامرة وهناك مئات ملايين الدولارات تخرج من هذه البلاد.. أموال كبيرة نخسرها، لكننا لا نملك حلا آخر". التحقيق خاص بـ"العالم الجديد" وأنجز بالتعاون مع شبكة "نيريج"
عربية:Draw قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد، إن قوات الأمن في إقليم كردستان العراق، اعتقلت عشرات الصحافيين، والنشطاء، والسياسيين في 5 و6 أغسطس/آب 2022، قبل تظاهرات كان مخطط لها. في 1 أغسطس/آب، دعا رئيس حزب «حراك الجيل الجديد» شاسوارعبد الواحد إلى مظاهرات في السليمانية، وإربيل، ودهوك، لمواجهة تفاقم "الفساد والفقر والبطالة" في الإقليم. قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في "رايتس ووتش" إن "استخدام القمع التعسفي لقمع الاحتجاجات وترهيب النشطاء والصحافيين سيفاقم مظالم سكان إقليم كردستان العراق. لمعالجة غضب الناس، من الأفضل ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية، ومنها الحق في الاحتجاج السلمي. ووثّقت المنظمة، تصاعد استهداف وسائل الإعلام المستقلة والصحافيين المستقلين في كردستان في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى استخدام السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم «مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بالتشهير والتحريض ضد المنتقدين، بمن فيهم صحافيون، ونشطاء، وأصوات معارضة أخرى». 78انتهاكا رحمن غريب، مدير «مركز مترو» المختص برصد حرية الإعلام في الإقليم، قال للمنظمة، إن «المركز حدد 78 انتهاكا حقوقيا على يد قوات الأمن ضد 60 صحافيا ووسيلة إعلامية أثناء الاعتقالات». وحسب المنظمة، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 26 صحافيا، وصادرت معدات 23 صحافيا، ومنعت 16 صحافيا من تغطية الاحتجاجات. وزاد غريب: «أصبح واضحا لنا أن قوات الأمن تستهدف الصحافيين أثناء الاحتجاجات بدل حمايتهم. قوات الأمن تخشى عدسات الكاميرا لأنها تكشف سلوكها غير القانوني. فيما أوضح رئيس تحرير موقع "ويستغا نيوز" الإخباري المستقل، سيروان غريب، إنه احتُجز في السليمانية يوم الاحتجاجات، في 6 أغسطس/آب، لعدة ساعات مع العديد من زملائه. وبيّن: "عندما وصلنا لتغطية الاحتجاجات، صوّرتنا طائرة دون طيار تابعة للأسايش (قوات الأمن الداخلي) من مسافة قريبة لترهيبنا، فلوّحتُ ببطاقتي الصحافية حتى يعلموا أننا صحافيون". وحسب قوله فقد سعى إلى ضمان ظروف آمنة لتغطية الاحتجاجات من خلال الاتصال مسبقا برئيس بلدية السليمانية آوات محمد مطالبا إياه بتخصيص مكان للصحافيين في ساحة السرايا، موقع الاحتجاج، لكن رئيس البلدية لم يستجب. وقال صحافيون ونشطاء إن "عناصر الأسايش كانوا في الساحة قبل وصولهم. مع بدء الاحتجاج، أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والصحافيين، رغم أن الشهود قالوا إنهم لم يروا أي عنف يمكن أن يبرر استخدام الغاز المسيل للدموع أو الاعتقالات". ووفقاً لغريب مع استمرار الاحتجاجات، اعتقلت الأسايش مصوره زانيار مريوان، ثم، وبينما كان زملاؤه يحاولون مساعدته، اعتقلت الأسايش بقية الطاقم، لانيا بختيار، وأركان عبد القادر، وهيفار هيوا، بالإضافة إليه أيضا. عاملونا مثل المجرمين وأضاف: "نُقلنا جميعا في حافلة صغيرة إلى مقرات الأمن التابعة للأسايش، حيث صادروا هواتفنا الخلوية وعاملونا مثل المجرمين. لكن تغطية الأخبار حق أساسي وليست جريمة. أثناء التحقيق قالوا لي إنه ليس لدينا إذن (لتغطية الاحتجاجات). قلت لهم إنني صحافي، ولست في حاجة إلى إذن عند تغطية المظاهرات». وأطلِق سراحهم بعد ساعات قليلة دون توجيه تهمة إليهم. قال القيادي في حراك "الجيل الجديد" طه أحمد سعيد لـ"هيومن رايتس ووتش" إن "قوات الأسايش اعتقلت 86 من أعضاء الحزب، بعضهم قبل الاحتجاجات والبعض الآخر منذ بدايتها". وأشار إلى إنه في 6 أغسطس/آب داهمت الأسايش منزله، ثم منزل والده، وكلاهما في السليمانية، واعتقلته في منزل والده دون إبراز مذكرة توقيف. صادروا هاتفه الخلوي وهاتفَيْ أخيه وأخته، وفتشوا الهواتف ثم أعادوها. واحتجزت قوات الأمن سعيد في سجن كاني كومة في السليمانية لأربعة أيام، ثم أفرجت عنه بعد أن دفع كفالة، لكنها لم تخبره ما إذا كانت هناك أي تهم معلقة ضده. ومضى يقول: "أثناء التحقيق، سألني أحد الضباط: لماذا حرّضتم على التظاهر؟ قلت له إن الحق في التجمع حق أساسي للأحزاب السياسية ولأي مواطن. فكيف يكون جريمة؟". ووفق، عضو البرلمان العراقي عن حراك "الجيل الجديد" ريبوار عبد الرحمن، فإن النائبين في البرلمان العراقي عن الحزب أُميد محمد وبدرية إبراهيم اعتُقلا في طريقهما للمشاركة في الاحتجاجات. وقال: "الساعة 4:30 بعد الظهر، اعتقلتني الأسايش مع زميلي على بعد 200 متر فقط من ساحة المظاهرة" وضعونا في حافلة صغيرة وقادونا في جميع أنحاء المدينة لأربع ساعات، ثم أنزلونا في شارع الستين. لم تظهر لنا (قوات الأمن) مذكرة توقيف، فقط قالوا لنا إن لديهم أوامر باعتقالنا. هم يريدون فقط ألّا يحدث الاحتجاج". قال إنهم لم توجَّه إليهم تهمة. كما قال مدير مكتب شبكة "ناليا" الإعلامية المحلية في دهوك، طائف غوران، إن قوات الأمن اعتقلت 18 من موظفي المؤسسة في أربيل، ودهوك، والسليمانية. وبيّن إنه في 5 أغسطس/آب، عندما غادر مع المراسل بريار نيرواي مكتبهما، اعتقلتهما الشرطة المحلية، وصادرت معداتهما، بما فيها كاميرا وجهازين للبث المباشر، واقتادتهما إلى مقر شرطة طوارئ دهوك. من بين الموظفين الآخرين الذين اعتُقلوا مصور مكتب ناليا في دهوك عادل صبري، ومراسلة الشبكة في مكتب شيخان صباح صوفي، اللذان نُقلا إلى مقر شرطة الطوارئ في دهوك. وقال غوران: "لم تقدم إلينا قوات الأمن أي سبب قانوني لاعتقالنا. واعتقلوا 11 ناشطا أيضا. كنا 15 محتجزا". بعد 27 ساعة من الاحتجاز، أفرجت قوات الأمن عن الـ 15 جميعا بكفالة 5 ملايين دينار عراقي (3,430 دولار) لكنها لم تخبرهم بالتهم الموجهة إليهم. وغالبا ما تستخدم سلطات كردستان قوانين الإقليم، مثل قانون الصحافة وقانون منع إساءة استخدام معدات الاتصالات، ضد الصحافيين والنشطاء الذين يمارسون الحقوق الأساسية مثل حرية التجمع. يحظر هذان القانونان، من بين جملة أمور، إساءة استخدام الهواتف الخلوية والبريد الإلكتروني ـ أو، على نطاق أوسع، الإنترنت ـ لتهديد شخص ما، باستخدام ألفاظ نابية، ونشر المعلومات المضللة، ومشاركة الصور التي تتعارض مع القيم العامة، ومشاركة المعلومات الخاصة، حتى لو كانت صحيحة. ويتطلب القانون الكردي لتنظيم المظاهرات في إقليم كردستان العراق إذنا كتابيا لجميع الاحتجاجات من وزير داخلية الإقليم أو وحدة الإدارة المحلية. إذا رُفض الإذن، يمكن اتهام المتظاهرين بارتكاب جريمة. وقال كوغل: "غالبا ما تروّج السلطات الكردية لازدهار الإقليم واستقراره مقارَنةً بأجزاء أخرى من العراق. لكن الاعتقال الاستباقي بحق النشطاء، والسياسيين المعارضين، والصحافيين لمجرد تنظيم احتجاجات سياسية سلمية، وحضورها، وتغطيتها ليس مدعاة للفخر". في الموازاة، نظمت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل، أول أمس، لقاء مع صحافيين تعرضوا لممارسات "تعسفية" من قبل الحكومة. وذكر بيان للقنصلية، أن "موظفي القنصلية العامة الأمريكية التقوا بمجموعة من صحافيي إقليم كردستان العراق" مبيناً «أخبرنا العديد منهم أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي سابقاً، سمعنا قصصهم وفهم أفكارهم بشكل أفضل حول كيفية الدفاع بشكل أفضل عن حرية الإعلام وحماية الصحافيين». وأشار البيان إلى إنه «سمعنا بعض القصص المروعة، بما في ذلك من صوت أمريكا، الصحافية سنور كريم، التي روت أنها تعرضت للاعتقال التعسفي أثناء تغطيتها للاحتجاجات في السليمانية في أوائل/ آب أغسطس». وذكر أن «الولايات المتحدة تعتقد أن وسائل الإعلام والصحافيين يجب أن يكونوا قادرين على العمل دون خوف من الترهيب أو الاحتجاز التعسفي أو تفتيش الأجهزة الإلكترونية دون إذن قضائي أو التمييز بدوافع سياسية أو التهديدات أو الانتقام». قلق أمريكي وفي 8 آب/ أغسطس نشرت القنصلية الأمريكية في أربيل بياناً صحافياً تعليقاً على أحداث الاحتجاجات حينها جاء فيه: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين واعتقال الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء البرلمان في إقليم كردستان العراق خلال الاحتجاجات والفترة التي سبقتها، في السليمانية بتاريخ 6 آب / أغسطس". وأضاف البيان حينها: "لكي تنجح الديمقراطية، يجب على الحكومات حماية حقوق الإنسان والحريات العالمية المكفولة بموجب الدستور، بما في ذلك حرية التجمع والتظاهر السلميين، وحرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة مع مراعاة الأصول القانونية، وأيضاً حق الصحافيين في ممارسة أعمالهم بحرية وبدون تدخل". وحثّ، سلطات إقليم كردستان العراق على "مراجعة هذه الإجراءات وإعادة التأكيد على الأدوار الحيوية التي تلعبها الصحافة الحرة والتجمع السلمي وسيادة القانون في العملية الديمقراطية". القدس العربي
عربية Draw: وجه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق انتقادات شديدة لطريقة اللامبالاة التي تعتمدها إدارة الرئيس جو بايدن في العراق مما مهد الطريق أمام إيران لتكون لها ولحلفائها من الميليشيات اليد العليا في بغداد. ولم ترسل الولايات المتحدة أيّ إشارات إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يرغب في كسر السيطرة الإيرانية على العراق، ويتحمس لفتح قنوات التواصل مع محيطه العربي خاصة مع حلفاء واشنطن مثل السعودية، متمسكة بالحياد السلبي الذي سيمكن إيران من فرصة الانتصار مجددا في العراق. ولم تتدخل واشنطن في الانتخابات العراقية التي نجح من خلالها التيار الصدري في الفوز بالأغلبية في البرلمان، لكن حلفاء إيران يتجهون الآن لوضع أيديهم على المشهد السياسي من جديد. يرى المراقبون أن طهران تقف وراء المناورات التي يقوم بها الإطار التنسيقي بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهي التي تحركت لبناء تحالف شيعي – شيعي ضد الصدر، وحرصت على استقطاب الأكراد والسنة إلى صفها، بهدف ترك الصدر وحيدا في المشهد ليسهل تحييده وتكون هي صاحبة اليد العليا. وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان واشنطن منع سيطرة إيران مجددا على المشهد منذ 2003، ولا يبدو أن إدارة جو بايدن بذلت أيّ جهود لإحباط هذا السيناريو. وفي ما يقرب من تسعة أشهر، بين الانتخابات وانسحاب نواب الصدر من البرلمان ونزول أنصاره للاعتصام في المنطقة الخضراء، زار كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي العراق مرتين فقط، وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن عددا قليلا من المكالمات مع صناع القرار العراقيين في محاولة للتأثير على التطورات على الأرض. وربما تكون سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في العراق ألينا رومانوسكي قد مارست بعض الضغط بعد وصولها إلى بغداد في يونيو أيضا. لكن يبدو أنها فعلت ذلك دون دعم كافٍ من إدارة بايدن. واعتبر شينكر في مقال بمجلة “فورين بوليسي” أن غياب التأثير الأميركي في الحراك العراقي حول المناورات والضغوط والتحالفات بشأن تشكيل الحكومة لم يكن سهوا بل قرارا مقصودا، مستشهدا بقول مسؤول بارز في إدارة بايدن في ديسمبر بأن خطتهم كانت ترك الأمر للعراقيين. ولا تدرس واشنطن عادة نتائج الانتخابات في الدول الأجنبية، وتفضل بدلا من ذلك التركيز على دعم المؤسسات. وليس العراق حالة نموذجية للأسف نظرا إلى أن ديمقراطيته الوليدة كانت تكافح من أجل البقاء تحت ضغط ذراع إيران الطويلة في العراق، ميليشيا الحشد الشعبي التي يبلغ قوامها 100 ألف فرد. وكان من الممكن في العراق أن تساهم الانتخابات، في نهاية المطاف، في إضعاف قبضة إيران الخانقة، لكن فك الارتباط الأميركي أثناء عملية تشكيل الحكومة ترك فراغا ملأته طهران. وفي الآن نفسه زار قائد الحرس الثوري إسماعيل قاآني ومسؤولون إيرانيون كبار آخرون العراق ما لا يقل عن 10 مرات في الأشهر الأخيرة لتهديد خصومهم، وإقناع شركائهم المحليين بكيفية تنظيم الحكومة المقبلة. ورغم أن عدد الزيارات وحده لا يقيس اهتمام الولايات المتحدة، فإن التباين يشير إلى أن واشنطن قررت اتباع سياسة عدم التدخل. ولم تستخدم الإدارة النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي لحماية العملية السياسية التي تتعرض إلى هجوم إيراني. ويعتبر كل هذا أساسيا لأن العراق مهم للولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، حيث خسر الآلاف من الأميركيين أرواحهم للمساعدة في بناء عراق ما بعد صدام حسين. ويتمتع العراق، على عكس أفغانستان، بفرصة حقيقية ليصبح دولة ديمقراطية كاملة. وتقف الدولة على منطقة جيوستراتيجية حيوية، ولديها خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وهي في خط المواجهة ضد خطط إيران لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويرى مراقبون أنه مع اقتراب واشنطن من التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، تصبح مواجهة التدخل الإيراني في بغداد أكثر إلحاحا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. ويقول هؤلاء إنه بعد أن صوّت العراقيون بشجاعة للأحزاب المعارضة للهيمنة الإيرانية، سمح نهج عدم التدخل الذي تبنته إدارة بايدن في عملية تشكيل الحكومة لحلفاء إيران بسرقة النصر من فكي الهزيمة. ولسبب غير مفهوم يبدو أن العراق، حيث خاضت الولايات المتحدة حربين رئيسيتين في العقود الأخيرة، لم يعد أولوية بالنسبة إلى واشنطن. صحيفة العرب اللندنية
عربيةDraw : طبقاً لمصدر مطلع مقرب من الحكومة، أفاد أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تأجيل الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني هو اشتراط كل من تحالف السيادة السني، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، حضور ممثل عن زعيم التيار الصدري هذا الحوار، الذي عقدت جولته الأولى الخميس الماضي، بمشاركة جميع القوى السياسية باستثناء التيار الصدري. وفي الوقت الذي لم يعرف بعد ما إذا كان الشرط الذي وضعه تحالف السيادة والحزب الديمقراطي يعني إعادة إحياء لتحالف «إنقاذ وطن» الذي شكله الصدر قبل سحب نوابه من البرلمان خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشهد السياسي، أو أن السبب يعود لقناعة الطرفين السني والكردي أن أي حوار من دون مشاركة الصدر لن يجدي نفعاً، خاصة بعد التطورات الأخيرة ورفع الصدر سقف مطالبه وتهديده باحتمال اتخاذ خطوات غير مسبوقة. في سياق المعلومات المتسربة من الغرف السرية لمختلف القوى السياسية، لا تريد بعض القوى الأخرى خارج الإطار، وبالذات الكرد، ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني، والسنة ممثلين بتحالف السيادة، الانخراط في الصراع الشيعي - الشيعي، عبر المشاركة في جلسة برلمانية هي بالضد من توجهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. الأمر الذي من شأنه أن يعقد المشهد السياسي أكثر، فإن موقفي «السيادة» والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال قريباً من الصدر، وهو ما يعني إمكانية تشكيل ثلث معطل جديد في حال مضى الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة. وبالاستناد إلى تلك المعلومات، فإن تحالف السيادة السني وخصوصاً في ظل الحراك الجديد في محافظة الأنبار، والمتمثل في الإعلان عن تكتل جديد بالضد من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بات يراجع مواقفه، ولا سيما أن أطرافاً منه توجّه أصابع الاتهام لبعض الأطراف في قوى الإطار التنسيقي بأنها هي من تقف خلف محاولات إقصاء الحلبوسي أو خلق «ضد نوعي» له داخل المحافظة. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، فإنه في الوقت الذي لم يحسم موقفه داخل الإقليم مع شريكه الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، فإنه يرى أن عقد أي جلسة برلمانية تكون فيها الغالبية لقوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني يعني ضياع فرصة إمكانية تمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وفي سياق تفصيل هذه الجزئية، فإن الإطار التنسيقي أكد التزامه مع الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية الرئيس الحالي برهم صالح. وبينما تقوم قوى الإطار التنسيقي بتوجيه رسائل إلى مسعود بارزاني بشأن التفاهم مع غريمه الاتحاد الوطني، إما على مرشح متفق عليه، أو دخول الحزبين بمرشحين اثنين، فإن الديمقراطي الكردستاني لا يحبذ الدخول إلى قبة البرلمان بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية، خشية أن يكون الفوز حليف مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي سياق إمكانية عقد جلسة للبرلمان العراقي، فإنه طبقاً لما أعلنه النائب عن دولة القانون ثائر مخيف الجبوري تم جمع تواقيع لنحو 180 نائباً من كل الكتل السياسية، بمن فيهم نواب كرد وسنة، لعقد جلسة للبرلمان. وطبقاً للجبوري، فإن «الإطار سلّم التواقيع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي وافق على أن تعقد الجلسة بعدم حضوره شخصياً»، مشيراً إلى أنه «سرعان ما تغير موقفه بعد ضغط من نواب كتلته لضرورة حضوره الجلسة والمضي بإقرار القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية». وعن ردّه حول كيفية عقد جلسة لتمرير رئيس الجمهورية بـ180 نائباً فقط، أوضح أن «المجلس سيناقش 3 ملفات كبداية، وهي رواتب الموظفين وتأمينها وشحّ المياه والاعتداءات التركية». وأوضح أنه «في حال زاد عدد الحاضرين، ووصل إلى 220 نائباً، فسيتم تحويل الجلسة إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء». وأضاف الجبوري أن «كل نواب البرلمان حالياً لا يريدون حلّه، فحلّ البرلمان حلّ لأنفسهم، وهم لم يقدموا حالياً ما تصبو إليه جماهيرهم، وعليه فهم يدفعون لعقد الجلسة، بل وصل حال بعضهم بالتوقيع معنا لعقد جلسة البرلمان، من دون استشارة رأي كتلهم الشرق الاوسط
عربيةDraw : صلاح حسن بابان جبهة جديدة فُتحت أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد أن استيقظت العاصمة بغداد صباح أمس الثلاثاء على اعتصام لأنصاره أمام مجلس القضاء الأعلى، دفع الأخير إلى تعليق أعماله. وجاء التحرّك الصدري صوب مجلس القضاء بعد نفي القضاء إمكانية تنفيذ أبرز مطالب الصدر المتعلقة بحل البرلمان، قبل أن تنتهي المهلة التي وضعها الصدر له حتى نهاية الأسبوع الماضي، وتزامن ذلك مع صدور 7 أوامر إلقاء قبض بحق قادة في التيار -أبرزهم صباح الساعدي- بتهم تهديد القضاء وغيرها. الانسحاب والتصعيد مجددا بعد الاعتصام بساعات، نصح الصدر -عبر "وزيره الافتراضي" صالح محمد العراقي- أنصاره بالانسحاب والإبقاء على الخيام، ليستأنف إثر ذلك القضاء أعماله. لكن وزير الصدر عاد وجدّد التصعيد اليوم الأربعاء في بيان من 16 نقطة، أشار فيها إلى أن من سماهم "الثوار" سيخطون خطوة مفاجئة أخرى، في إشارة إلى الاعتصام أمام مجلس القضاء الذي نُفّذ أمس الثلاثاء، إذا قرّر الشعب الاستمرار في الثورة، وأن أكثر ما أزعج خصوم التيار هو المطالبة بتنحّي رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الذي يعدّ الداعم الأكبر للإطار التنسيقي. وقال الوزير إن الإطار التنسيقي يعدّ القضاء الحامي الوحيد، واستمرار الاعتصام يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة، مضيفا أن سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية. مشيرًا إلى أن الأغلبية مجمعة على أن الفساد ضرب المؤسسة القضائية ومنذ 20 عامًا، وتوقع أن يحاول القضاء كشف بعض ملفات الفسـاد "تجنبًا لاعتصام آخر"، حسب رأيه. وقال الوزير الافتراضي إن "أبواق السلطة تعالت ضد الثورة حين اعتصمنا أمام مجلس القضاء خشية كشف ملفات فسادهم"، مبينا أن تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا، وأن القضاء "يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية". كيف رد خصوم الصدر؟ وإثر التصعيد الأخير، قطع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مشاركته في القمة الخماسية بين العراق ومصر والأردن والإمارات والبحرين المنعقدة في مصر، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأزمة، وحذّر من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية "يعرض البلد لمخاطر حقيقية". واستغل خصوم الصدر التقليديين تصعيده ضدّ القضاء ليعزّزوا جبهتهم ضدّه، إذ وجه "ائتلاف دولة القانون" -خلال اجتماع لكتلته مع المالكي- تحذيرًا إلى التيار الصدري على خلفية التصعيد ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقال إن السلطة القضائية تواجه اعتداءً آثمًا وتجاوزًا مشابهًا لما تعرضت له السلطة التشريعية، ضمن مسلسل الاعتداءات الممنهجة على مؤسسات الدولة وهيبتها. وما حدث الأمس، يصفه القيادي في الإطار التنسيقي النائب محمد الصيهود "بتجاوز كبير" على النظام الديمقراطي والعملية السياسية. ويقول في تعزيز منه للقضاء إن القرارات التي اتخذها مهمة جدًا وإنه حافظ على العملية السياسية والنظام الديمقراطي، نافيًا في الوقت نفسه أن يقف بجانب طرف على حساب آخر؛ في إشارة منه إلى حديث وزير الصدر الذي اتهم زيدان بأنه الداعم الأكبر للإطار. وفي حديثه للجزيرة نت، يقرّ الصيهود بأن التصعيد الأخير ضدّ القضاء أثّر كثيرًا على طبيعة الحوار بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وهو متوقف تمامًا الآن، منتقدًا ما أسماه "حوارات التغريدات والإعلام"، في إشارة إلى تغريدات الصدر "التي لن تجدي نفعًا ولا يمكن أن تستمر العملية السياسية بطريقة التغريدات وإنّما يجب أن تكون الحوارات مُباشرة" كما قال. هل أقحم القضاء نفسه في الأزمات؟ وتماشيًا مع اتهامات الصدر لرئيس مجلس القضاء الأعلى بدعم الإطار التنسيقي؛ أثيرت عدّة تساؤلات حول أسباب مشاركته في اجتماعات القوى السياسية الأخيرة. ويرى المحلل السياسي محمد نعناع أن تحركات ومواقف رئيس المجلس "تصب دائمًا في مصلحة الإطار التنسيقي"، وتأكيده في أكثر من موقف ومناسبة أن حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة أمر صعب وغير ممكن في ظل الظروف الحالية. وهو بهذه المواقف والتحركات يحرج الصدر ويصطف مع خصومه. وأضاف نعناع أن مسار زيدان تكلل بحضوره جلسات القادة السياسيين، بل أكثر من ذلك دعا الإعلاميين والمحللين السياسيين في أكثر من مرة لتكرار أمور لا يجب أن تتكرر الآن "كصعوبة حل البرلمان وأن القضاء ليس جزءًا من المشكلة السياسية وأن الإجراءات الدستورية يجب أن تأخذ مجراها في عملية تشكيل الحكومة". وقال نعناع للجزيرة نت "كأنه غير مكترث لخرق التوقيتات الدستورية وراض بتقديم الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الوزراء بوصفه الكتلة الأكثر عددًا، وهذا ما لم يتم تأكيده قانونيًّا وسياسيًّا وبرلمانيًّا". وفيما إذا كان القضاء العراقي فعلًا قد أقحم نفسه في الأزمات السياسية، لا سيما الأخيرة منها بين الصدر والمالكي؛ يُجيب نعناع بأن القضاء عبر رئيسه فائق زيدان أقحم نفسه في الأزمة السياسية بطريقة سلبية، كما أنه يستبق المحكمة الاتحادية بإصدار مواقف من اختصاصها، كأنه يمنع إفتاءها ورأيها تحسبا لإقرارها قرارات في غير المسار الذي يسير به هو ويتناغم مع جهات سياسية يحضر اجتماعاتها باستمرار. هل يتنحى زيدان؟ يصف المحلل السياسي زياد العرار اعتصام أمس الثلاثاء أمام المجلس بأنه "خطوة لحث القضاء على فتح الملفات العالقة والمُتعلقة بالفساد والأمور الدستورية الأخرى". وعدّه رسالة للقوى السياسية بأن التيار مستمر في موقفه ومستعدّ للذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك لتحقيق مطالبه في عملية الإصلاح. ويرى العرار - في حديث للجزيرة نت- أن المشكلة ليست في القضاء، "وهو الذي يعتمد على السلطة التنفيذية التي فيها الخلل"، مُتهمًا الأخيرة بأنها لم توفر الأجواء الكاملة لعمليات التحقيق وكشف الملابسات أمام القضاء العراقي. لكنه يقرّ بأن "ضغوطا سياسية تُمارس على القضاء والكثير من القوى والأطراف السياسية تحدثت عن ذلك" وعن احتمالية أن تدفع الضغوط والاعتصامات رئيس المجلس إلى الاستقالة أو التنحي، يستبعد العرار هذا الأمر، ويتوقع أن تحصل إجراءات فعلية من القضاء، لكنه يؤكد أن التيار الصدري سيُمارس ضغوطًا أكثر على المجلس من خلال العملية الديمقراطية وفق الطرق السلمية لحثه على اتخاذ الخطوات اللازمة المتعلقة بفتح كل الملفات. المستفيد الأكبر وعلى الجانب الآخر، يُفسّر الباحث السياسي الكردي كوران قادر اعتصام أنصار الصدر أمام المجلس بالسعي للضغط على القضاء لاتخاذ قرارات في صالح التيار الساعي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بشتى الطرق والوسائل. وفي حال تجدد الاعتصام وعلق القضاء أعماله، يرى قادر في حديثه للجزيرة نت أن التيار الصدري سيستفيد من هذه الخطوة. عازيًا السبب إلى أن القضاء لن يقوم بأداء وظيفته، وتبقى بذلك الحكومة الحالية من دون رقيب على أعمالها بالتزامن مع عدم وجود رقابة برلمانية أيضا، وهذا يعني أن سلطة رئيس الوزراء تكون شبه مطلقة، وهو ما تسعى إليه بعض الأطراف في الوقت الراهن. ويتوقع الباحث الكردي أن يقوم القضاء العراقي برفع دعوى قانونية ضد كل من يتهمه بلا أساس قانوني أو يقوم بالتشهير به من دون دليل ملموس، بمن فيهم (صالح محمد العراقي) الشخصية الافتراضية الناطقة باسم الصدر. وفي حال لم يقم بذلك، "فإنه سيكون عُرضة للمزيد من التشهير والاتهامات من قبل كل من هب ودب، وهذا يقلل مكانته وثقله، وسيكون له وقع وتأثير على قوة أحكامه وقراراته". المصدر: الجزيرة

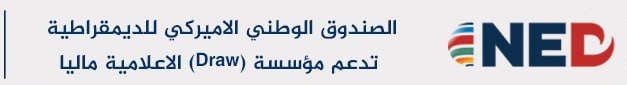
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.j)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)