حسني محلي تشهد تركيا نقاشاً مثيراً حول فترة السلطان عبدالحميد الّذي حكم الدولة العثمانية من آب/أغسطس 1876 وحتي نيسان/أبريل 1909، عندما أطاح به حزب الاتحاد والترقّي، ليحلّ محلّه السلطان محمد رشاد، ومن بعده السّلطان الأخير وحيد الدين، الَّذي غادر إسطنبول علي متن مدمّرة بريطانية بعد هزيمة الدّولة العثمانيّة في الحرب العالمية الأولي. وخلافاً لأحاديث المديح والتمجيد التي أبرزها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وإعلامه خلال السنوات الأخيرة، خرج رئيس تحرير قناة "TELE1" الإخباريّة المعارِضة ماردان ينار داغ، ليصف السلطان عبدالحميد بكلّ الصفات السيئة سياسياً، ويقول عنه إنه "سلطان استبداديّ دمويّ إجراميّ وخائن، باع كلّ ممتلكات الدّولة العثمانيّة التي خسرت في عهده 1.6 ملايين كم مربع من أراضيها، وكان السّبب في إفلاسها، كما باع فلسطين للصّهاينة". وقد أثار كلام ينار داغ ردود فعل عنيفة في الإعلام الموالي للرئيس إردوغان، فيما يستعدّ المجلس الأعلي للإذاعة والتلفزيون لاتخاذ قرارات صارمة بحقّ القناة. ورفع بعض أتباع إردوغان دعاوي قضائية ضد ينار داغ بتهمة الإساءة إلي رموز الأمة التركية. واكتسب هذا النّقاش أهميّة إضافيّة، لأنه تزامن مع أحاديث الأوساط السياسية والإعلامية في الداخل والخارج، والتي شبَّهت الرئيس إردوغان وحكمه بحكم السّلطان عبدالحميد بالمفهوم السيئ، فيما صوَّرت المسلسلات التي أخرجها أتباع إردوغان السلطانَ عبدالحميد "بأنّه بطل تاريخيّ تآمرت عليه كلّ الدول والقوي الإمبريالية والصهيونية، ولكنه انتصر عليها، فأسقطه الاتحاد والترقي، وهو حزب يسيطر عليه اليهود والماسونيون". وتتناقض المعلومات والأقاويل بين أتباع إردوغان الَّذين "يتغنّون بأمجاد عبدالحميد"، والمعارضين الذين يتحدّثون "عن النظام الاستخباراتي الشنيع التابع له، وهو الَّذي قام بتصفية كلّ معارضيه، بل إنه سجن مصطفي كمال أتاتورك 4 مرات في شبابه". ولم ينسَ هؤلاء الإشارة إلي أن عبدالحميد، وهو السلطان رقم 34 من بين السلاطين العثمانيين الذين حكموا الدولة العثمانية، وعددهم 36، لا يختلف عن أسلافه، فمعظم أمهات السلاطين غير مسلمات (مسيحيات ويهوديات وأرمنيات)، وهو الحال أيضاً بالنسبة إليه، فوالدته أرمنية، والبعض يقول إنها شركسية، فيما لم يشبه عبدالحميد السّلاطين الآخرين الَّذين قتلوا آباءهم وإخوتهم وأخواتهم وأقرب المقربين إليهم من أجل السلطة، كما قطعوا رؤوس أكثر من 45 رئيساً للوزراء وعدد مضاعف من الوزراء وكبار المسؤولين. ومع احتمالات أن يستمرّ هذا النقاش المحتدم بين أتباع عبدالحميد والمعادين له، فإنَّ الكثيرين يرون فيه علاقة مباشرة بما يتغنّي به الرئيس إردوغان عندما يتحدّث عن إحياء ذكريات الخلافة العثمانيّة علي الصّعيدين الداخليّ والخارجيّ. وتتّهم المعارضة إردوغان بالعمل علي إقامة حكم استخباراتي استبدادي، بعد أن سيطر علي جميع مرافق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، كما فعل السلطان عبدالحميد الّذي أوصل البلاد إلي حافة الإفلاس، وفق كلام المعارضة، التي تستغرب محبة إردوغان للسلطان عبدالحميد الّذي هُزم في جميع حروبه الخارجية. ويري آخرون في محبّة إردوغان وأتباعه لعبدالحميد علاقة مباشرة بين السلطان والسياسة الخارجية للرئيس التركي الحالي، الذي يسعي إلي استرجاع ما خسره الأخير خلال السنوات الأخيرة من حكمه في البلقان والقوقاز والعالم العربي. ويفسر ذلك سياسات أنقرة الحالية في التواجد والانتشار العسكريّ الفعال في سوريا وليبيا وقطر والعراق والصومال وأذربيجان، إضافةً إلي البوسنة وأفغانستان، تحت غطاء الأمم المتحدة وحلف الأطلسي، في الوقت الَّذي تستمرّ العديد من المؤسسات التركية الرسمية وغير الرسمية في أنشطتها المختلفة في العديد من دول الدولة العثمانية السابقة، مع دعم تركي رسمي وعلني لكلّ الجماعات الإسلامية الإخوانية في جميع أنحاء العالم، وفي مقدمتها الدول العربية التي تحكمها أو تتواجد فيها أنظمة أو قوي معادية للرئيس إردوغان، وفي مقدمتها مصر والسودان وموريتانيا والجزائر واليمن وتونس والأردن. ومثّل حديث إردوغان وإعلامه في بدايات الأزمة السورية عن التركمان في سوريا نهجاً جديداً في سياسات أنقرة التي أولت لبنان اهتماماً خاصاً، أولاً لقربه من سوريا، وثانياً لكثرة الأحزاب والقوي المعادية لدمشق فيه، وتردّد بعض زعمائه إلي أنقرة، التي كانت، وما زالت، علي علاقات وطيدة معهم ومع التركمان الّذين يعيشون في لبنان، والذين لهم علاقات واسعة مع مختلف أجهزة الدولة التركية، بحسب معلومات مصدرها جهات لبنانية رسمية. وتعكس كلّ هذه التحركات التركية، العلنية منها والسرية، في جميع أنحاء العالم العربي والبلقان والقوقاز وآسيا الوسطي، رغبة إردوغان في إحياء ذكريات الخلافة والسلطنة العثمانية بطابعها الجديد الذي عبَّر الرئيس الفرنسي ماكرون، ومعه المستشارة الألمانية ومسؤولون أوروبيون آخرون، عن قلقهم منه، لأنه بات يشكّل خطراً أمنياً علي أوروبا التي يتواجد فيها حوالي 5 ملايين تركي، إضافةً إلي 10 ملايين مسلم. ويعتقد إردوغان أنَّ هؤلاء سيتضامنون معه، بعد أن أعلن نفسه زعيماً سياسياً وروحياً للعالم الإسلامي الذي لم يعد تحت تأثير وسيطرة الفكر الوهابي لآل سعود، الَّذين خدموا المشروع الأميركي طيلة 70 عاماً الماضية. وبات واضحاً أنّ آل ثاني الذين تحميهم القواعد الأميركية يسعون إلي أن يحلّوا محلّ آل سعود، بدعم من جيش تركيا ذات التاريخ العثماني والجمهوري؛ الجيش الذي يريد له البعض أن يواجه إيران عند اللزوم! وتثبت كلّ هذه المعطيات وخطابات الرئيس إردوغان ومقولات إعلامه الذي يهدد الجميع ويتوعَّدهم، وخصوصاً مصر والإمارات والسعودية والأردن، أن تركيا لن تتراجع عن موقفها الحالي وسياساتها "التوسعية" ذات الطابع العثماني. بمعني آخر، إنَّ تركيا، وفي الظروف والمعطيات العربية والإقليمية والدولية الحالية، لن تنسحب من الأماكن الّتي يتواجد فيها الجيش التركي، الذي يبحث لنفسه عن مواطئ قدم جديدة في المنطقة. ويفسّر ذلك كلام إردوغان، الّذي علّل التواجد العسكري التركي في ليبيا ببقايا العثمانيين فيها، وقال "إنَّ عددهم مليون نسمة" من أصل 6 ملايين هم سكان ليبيا، كما سبق له أن تحدَّث عن "حقوق التركمان في سوريا والعراق". ولم تهمل أنقرة علاقاتها مع كلّ الأحزاب والقوي والجماعات والتنظيمات، السياسية منها والاجتماعية والمسلّحة، سراً كان أو علناً في العالم، وهي تري فيها جميعاً قوتها الاحتياطيّة لمواجهة أعداء تركيا العثمانية، وخصوصاً بعد أن بايعت معظم هذه القوي الرئيس إردوغان، بصفته الزعيم السياسيّ والروحيّ لكلّ الإسلاميين في العالم، وهو يريد لهم "أن يروا في إسطنبول، عاصمة الدولة العثمانية، كعبتهم الجديدة"، بعد أن دنَّس آل سعود الأماكن المقدسة في مكَّة المكرمة والمدينة، علي حد قول إعلام إردوغان الذي يتوعّد آل سعود وآل نهيان بالقضاء عليهم في عقر دارهم، إذا استمرّ عداؤهم للأخير في ليبيا وسوريا والعراق والصومال، أو أي مكان آخر في العالم يتواجد فيه الأتراك الذين يتغنّون بأمجاد السلطان القديم والجديد!
مصطفى فحص "أنا على حبل معلق بين بنايات كبار، لست مضطرا للمشي على الحبل فقط وإنما لركوب دراجة على الحبل، أرقص كل يوم مع الأفاعي لكنني أبحث عن مزمار أستطيع من خلاله التحكم بالأفاعي، فالصبر أفضل من الدخول في فوضى دموية وحرب أهلية، ألف سنة من الحوار أفضل من لحظة تبادل لإطلاق النار". هذا التصريح لرئيس الوزراء العراقي الكاظمي عبر الغارديان البريطانية في ختام جولته لمثلث القرار الأوروبي (فرنسا، ألمانيا بريطانيا)، لكن يبقى للعاصمة البريطانية لندن عند الساسة العراقيين معنى خاص. بالرغم من النفوذ والحضور الأميركي الهائل في العراق منذ 2003 بعد قرار جورج بوش تغيير الثوابت السياسية التي فرضتها بريطانيا على منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي ما بين الحربين العالميتين، وعملها مع فرنسا على تحويل الولايات العثمانية إلى دول مستقلة، حيث كان العراق الحديث بحدوده الحالية أحد أبرز نتائجها سنة 1921، لا يزال الوعي الجماعي للنخبة العراقية يعتبر أن بريطانيا هي الدولة الاستعمارية الوحيدة التي تعرف معنى العراق وتركيبته الاجتماعية والثقافية والدينية العشائرية والإثنية. لعل الكاظمي في حديثه للغارديان أراد لفت انتباه الإنكليز إلى معاناة من يكون على رأس الدولة من تلك القبائل والجماعات والحواضر التي روضتها بريطانيا عندما أعلنت انتدابها وفرضت عليها الانضمام إلى الكيان الجديد، إلا أن كلام الكاظمي يوحي أن تلك القبائل والجماعات والإثنيات قد تحولت إلى عشائر متصارعة وأحزاب دينية ومجاميع مسلحة وحواضر شبه مستقلة وقبائل متنازعة جهويا وعقائديا، وأصبحت كالأفاعي تحتاج إلى حاو صبور في ترويضها. تعود سياسيا مقولة الرقص مع الأفاعي إلى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ففي حوار أجراه الصحفي اللبناني خيرالله خيرالله على هامش حفل توقيع كتابه "حرائق اليمن ـ من انهيار دولة الجنوب إلى انهيار الدولة" عن علاقته الشخصية والطويلة مع الرئيس صالح أنه سأله مرة كيف ستحكم اليمن بعد أحداث 1994، فأجاب صالح "سوف أرقص فوق رؤوس الأفاعي"، لكن خيرالله يختم كلامه بالقول إنه على الرغم "من حرص علي عبدالله صالح في النهاية وجدت أفعى تلدغه"، والأزمة أن هذه الأفاعي التي اعتقد صالح أنه استطاع ترويضها، جاءت من الجحر نفسه الذي جاءت منه الأفاعي التي يحاول الكاظمي إما ترويضها أو الرقص معها. الواضح إيجابيا أن السلطة والحُكم لم يغيرا في طبائع الكاظمي، وهو لم يزل متمسكا في وسطيته واعتداله، لذلك يقول إنه يبحث عن مزمار يساعده على التحكم بهذه الأفاعي، وكان الكاظمي اشتكى في لندن أن ظروف العراق وضغوط الأصدقاء والأعداء تحول السياسي إلى حاو مهدد دائما بلدغ الأفاعي القاتلة. أثبتت التجربة أن الرقص مع سياسيين يتصرفون كالأفاعي لا يمكن أن تخرج منها إلا مصابا بلدغة، وهذا ما جرى مع أغلبهم، ومن أشهرهم شيخ الحواة في صعيد مصر ستينيات القرن الماضي، المعروف بموسى الحاوي وكما كاد أن يحدث مع بطل رواية "الأفعى الزرقاء" للأديب المغربي الطاهر بن جلون. فالحاوي في رواية بن جلون كان يراقص الأفاعي أمام السُّياح، كما يحاول الكاظمي مراقصة السياسيين في العراق، لكن بطل رواية بن جلون كاد أن يفقد اليقين ويموت من لدغتها لأن أفاعيه لا تستجيب لموسيقاه. طبيا هناك جدل بين العلماء حول نظام السمع لدى الأفاعي والثعابين، ويجمعون أنه يختلف تماما عن البشر والحيوانات الأخرى التي لديها أذان، لذلك لا تعتمد الأفاعي في سمعها على الطريقة التي تعتمدها غيرها من الزواحف بل تستعين بالحواس الأخرى، هذه الحواس التي لا تسمع المزمار أو لا تريد سماعه، فإن حواسها الأخرى قد تشعر بالألم من ضربة العصا مثلا، وهذا ما تؤكده الميثولوجيا الهندية "الغانا" بأحد أمثالها بأن "بالرغم من صغر حجم الثعبان فلا يزال من الحكمة ضربه بعصا كبيرة". يقول الهنود إن الأفاعي تحول الحليب إلى سم، وهذه الأفاعي حولت حليب وتمر وماء ونفط وهواء العراق إلى سموم، وهي ومنذ الأول من تشرين (أكتوبر) خرجت للدفاع عن جحورها في الدولة، ولن تترد في لدغ من يفكر في اصطيادها وترويضها أو قراءة تعويذة عليها، فالعازف على المزمار يتوقف عادة لالتقاط أنفاسه، لكن الأفعى تبقى مهتابة للنيل منه عندما تسنح لها الفرصة. لم يمر الكاظمي بتجربة يسارية أو شيوعية، لكن لديه أصدقاء مخلصين مروا بهذه التجربة، وعلى الأغلب قرأوا كثيرا عن نظرة كارل ماركس عن نشأة التاريخ وخصوصا قوله بأن "العنف قابلة التاريخ فمن رحمه تولد الإمبراطوريات"، أما طموحات الشعب العراقي تنحصر بولادة الدولة فقط، وهذا الشعب الذي أرهقته الانقلابات والحروب والعنف يرغب بعصا غليظة تضعها إلى جانبك وأنت تعزف على المزمار، لكن يا صديقي على من تعزف مزاميرك.
أياد السماوي ( إنّ حكم اليمن يشبه الرقص علي رؤوس الثعابين ) عبارة استعارها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من ملك يمني قديم .. نهاية الرقص علي رؤوس الثعابين انتهت باغتيال علي عبد الله صالح بطلقة في رأسه في الرابع من ديسمبر عام 2017 .. رئيس الوزراو مصطفي الكاظمي استعار هو الَاخر هذا المعني في ختام جولته الَاوربية التي شملت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمي , وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره بوريس جونسون ( أنا علي حبل بين بنايتين شاهقتين , لست مطالبا بالسير علي الحبل , بل أن أركب دراجة علي الحبل , وأنا أرقص يوميا مع الثعابين ولكني أبحث عن مزمار للسيطرة علي الثعابين ) .. إنّ من استعار حكمة الملك اليمني القديم وهمس بها بإذن الكاظمي , كان يقصد أمرا يَخر غير موضوع التوازن والصراع الجاري بين أمريكا وإيران علي الساحة العراقية .. بل أنّ من استعارها أراد أن يوصل رسالة من خلال الكاظمي مفادها أنّ المزمار الذي نبحث عنه للسيطرة علي الثعابين , يمرّ من خلال التطبيع مع إسرائيل ونحن جاهزون لاستقبال هذا المزمار .. هذا المعني تحدّث به صديق إسرائيل مثال الَالوسي قبل جولة الكاظمي الَاوربية .. الثعابين التي قصدها الكاظمي في حديثه لا تحتاج إلي عناو لمعرفتها , قطعا هم ليسوا الشركاو الَاكراد أو الَاخوة السنّة ولا حتي كلّ الشيعة .. بل الَاكيد أنّ الذين عناهم الكاظمي في استعارته الرقص مع الثعابين هم الفصائل الولائية , أي الفصائل التي ترتبط بعلاقة مصيرية مع إيران , والتي تقف بوجه المشروع الَامريكي الإسرائيلي في الشرق الَاوسط , وتطالب الكاظمي بإنهاو الوجود العسكري الَامريكي في العراق .. وعلي ما يبدو أنّ الكاظمي وصل إلي نقطة اللا عودة مع هذه الفصائل التي باتت تعتبر وجوده يشّكل خطرا علي وحدة وسيادة الوطن العراقي , بل أنّ مخاوف هذه الفصائل من استمرار الكاظمي وطاقمه الَامريكي علي رأس الحكومة العراقية من شأنه أن يجعل من العراق قاعدة إسرائيل الكبري في الشرق الَاوسط .. الذي يجهله الكاظمي أنّ الثعابين التي يرقص معها قادرة علي ابتلاعه هو وفريقه المتأمرك , متي ما أرادت ومتي اعتقدت أنّ ذلك ضروريا .. والمزمار الذي يبحث عنه مصطفي الكاظمي عند البريطانيين وحلفائهم , لا ينفع مع ثعابين هي من سلالة ثعبان موسي عليه السلام .. وعلي الكاظمي أن يتّعض من نهاية الذين رقصوا مع الثعابين قبله ..
منقذ داغر يسود اعتقاد واسع بين النخب العراقية أن الانتخابات المقبلة في العراق هي انتخابات مفصلية وستؤدي إلي حصول تغيير كبير في خارطة القوي السياسية المتحكمة بالمشهد العراقي منذ عام 2003. وقد تعززت هذه القناعة بعد إعلان الكاظمي عن مقترحه لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 6 حزيران 2021. كما زاد الأمل بحصول تغيير حقيقي بعد تعديل قانون الانتخابات العراقي بشكل جذري وتعيين مفوضية مستقلة جديدة للانتخابات تتألف من قضاة (مستقلين). كل هذه التغييرات المرتقبة جعلتني أفحص وعبر سلسلة من استطلاعات الرأي العام العراقي لأتبين ما إذا كانت تلك الظروف قد أنتجت آراء أكثر تفاؤلاً في الرأي العام العراقي حول طبيعة السياسة العراقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لقد كنت آمل أن أحمل لكم أخبار جيدة تتناسب مع هذه التوقعات المتفائلة بخصوص حصول تغيير كبير في الخارطة السياسية العراقية نتيجة الانتخابات، لكن يؤسفني أن أحمل بعض الأخبار السيئة التي قد تقلل كثيراً من هذا التفاؤل وتكشف مرة أخري عن فجوة عميقة بين ما تتوقعه النخب، وما يفكر به الجمهور العراقي. فقد كشفت استطلاعات الرأي العام الأخيرة أن الشارع العراقي، وبالذات الشباب منه لديهم رؤية مختلفة عن تأثير الانتخابات المقبلة علي تغيير الوضع السياسي. وفي الوقت الذي أجري فيه اثنين من هذه الاستطلاعات بواسطة عينة عشوائية احتمالية وطنية شملت 2000 و3000 مستجيب عراقي علي التوالي وباستخدام الكومبيوتر بدلاً من الورقة والقلم فإن الاستطلاع الثالث أجري باستخدام الهاتف CATI علي عينة عشوائية بسيطة شملت 1300 مقابلة. إن من البديهي القول أن الشرط الأول لتحقيق تغيير حقيقي في خارطة القوي السياسية العراقية المهيمنة علي البرلمان والحكومة منذ مدة طويلة، هو تحقيق معدل مشاركة عالي في الإنتخابات المقبلة يتجاوز ما حصل في انتخابات 2014، و2018. فمن المعلوم أن القوي التقليدية المسيطرة علي البرلمان لديها جمهور وقاعدة صلبة ستخرج لتصوت لها في كل الأحوال ومهما كان حجم تلك القاعدة صغير. لذلك فكلما قل معدل المشاركة في الإنتخابات كلما زادت فرص تلك الأحزاب وذلك نظرا لالتزام قواعدهم الانتخابية بالحضور والتصويت. وللأسف فلا تبدو النسبة المتوقعة للمشاركة في الإنتخابات المقبلة مشجعة إذ لن تتجاوز بحسب الاستطلاعات التي أجريناها 35-40 % ممن لهم حق التصويت. والمؤسف أن الغالبية المطلقة المقاطعة للانتخابات (أكثر من ثلثي المقاطعين) هم من الشباب بين 18-35 سنة. إن تشجيع العراقيين، والشباب منهم علي وجه الخصوص علي المشاركة في الانتخابات المقبلة ليس مهماً لإحداث تغيير في المشهد السياسي حسب، بل هو أهم لمنع الانزلاق نحو العنف والمجهول. ولكي يشارك الناس في الإنتخابات ينبغي أن يكونوا واثقين من شيئين مهمين وهما أن أصواتهم لن يتم تزويرها أو السطو عليها، وهذا يقتضي ثقة بنزاهة الانتخابات، و إن أصواتهم ستؤدي إلي التغيير الذي يريدونه ولن تكون جولة أخري من جولات خيبة الأمل التي إعتادوها سابقاً. تشير أرقام الاستطلاعات إلي أن أكثر من 60% من العراقيين عموماً (وفي بعض المناطق أكثر من ذلك بكثير) لا يثقون بنزاهة الإنتخابات ومن يثقون بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أقل من 30%. من جانب آخر فإن أقل من 15% من العراقيين يعتقدون أن تصويتهم في الإنتخابات المقبلة سيؤدي إلي تغيير المشهد السياسي والخارطة السياسية الحالية للقوي المؤثرة في القرار! هذه النتائج تؤكد أن الانتخابات المقبلة، إذا جرت في ظل الظروف الحالية، وما لم يحصل تغيير في عامل مؤثر علي معتقدات الجمهور العراقي، فإنها سوف لن تحدث التغييرات التي يأملها كثير من العراقيين وبخاصة أولئك الذين خرجوا إلي الشوارع منذ أكتوبر 2019 ليتظاهروا مطالبين بالتغيير. ومما يزيد الأمر سوءاً هو فجوة عدم الثقة بمؤسسات الدولة العراقية، رغم حصول تحسن ملموس في مستوي رضا العراقيين عن تلك المؤسسات وعن رئيس الوزراء مؤخراً. بالمقارنة مع أعلي درجة تفضيل بلغها رؤساء الوزراء السابقين له فإن درجة التفضيل الحالية للكاظمي هي الأعلي . مع ذلك فلا زال أكثر من 55% من العراقيين لا يثقون بالحكومة. كما أن أكثر من النصف أيضاً لا يثقون بالقضاء، في حين لا يثق بالبرلمان العراقي أكثر من 15% ولا بالأحزاب السياسية أكثر من 10% ولا ينتمي لتلك الأحزاب أكثر من 2% من شباب العراق. فجوة الثقة بمؤسسات الدولة العراقية والتي تتزامن مع إيمان واسع بوجود ما يسمي بدولة الأشباح أو سيطرة الدولة العميقة (غير الرسمية) علي الدولة الرسمية، جعلت كثير من العراقيين وبالذات الشباب يفضلون التغيير خارج الإطار المؤسسي. كما أن الفهم العراقي للدولة العميقة هو أن الميليشيات المتحالفة مع إيران تسيطر علي صناع القرار السياسي في العراق. وحتي لو كانت هناك تغييرات في هيكل سلطة الحزب السياسي، فإن الدولة العميقة ستستمر، وبالتالي لن تتغير طبيعة المجال السياسي العراقي وهو ما يهم حقًا. إن الشعور العميق بالتهميش بين الشباب العراقي وعدم ثقتهم بالمؤسسات السياسية وحاجتهم الطبيعية كبشر للشعور بالأهمية Needs for Significance هي التي جعلت إنتفاضة تشرين 2019 في بغداد وجنوب العراق هي الأطول والأشد قوة وتأثير منذ تأسيس الدولة العراقية في 1921. وما لم تستطع مؤسسات الدولة العراقية استيعاب واستقطاب هؤلاء الشباب فسوف لن يكون سوي العنف هو البديل عن الديمقراطية المعوقة التي حاولت الولايات المتحدة زرعها في العراق بعد 2003. إن توفير الضمانات الحقيقية والمقنعة من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي للشباب العراقي بأن الإنتخابات المبكرة المقبلة ستكون مختلفة هذه المرة وستتميز بالنزاهة والشفافية هو المخرج السلمي الوحيد والمتاح حالياً لتجنب سيناريو العنف والانزلاق للمجهول. ويبدو أن النافذة المتاحة لذلك تغلق تدريجياً ما لم يتم إنجاز عمل حقيقي في هذا الصد. "معهد واشنطن"
شيرزاد اليزيدي بعد عفرين التي طواها النسيان وما عاد أحد يتحدث عن معاناتها الوجودية بل تحول احتلالها وتتريكها إلي أمر واقع مع حلول الذكري السنوية الأولي لغزو "نبع السلام" التركي المسموم للمنطقة الواسعة الممتدة من سري كانييه (رأس العين) إلي كري سبي (تل أبيض) في كردستان سوريا شمالي البلاد هذه الأيام لا زال ثمة إيغال غير مفهوم من قبل سلطات الإدارة الذاتية لما تبقي من شرق الفرات في الاستهتار والاستسهال والتأقلم مع الكوارث والفواجع ليس بمعني الامتصاص الإيجابي والتقويم والتصحيح إنما بمعني المكابرة والانغماس في الخطيئة وتبرير الفشل بل وتصويره نجاحاً وتحويل الهزيمة وهمياً إلي نصر (علي ما هو جاري العادة في ربوعنا من أحمد سعيد مدير راديو "صوت العرب" المصري وصولاً إلي "قاهر" العلوج محمد سعيد الصحاف) وتقديم الكارثة كحدث عارض وهامشي وفق نزعة رغبوية متعجرفة ومنفصلة عن الواقع ترفض الإقرار بتحمل المسؤولية أقله أخذاً للعبر والدروس ولعدم الوقوع في الحفرة ذاتها مرة بعد أخري. كونها (الإدارة) وقعت في الحفرة نفسها غير مرة وما تشهده المناطق الكردية في سوريا من كارثة قومية وإنسانية خير مثال، فبعد عفرين التي طواها النسيان وما عاد أحد يتحدث عن معاناتها الوجودية بل تحول احتلالها وتتريكها إلي أمر واقع، تكرر السيناريو بحذافيره في مناطق أخري وبشكل أوسع وأكبر هذه المرة فمن سري كانييه إلي كري سبي وبطول نحو 130 كيلومتراً وعرض قرابة 30 كيلومتراً تتكرر مآسي الغزو والذبح والاغتصاب والنهب والتطهير العرقي والتغيير الديمغرافي لكن المفارقة أن الطرف الحاكم قبلاً في تلك المناطق (الإدارة الذاتية) يقفز علي كل هذه الوقائع المرة بكل خفة ليصور نفسه منتصراً. وشيئاً وشيئاً يشرع في تجاهل قضية هذه المناطق المحتلة وتهميشها التي لا شك أن لسياساته السلطوية قسطاً لا بأس به في تحمل وزر وقوعها تحت الاحتلال ما يمكن الذهاب إلي حد اعتباره تحالفاً موضوعياً حتي مع أنقرة بمعني ما لاحتلال هذه المناطق وتفريغها من أهلها الكرد وتسليمها لها ففي المحصلة ثمة توسع وتمدد تركيان علي الأرض وثمة إطلال فعلي وملموس لشبح تكرار السيناريو الشمالي القبرصي شمال سوريا هذه المرة. والأنكي أن الإدارة الذاتية إنما تبادر إلي ممارسة نوع من تعميم حال من التبجح واللامبالاة وطمس الحقيقة وتالياً التباهي بالمعارك الخاسرة وبتضييع الإنسان والأرض وبالقراءات والتحالفات السياسية الخاطئة وخلط الأمور وقلب المفاهيم في محاولة للتملص والتنصل من الحصاد الصفري البائس عبر الانتفاخ اللفظي وممارسة إرهاب فكري حتي ضد أي محاولة عقلانية ونقدية لسبر وتفكيك ما حدث من كارثة كبري يراد لها المرور مرور الكرام وكأن شيئاً لم يكن. فكردستان سوريا والمناطق الشمالية من البلاد ككل تعيش مأساة ونكبة حقيقية وما عاد التخفي خلف تضحيات الناس والمقاتلين كافياً ولا الترسانات الخطابية المؤدلجة للتغطية علي الواقع الرهيب والمرير فالتتريك وفرض وقائع جغرافية وسكانية جديدة علي الأرض من قبل سلطات الاحتلال التركية جار علي قدم وساق ودونما هوادة كما سبقت الإشارة ما لن يردعه الإنشاء الشعاراتي واللغو المقاوماتي الفارغ والكاذب. والحال أن وضع الإصبع علي الجرح والنقاط علي الحروف يستدعي الإقرار بلا مواربة أن هذه الإدارة فشلت فشلاً مدوياً والأنكي مضيها بنفس الطريق الذي سيودي في المحصلة بالكرد وكافة مكونات الشمال السوري للتهلكة الوجودية ويحول جلهم لسكان مخيمات العراء كما هي مع شديد الأسي حال سكان عفرين ولحقهم مع الأسف سكان سري كانييه وأخواتها من مدن وبلدات وقري يحتلها الجيش التركي الغازي بمعية مرتزقته في الائتلاف السوري وما يسمي الجيش “ الحر” الذين وصلت شرور ارتزاقهم وإرهابهم مؤخراً إلي أرمينيا والقوقاز والحبل علي الجرار.
كفاح محمود كريم قبل ثلاث سنوات وفي غفلةٍ من الزمن وبالاستعانة بالجنرال، قاسم سليماني، وحفنة من أهل الدار، اندسوا خلسةً في مناطق كوردستانية خارج إدارة الإقليم والمُسماة دستورياً بــ"المناطق المتنازع عليها" كما ورد في المادة 140 من الدستور العراقي، الذي وضع لها خارطة طريق لإنهاء ازدواجية علاقتها بين المركز والإقليم، وبخرقٍ فاضح للدستور الذي يحرم استخدام القوّات المسلحة في النزاعات السياسية بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات، اجتاحت ميليشيات منضوية تحت الحشد الشعبي وبمساعدة القوّات المسلحة العراقية وبإشراف مباشر من، قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني مدن كركوك وسنجار وسهل نينوي وخانقين، وحاولت التقدم باتجاه أربيل عاصمة الإقليم من عدّة محاور في التون كبري ومخمور وأخري في خاصرة دهوك، إلا أنها باءت بالفشل الذريع، حيث واجهت جداراً صلباً ومقاومة عنيدة من قوّات بيشمركة كوردستان، كلفها خسائر كبيرة في العدة والعدد، اضطرتها إلي وقف هجماتها والتقهقر إلي خطوط دفاعاتها، ووقف زحفها إلي الإقليم وعاصمته أربيل. واليوم وبعد مرور ثلاث سنوات من تلك العملية، التي أحدثت شرخاً كبيراً في العلاقات بين الإقليم وشعبه من جهة وبين العراق وحكومته من جهةٍ أخري، بل وكشفت نوايا الكثير من مفاصل الإدارة السياسية والتشريعية المبيتة ضد مكاسب شعب كوردستان وحقوقه الدستورية إلي الحد الذي استخدموا فيه مصطلحات غير دستورية لتقزيم الإقليم وإلغاء هويته السياسية، وفرض الحصار عليه بالتعاون مع كل من تركيا وإيران، مما تسبب في تقهقر شديد في العلاقات مع بغداد وإعادتها إلي المربع الأوّل. ورغم تداعيات تلك السياسة الخاطئة وتردي أوضاع البلاد بشكل مريع وفي كل النواحي، ما يزال البعض يحاول صناعة قصص وهمية لبطولات فارغة، يحاولون فيها صناعة نمر من ورق حينما يتحدثون عن أحداث كركوك وكأن رئيس الحكومة في حينها بطل من أبطال معارك الحرب العاليمة الثانية، وهم يدركون جيداً وفي مقدمتهم السيد العبادي بأنه لولا الصفقة التي عقدت بين مجموعة من الاتحاد الوطني وبين الجنرال، قاسم سليماني، وقيادات في الحشد الشعبي لما دخل كركوك إطلاقاً، والغريب أنهم يتحدثون عمّا حصل حينها، معتبرين تلك الأحداث المشينة عملية لفرض القانون، بينما هم ومن يعتبرونه "بطلاً" كانوا عاجزين عن فرضه في منطقتهم الخضراء، والأنكي من كل ذلك أنهم يتحدثون عن نصرٍ وهمي، متبجحين بقصصٍ واهية يعرف حقيقتها السيد عبادي، وهي أنه لولا تلك الصفقة، لما تحقق هذا الاجتياح المدّبر خلسة. إن الإجراءات التي اتُخذت إثر دخولهم المشين إلي كركوك واقحام القوات المسلحة في الخلافات السياسية خرقاً للدستور، ومنعهم لاستخدام اللغة الكوردية وعزل مئات الموظفين والإدارات من مناصبهم لكونهم من الكورد، وتهجير قرابة 180 ألف مواطن، ناهيك عن مقتل المئات من الكورد وحرق بيوتهم ومحلاتهم ومقرات أحزابهم كما حصل قبل عدّة أيّام في حرق مقر واحد من أعرق الأحزاب الكوردستانية والعراقية، وأكبر حزب كوردي عراقي في البرلمان، وإهانة علم الإقليم الدستوري، مما يدلُّ علي الكم الهائل من الكراهية والحقد علي الكورد وكوردستان، مما أشاع شعوراً مأساوياً لدي الشارع الكوردي، حينما يعجز عن وضع فرق بينهم وبين سلوك علي كيمياوي أبان النظام السابق، حيث أثبتت الأحداث والسلوكيات أنها امتدادٌ لتلك الثقافة التي دمرت البلاد والعباد طيلة أكثر من نصف قرن، ويقيناً ستكون النهايات ذاتها التي ينتهي إليها الشوفينيون في كل زمان ومكان.
وليد خدوري بادرت حكومة مصطفى الكاظمي بإطلاق محاولة للإصلاح الاقتصادي، في فترة تدهور أسعار النفط الخام على ضوء إغلاقات «كوفيد- 19» التي قلصت الطلب على النفط، ومن ثم تدهور الأسعار عن معدلاتها التي تراوحت بين حوالي 60 و70 دولارا، قبل تفشي «كوفيد- 19»، لتستقر منذ بدء فصل الصيف على معدل يتراوح ما بين 40 و45 دولارا لبرميل «برنت». أدى هذا التدهور السعري للنفط الذي يشكل نحو 90 في المائة من موارد الموازنة العراقية إلى عدم التزام الحكومة بدفع معاشات الموظفين والمتقاعدين لشهر سبتمبر (أيلول) المنصرم، نظرا لعدم توفر الأموال في الخزينة. يقدر عدد الذين لم يتسلموا معاشاتهم للشهر الماضي بنحو 6 ملايين نسمة، الأمر الذي خلق أزمة في البلاد، بالذات لأن المؤشرات تدل على صعوبة تحسن أسعار النفط في المستقبل المنظور؛ الأمر الذي يعني احتمال حجب الرواتب لهذا العدد الضخم من السكان وعائلاتهم مرة أخرى قبل نهاية العام. شكّل مجلس الوزراء العراقي خلية طوارئ للإصلاح المالي في 22 مايو (أيار) 2020. اجتمعت اللجنة أكثر من 20 مرة ما بين شهري مايو وأغسطس (آب). ترأس اللجنة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأدار اجتماعاتها الخبير الاقتصادي وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي. وأصدرت اللجنة «الورقة البيضاء» التي قدمت الحكومة من خلالها توصياتها الهادفة «بلورة أساس مشترك يمكن الاتفاق عليه وإقراره، يتبعه تقديم التشريعات الضرورية والإجراءات التنفيذية بموجبها». وذلك بعد احتمال إدخال بعض التعديلات عليها، ومن ثم تبني الورقة كسياسة اقتصادية مستقبلية. ألقت «الورقة» عبء الخلل الاقتصادي في البلاد منذ احتلال 2003 على القطاع العام، وعلى مجموع الشركات الصناعية التي تم تأسيسها في الفترة ما قبل الاحتلال. وشرحت «الورقة» بإسهاب الآثار السلبية لهذه الشركات، وحملتها مسؤولية عدم الكفاءة وعدم تنافسية أسعارها، وعن تكديس اليد العاملة فيها دون الحاجة لهذا العدد من العمال والموظفين. هذه عوامل سهل اتهام القطاع العام بها. ومن الواضح هناك شوائب في المصانع الحكومية؛ لكن عند سرد مساوئ الصناعات الحكومية كان من الضرورة الإشارة إلى الفساد والمحاصصات الطائفية. كان يتوجب أيضا سرد ضخامة عمليات التهريب عبر الحدود، ومدى الأضرار من نفوذ الطبقة السياسية في تعيين المحسوبين جزافاً، هذا طبعا ناهيك عن «الفضائيين» الذين يقبضون المعاشات دون الدوام أو تنفيذ أي عمل، ويتسلم المسؤول السياسي الذي عينهم جزءا من راتبهم. وقد شاعت - كما هو معروف - ظاهرة «الفضائيين» في عهد نوري المالكي. ركزت «الورقة» على عدم إمكانية منافسة شركات القطاع العام، وهذا أمر فيه بعض الصحة؛ لكن غضت «الورقة» عن سرد بعض أسباب هذه المشكلة خلال العقدين الماضيين. ومن ثم أعطت الانطباع بأنها تدافع عن سياسات حكومات عهد الاحتلال، رغم السياسات الاقتصادية الخاطئة لحكومات فترة الاحتلال، كما صرح بذلك بعض المسؤولين عن إعداد «الورقة». هذا النوع من النقاش أعطى الانطباع بأن «الورقة» هدفت الهجوم على السياسات الاقتصادية للنظام السابق، وغض النظر عن سياسات وأخطاء حكومات ما بعد 2003. طبعا، هذا رغم محاولة «الورقة» طرح سياسة اقتصادية جديدة للبلاد. من نافل القول إن السياسات الاقتصادية لحكومات ما بعد 2003 اعتمدت أساسا على الفساد والمحاصصات الطائفية، كما لم توفر الحاجات الأساسية للشعب العراقي، كان من أجل طرح سياسة اقتصادية مستقبلية توفر مراجعة وافية ومتوازنة للاقتصاد العراقي المعاصر. هذا لا يعني غض النظر عن المشكلات التي لحقت بالقطاع العام في عهد النظام السابق؛ لكن هذا لا يعني بتاتا أن سبب فشل الاقتصاد العراقي حاليا هو إدارة مصانع القطاع العام فقط، هذه المصانع والشركات التي تم نهبها وسرقتها خلال الأيام الأولى للاحتلال، ناهيك عن فساد الفترة اللاحقة. كان من الممكن - على الأقل - طرح أفكار جديدة حول إمكانية الاستفادة من هذه الاستثمارات الضخمة التي أفادت البلاد فترة طويلة. طبعا هناك إمكانية تخصيص هذه المصانع من خلال طرح أسهمها في البورصة، أو إعادة تشكيل ملكيتها كشركات مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص. لكن لكي يتم هذا بنجاح يجب أن تكون هناك ثقة لدى المستثمر العراقي بصحة ونظافة الأداء، بعيدا عن جو الفساد والمحاصصة الطائفية. من الجدير بالذكر، أن «الورقة» دافعت عن دور القطاع الخاص والشركات الخاصة؛ لكنها لم تذكر من قريب أو بعيد الدور المخرب لحيتان الفساد والاحتكارات الذين أرهبوا القطاع الخاص خلال العقدين الماضيين، ومنعوا من تأسيس الشركات الصناعية المنتجة، أو نموها بشكل طبيعي واقتصادي مستدام. كما لم تذكر «الورقة» أهمية بروز القطاع المشترك، والدور الذي يمكن أن يلعبه في اقتصادات البلاد. وإذا كان هناك من خلل في اقتصاد العراق خلال العقدين الماضيين، فهو إخفاق الحكومات المتتالية في أخذ المبادرات لدعم تأسيس «قطاع اقتصادي منتج»؛ خاص أو عام. نحن لا نتكلم هنا عن شركات الاستيراد والتصدير العديدة التي تم تأسيسها. ولم تتوفق «الورقة» أيضا في مناقشة أزمة الكهرباء في البلاد. فقد ألقت عبء المشكلة برمتها على المستهلك، والسعر الرخيص نسبيا الذي يدفعه المستهلك العراقي. ورغم صحة القول إن فاتورة الكهرباء لا تزال منخفضة في العراق؛ فإن هذا ليس عذرا لانقطاع الكهرباء عدة ساعات يوميا لسنوات متتالية. لقد خصصت الموازنات السنوية المتتالية منذ 2003 حوالي 55 مليار دولار لزيادة الطاقة الكهربائية. فما الذي حصل لهذه الأموال الطائلة؟ وهنا تبرز مرة أخرى مشكلة الفساد التي أغفلتها «الورقة». كما تبرز مشكلة إخفاق الدولة بعد 2003 في تخطيط وتنفيذ المشروعات الأساسية للبلاد. وهنا نذكر أيضا بإخفاق تنفيذ مشروعات تزويد البصرة بالمياه الصالحة للشرب. فالتقاعس هنا أيضا مرده الإهمال والفساد وقلة الخبرة عند المسؤولين. وينطبق الأمر أيضا على موضوع المولدات الكهربائية. وأغفلت «الورقة» دور أصحاب المولدات؛ حيث إن عددا كبيرا منهم من أعضاء البرلمان، وكيف أن بعض نواب الشعب كان يضغط على مؤسسة الكهرباء لقطع الطاقة الكهربائية عن منطقتهم، لكي يضطر المستهلك لاستعمال المولدات التي يملكها النواب. ولم تذكر «الورقة» أيضا لماذا ظاهرة المولدات الخاصة ظاهرة جديدة في العراق برزت ما بعد عام 2003؟ اعتبرت «الورقة» أن استمرار اعتماد العراق على الريع النفطي باعتباره المورد المالي الأساسي، أو التخطيط بالاعتماد على ارتفاع سعر النفط، هما أمران لهما محاذيرهما وخطورتهما. وهذا أمر صحيح، وتجب إعارته الأهمية اللازمة. لكن لم نجد في «الورقة» شرحا وافيا لما قامت به حكومات قبل وما بعد 2003 في مجال تقليص الاعتماد على النفط، وزيادة دور الطاقات البديلة المستدامة أو تطوير قطاع الغاز.
مأمون فندي لكل منا لحظات يراجع فيها نفسه ليغير سلوكاً ما، وأجدني واقفاً في هذا المفترق فيما يخص الشاشات الصغيرة والسوشيال ميديا، وهناك أحداث تكون فارقة في حياتنا تتطلب منا التأمل وبدء رحلة داخل النفس، خصوصاً أن الرحلات خارجها أصبحت قريبة من المحال في زمن الوباء، ومع ذلك فالسفر إلي دواخل النفس هو أمر شخصي لا يهم القارئ كثيراً، المهم في تجربتي ما هو عام أو قد يكون مشتركاً مع أناس مثلي، وبهذا يكون للموقف من السوشيال ميديا معني أوسع وتبعات أكثر عمومية تحث الآخرين علي التأمل والتفكير. السبب الأول، الذي قد يشاركني البعض أهميته، هو أن دراسات كثيرة تشير إلي أن أدوات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» وغيرهما هي نوع جديد من الإدمان. فرغم النشوة الأولي والاحتفاء بأدوات التواصل كفكرة تؤدي إلي دمقرطة المعلومات، فإن نتائج الدراسات الأولية تشير إلي عكس ذلك. فالناس لا يكتب بعضهم إلي بعض من أجل تواصل يوسع من مساحات الإدراك، ولكنهم يكتبون لتلك الآلة أو الكومبيوتر الكبير الذي يكافئنا بلايكات أو ريتويت وأحياناً تريندنغ، وإذا ما حصل أن أحدنا وصل إلي حالة الـ viral (سعة الانتشار للتويت أو البوست) يزيد استخدامه لأدوات السوشيال ميديا بحثاً عن لذة تلك اللحظة التي حدثت مرة واحدة في حياته بالصدفة وقد لا تحدث ثانية. ولكنها حالة الإدمان التي تجعل الناس يتصورون أنهم يوماً ما سيربحون الـ lottery أو اليانصيب الأوروبي الذي يصل أحياناً إلي أكثر من مائة مليون دولار في السحب الواحد، ولكن الحقيقة هي أن فرصة ربح من يشارك في السحب هي واحد من كل مائة وأربعين مليوناً، أي شديدة الندرة. يقول الباحثون في الإدمان إن مدمني المخدرات بأنواعها يحاولون استرجاع النشوة الأولي التي حدثت مع حالة التعاطي الأولي، وهي نشوة وهمية غير قابلة للاستعادة الكاملة، قد يقترب منها المدمن ولكنها ليست ذاتها تماماً، لذلك يستمر في التعاطي في حالة بحث دائمة ومستمرة، ولا يقتنع المدمن بعدم وجود تلك النشوة الوهمية إلا بعد علاج طويل الأمد. وكذلك الحال مع السوشيال ميديا، بحث مستمر علي تأكيد الذات والأهمية الشخصية من عدد لايكات وإعادات تغريد وتعليقات لا تعكس بالضرورة قيمة الكاتب أو أهمية المتلقي ولكنه الوهم، ومع ذلك ليس سهلاً أن تقنع نفسك أنه وهم. ومهم هنا أيضاً أن أوكد أن الإدمان ليس للمتفاعل وحده، فهناك من لهم حساب علي «تويتر» ويتعاطي سلبياً كالمدخن السلبي، وهؤلاء الذين يتخفون حول أسماء وهمية متفاعلة أو خلايا نائمة، هؤلاء يحتاجون علاجاً بجرعة أكبر، فهذا حال المدمن الذي لا يعترف أنه مدمن. سألت نفسي لماذا يكتب الناس، ومن دون مقابل وكل يوم وربما كل ساعة، لهذه الآلة الوهمية التي تبتلع كل شيء وتحوله لمجرد خزين بدائي وليس معلومات؟ الكتابة كانت يوماً ما حرفة، من يجيدونها يتلقون مقابلاً مادياً جراء القيام بها بإتقان، اليوم أصبحت الكتابة بلا مقابل. فهل أصبحت الكتابة فقط بحثاً عن تأكيد الذات وأهميتها؟ ولأنني من الصنف الأول قررت أن الكتابة من دون مقابل هو أمر يدخل في عالم النرجسية والإدمان. التوقف عن السوشيال ميديا أمر ليس بالسهل علي من دخل هذا العالم من إدمان الكتابة من دون مقابل، فمنذ أكثر من ثلاثة أعوام توقفت عن «فيسبوك»، ولكن عقلي تلاعب بي في حيلة مفادها أن «تويتر» هو أداة أكثر عقلانية للتواصل، أي أن عقل الإدمان بدلاً من قبول حالة الامتناع عن «فيسبوك» أحالني إلي وسيلة بديلة عوضاً عن التوقف التام، واستمرت كتابتي في «تويتر» لعدة أعوام لاحظت معها أن عقلي المدرب علي البحث والتقصي طوال سنوات الماجستير والدكتوراه والتدريس والبحث العلمي قد بدأ تدريجياً في الاضمحلال، ودخل في منافسة نحو القاع، وهنا قررت أن أضع حداً لهذا الانهيار. ذات يوم حدثني صديق أثق بحكمه علي الأمور، تعرفنا علي بعضنا منذ ما يقرب من ربع قرن في سياق أكاديمي ونبهني لحالة الانهيار التي أصابت من هم أفضل مني تفكيراً، حيث أكلت ماكينة «تويتر» و«فيسبوك» عقولهم، كما تأكل المخدرات عقول المدمنين، أو كما أكلت دابة الأرض منسأة سليمان. هذه المكالمة كانت لحظة فارقة في موقفي من السوشيال ميديا، وذلك لثقتي بصديقي الذي حادثني. ربما يكون تأثير السوشيال ميديا لمن هم في عمري ممن عرفوا التواصل الاجتماعي المباشر ولم يعرفوا التليفون العادي إلا في سن الشباب، وربما كانت فكرة الارتباط العالمي من خلال الإنترنت بالنسبة لهم من معجزات الخيال العلمي، يكون إدمان الشاشات الصغيرة عندهم أقل، لذا لا بد أن نفكر في مجتمع جديد مولود وفي يده تلك الشاشات الزرقاء الصغيرة. هنا يصبح ضرورياً علي المؤسسات الأساسية: الأسرة والمدرسة والدولة أن ترشد السلوك فيما يخص هذا الإدمان الجديد. كان الخروج من «فيسبوك» منذ أربعة أعوام نوعاً من الموت الرمزي علي تلك المنصة، والآن قررت أن أجرب الموت الرمزي علي «تويتر». الموت الرمزي يحدث في حالات الإدمان قبل الموت الحقيقي، ولكنْ في ذلك إنقاذ للنفس وللعقل، فالتضحية أو ذبح الأنا علي منصات التواصل نوع من التقرب إلي العقل قبل أن تحتل آلة «تويتر» و«فيسبوك» وغيرهما ما تبقي من مساحات عقل قادرة علي الكتابة الإبداعية. أذكر ونحن صغار كنا نذهب إلي البريد لجمع أوراق بها رسائل التلغراف، خصوصاً في حالات العزاء، وكان التلغراف أكثر اختصاراً من «تويتر»، لأن لكل كلمة سعراً ما عدا توقيع المرسل، وكان التلغراف يكلف عشرة قروش تقريباً للعزاء فكانت الكلمة بقرش. كان الناس يختصرون في كلام غالٍ، أما «تويتر» اليوم فيختصر في 240 حرفاً. ذات مرة وقفت أمام سيارة أنظر في الزجاج من أجل أن أعدل ربطة العنق، أي استخدام زجاج السيارة كمرآة، وفي حالة الهوس بالذات والاهتمام بضبط ربطة العنق لم ألاحظ أن هناك أحداً بداخل السيارة يرون في نظرتي وتركيزي تطفلاً علي عالمهم المغلق، لم أتوقف للحظة لأفكر في أنني أستخدم زجاج سيارة غيري كمرآة حتي رأيت عيون رجل وسيدة بالداخل ينظران إليّ كأني أحمق يراقبهما، وهكذا السوشيال ميديا، لذا لزم التوقف. ولكن الاختبار الحقيقي هو مدي دوام هذا التوقف، فقد حاولت من قبل الإقلاع عن التدخين وباءت محاولتي بالفشل، فهل مصير الإقلاع عن السوشيال ميديا مثل الإقلاع عن التدخين؟ الأيام قد تكشف مدي جدية هذا القرار. شرق الاوسط
عبدالجبار الرفاعي في نهاية ستينيات القرن الماضي اشتركتُ في الامتحان الوزاري الشامل للسادس الابتدائي، الذي نسميه في العراق "بكالوريا"، يجري هذا الامتحانُ لأبناء الريف في المدينة، كانت قلعةُ سكر أقربَ مدينةٍ لقريتنا، تبعد عنها 15 كم تقريبًا، أسكنونا في إحدي المدارسِ المعطلة، كان كلٌّ منا يحمل فراشا بسيطًا للنوم جلبه من أهله، منحتنا التربية مبلغًا زهيدًا لطعامنا، مشهدُنا في المدينةِ يثيرُ الاستهجانَ والشفقةَ، نسيرُ خائفين ملتصقين ببعضنا، لو تأخر أحدُنا عن أصحابه سرعان ما يلتحق بهم مذعورًا. أهلُ المدينة ينظرون إلينا بدهشة، لا تخلو من ازدراءٍ يلتبس بإشفاق،كأننا مخلوقاتٌ غريبةٌ هبطت من كوكب آخر. أطفالُ المدينةِ وشبابُها كانوا أشدَّ وطأةً في تعاملهم معنا، لا يكتفون بنظراتِهم الحادة القاسية وسخريتِهم المبتذَلة منا، بل يستغلون أيةّ ثغرةٍ تحدث في تكدّسِ مجموعتنا ليرجمونا بالحجارة، نفرُّ منهم ونحن نرتجف. دهشتُهم ربما تعود إلي منظرِنا غيرِ المألوف في كثيرٍ من الأشياء الغريبة عليهم، وجوهُنا كالحةٌ من سوءِ التغذية والحرمان، ثيابُنا منكمشةٌ، ألوانها متناشزةٌ، مشيتُنا ولغةُ أجسادنا مرتبكة. كانت الفجوةُ بين نمطِ ثقافة وحياة المدينة والريف واسعةً جدًا تلك الأيام، اللهجةُ مختلفةٌ، الزيُّ مختلفٌ، المطبخُ مختلفٌ، الاقتصادُ ونمطُ العيش مختلفٌ، بعضُ الأعراف ليست واحدة، العلاقاتُ مختلفةٌ، وكأن الفجوةَ لا حدودَ لها. تشكّلت شخصيةٌ مدينيةٌ تجاريةٌ للمدن العراقية تميز بوضوحٍ نسيجُها الحضري عن شخصيةِ الريفِ الزراعية والرعوية، قبلَ تقويض مدينية المدينة وتبعثرِ نسيجها الحضري في حروبِ صدام وفاشيتِه وسفهه، وجهلِ وعبثِ وفسادِ أكثرِ رجال السلطة من بعده. كان امتحانُ البكلوريا ثقيلًا مملًا، مخيفًا ككابوس مرعب، أتطلع للخلاصِ منه كلَّ لحظة، في اليومِ الأخير للامتحانات عدتُ مبتهجًا إلي مقرِّ اقامتي، وجدتُ كلَّ كتبي ودفاتري المدرسية ممزقةً، ومهشمةً كلَّ لوازمي المدرسية وأقلامي بحقد عنيف، تحوّل ابتهاجي فجأة إلي اكتئاب أغرقني في كوميديا سوداء. لم يكن هناك عداءٌ معلنٌ بيني وبين أيِّ تلميذٍ من زملائي، لم أتحسّس أيةَ ضغينةٍ ضدي من أحد،كنا متفقين منسجمين متحابين في الظاهر، لكن ليس بالضرورة أن يكون ما يخفيه كلٌّ منا من مشاعر متفقًا مع ما يظهره، اكتشفتُ لاحقًا أن ما يخفيه كثيرٌ من الناس علي الضدِ مما يعلنُه. لم أكن في ذلك العمر قادرًا علي فهم ما يختبيء في باطنِ كلِّ إنسان، وإن كان صغيرًا، من غيرةٍ ونفورٍ وغضبٍ وكراهيةٍ مضمَرةٍ لكلِّ منافس له،كلُّ إنسان يحاول التكتمَ لئلا يفتضح، وعادةً ما يعلن أكثرُ الناس المتنافسين احتفائهم بنجاحِ وتفوقِ زميلهم، وهم يضمرون غيضًا متقدًا، ينفجر أحيانًا لدي بعض الأشخاص الانفعاليين بتحريض وحتي عدوانٍ لا تُعرف دوافعُه ضدَّ الشخص الناجح، والأقذر عندما يتحول إلي مكائدَ خفية. لم أدرك أن هذه ضريبةٌ بسيطةٌ لنجاحي في المرتبة الأولي أو الثانية كلَّ سنوات دراستي، وعليّ أن أواصل دفعَ ضرائبَ شتي لـ "أعداء متطوعين" في كلِّ مراحل دراستي ومحطاتِ حياتي الآتية، لأن ضريبةَ نجاح ِكلِّ إنسان وانجازِه المميز باهضة. التساؤلُ الذي كان يؤرقني في طفولتي: لماذا يكره الأطفالُ العصافيرَ والطيورَ الجميلة فيلاحقونها، ويقطعون رؤوسَها بأيديهم، وهم جذلون؟! لماذا يكره الأطفالُ الكلابَ فيطاردونها بالحجارة، وربما يقتلونها؟! لماذا يكره الأطفالُ كلَّ شيءٍ غريبٍ علي محيطهم، فيرجمون السيارةَ الخشبية "اللوري"، وهي تسير بالحجارةِ ويهربون، مع أنه نادرًا ما كنا نري سيارةً تصل قريتَنا النائية؟! لماذا يكره الأطفالُ الأطفالَ؟! تضخّم هذا التساؤلُ وتعمّق في مراهقتي وشبابي، كنت أقول: لماذا يكره الإنسانُ الإنسانَ؟! هل يحتاج الإنسانُ الكراهيةَ أكثرَ من حاجته للمحبة، أم يحتاج الكراهيةَ كحاجته للمحبة، أم أن الكراهيةَ مرضٌ غريبٌ علي البشر وليست حاجة؟! لماذا لا تجدي نفعًا الكلماتُ الجميلةُ من رجالِ الدين والوعّاظ وغيرِهم في هجاءِ الكراهية والثناءِ علي المحبة؟! وقائعُ الحياة والعلاقات الاجتماعية تخبرنا أن الكائنَ البشري مثلما يحتاج المحبةَ يحتاج الكراهيةَ أيضًا، وأحيانًا يحتاج الكراهيةَ أكثرَ من المحبة، وهو ما نراه ماثلًا في حياتنا، بعضُ البشر يفرضون علي غيرِهم كراهيتَهم، أحيانًا لا يحتمي الإنسانُ من نزعةِ الانتقام العنيفة لديهم إلا بالهروبِ والاختباءِ بعيدًا عنهم، ولو حاول أن يتسامح لن يجدي نفعًا تسامحُه معهم، لو حاول الصمتَ لن يصمتوا، لو حاول الاحسانَ لن يكفّوا. هؤلاء "أعداء متطوعون" لا خلاصَ منهم، يتسع حضورُهم في المجتمع باتساعِ انهيارِ منظومات القيم، وتفشي الجهل، والفقر، والمرض، والحروب العبثية. يتحدث علماءُ النفس والأنثربولوجيا والاجتماع عن هذه الحاجة، ويكشفون عن جذورِها العميقةِ في الطبيعة البشرية، ويبحثون مناشئها في نوعِ التربية والتعليم، وشكلِ الثقافة والآداب والفنون، ودرجةِ التطور الحضاري، ومنظوماتِ القيم، ونمطِ عيش الإنسان وموقعِه الطبقي، والهويةِ الإثنية والدينية، وغيرها. الإبداعُ والابتكارُ والحضارةُ تعبيرٌ عن تفريغِ الكبت والكراهية في حياة الإنسان،كما يقولُ علمُ النفس الحديث. عندما أنظر لأعماقِ النفس البشرية بمجهرِ علماء النفس، لا أري في هذا الكائن ما يغويني بمحبته، وعندما أنظر لروح الإنسان بمجهرِ العرفاء والمتصوفة أري شيئًا من النور يغويني بمحبته. أدركتُ أن الطبيعة البشرية ملتقي الأضداد، فعملتُ منذ سنواتٍ طويلةٍ علي ترويضِ نفسي علي الحُبّ، كان هذا الترويضُ شديدًا شاقًا منهِكًا، ولم يكن سهلًا أبدًا. الترويضُ علي الحُبّ هو الأشق، خاصة مع "الأعداء المتطوعين"، لم أتجرعه إلا كعلقم، إلا أنه كان ومازال يطهرني من سموم الكراهية، وينجيني من أكثر شرور هؤلاء الأعداء. سرُّ الحُبّ أنه لا يتحقّقُ إلا بالحُبّ من يعجز عن إنتاجِ الحُبّ يعجز عن إنتاجِ معنيً للحياةِ، الحُبُّ أهمُّ منبعٍ لإنتاج المعني في الحياة، مادام هناك إنسانٌ فإن حاجتَه لمعنيً لحياته تفوق كلَّ حاجة. لغةُ الحُبّ لغةُ القلوب، لغةُ القلوب لا تخطئ، لغةُ القلوب لا يمكن التشكيكُ في صدقها، يتذوقها بغبطةٍ وابتهاج مَنْ تفيض عليه حُبّك، ولا ينجذب إليك مَنْ لا يتذوقها منك. بعضُ الناس عاجزٌ عن إنتاج الحُبّ، علي الرغم من حاجته الشديدة إليه، ربما يكون عاطفيًا بلا حدود، ربما يمتلكُ حساسيةً فائقةً يفتقر إليها كثيرٌ من الناس. عجزُه عن إنتاج الحُبّ يعود لعقدٍ نفسيةٍ وعاهاتٍ تربوية وجروحٍ غاطسة في لا وعيه، تفرض عليه حياةً خانقة كئيبة، لا يمكنه الخلاصُ منها أو تخفيفُ وطأتها إلا بمراجعة مصحّ نفساني. لا يمكن أن تُكرِه إنسانًا علي الإيمان أو الحُبّ، فكما لا إكراه في الإيمان، لا إكراه في الحُبّ. الإيمان الحُبّ من الحالات، والحالات أشياء وجودية لا ذهنية، وكل ما هو وجود لا تطاله الأوامر والقرارات المفروضة من الخارج مهما كانت، لذلك لا تستطيع أن تُكرِه شخصًا علي عدم الإيمان، أو تُكرِه عاشقًا علي ترك معشوقه، مهما فعلت معه، حتي لو سلطت عليه أقسي أشكال التعذيب. الحُبُّ كالضوء الذي يكشف عن كلِّ شيء ويُفسّره، غير أنه لا يحتاج إلي من يكشف عنه ويفسّره، وإن حاول أحدٌ تفسيرَه فهو عصيٌ علي التفسير. الحُبُّ حالةٌ، والحالاتُ أشياء وجودية، كما أن مفهومَ الوجود واضحٌ، وحقيقتَه عصيةٌ علي الفهم، هكذا الحُبّ مفهومُه واضحٌ، كنهُهُ مبهمٌ. ينطبق علي الحُبّ قولُ ملا هادي السبزواري في بيان حقيقة الوجود، فمفهوم الوجود واضح جدًا، غير أن كنهه غاية في الخفاء: مفهومُه من أعرفِ الأشياءِ وكنهُهُ في غايةِ الخفاءِ مثلما يُعرفُ الوجودُ بآثاره ومظاهره وتعبيراته، يُعرفُ الحُبّ بآثاره ومظاهره وتعبيراته وثمراته في حياة الكائن البشري. تعددت طرائقُ فهمِ الحُبّ وتفسيرِه وبيانِ آثاره المتنوعة علي القلب والروح والضمير والعقل والجسد، فكلُّ فن وعلم يفسّره من منظور يتطابق مع الوجهة التي يتجلي له فيها، الحُبُّ لا يتجلي إلّا جميلًا مُلهِمًا. وكأن الحُبَّ مرآةٌ لا يرتسم فيها إلّا ما هو رؤيوي مضيء. الحُبّ محُبّوبٌ لكونه حُبًّا لا غير. الحُبّ حاجةٌ أبدية، وكلُّ شيء يحتاجه الإنسانُ بهذا الشكل لا يحتاج سببًا آخر غيره يدعوه للظفر به. أشبع العرفاءُ الحُبَّ في كلّ الأديان بحثًا وتحليلًا، ومازال تحليلُهم لماهية الحُبّ هو الأسمي والأبهج والأعذب والأثري، وهكذا أنشده الشعراءُ في قصائدهم وتغنوا فيه بغزلياتهم، ونهض بتفسيره الفلاسفةُ في علم النفس الفلسفي، واهتم بالكشف عن آثاره المتنوعة ومظاهره وتعبيراته في حياة الفرد والمجتمع، كلٌّ من: علماء النفس، والاجتماع، والأنثربولوجيا، والأخلاق، وأخيرًا قدّم له علماءُ الأعصاب والدماغ تفسيرًا بايولوجيًّا.كلُّ علم وفن يفسّره من منظوره، ويشترك الكلُّ في التشديد علي عدم استغناء الإنسان عنه في أي مرحلة من مراحل حياته، وفي أية حالة يكون فيها، وفي أية محطة تصل حياتُه إليها. تظل الحاجة للحُبّ مزمنة، تولد مع الإنسان ولا تنتهي بوفاته، إذ يتطلعُ الإنسانُ في حياته إلي مَنْ يُخلِّد ذكراه بعد وفاته. الحُبّ ليس صعبًا فقط، بل هو عصيٌّ علي أكثر الناس، لا يسكن الحُبُّ الأصيل إلا الأرواحَ السامية، وكلَّ مَنْ يتغلّب بمشقةٍ بالغةٍ علي منابع الكراهية والعنف الكامنة في أعماقه. حُبّ الإنسان من أشقِّ الأشياء في حياة الإنسان، لأن هذا الكائنَ ليس آليا، بل هو بطبيعته أسيرُ ضعفه البشري، يصعب عليه أن يتخلص من بواعث الغيرة في نفسه، وما تنتجه الغيرةُ من منافسات ونزاعات وصراعات، واستعدادات للشر، وما يفرضه الشرُّ من كراهياتٍ مختلفة، وآلامٍ مريرة في حياة الإنسان. لا يكفُّ الإنسانُ عن الصراع مع غيره، ولا يتواني عن اللجوء لمختلف أنواع العنف اللفظي والرمزي والجسدي مع خصومه، وإن كانت للعنف دوافعُه المختلفة، ولا عنفَ من دون أسباب ظاهرة او كامنة، لكن أحيانًا يلجأ الإنسانُ للعنف بلا أيّ سببٍ ظاهر يدعوه لذلك. أكثرُ الناسِ في مجتمعنا مشغولون بالحط من بعضهم البعض، حياتُهم تضج بالكراهية والأحقادِ والضغائن،كلُّهم جائعون للمحبة غيرَ أن أكثرَهم يعجزون عن إنتاجها. يصعب جدًا بلوغُ الإنسان مرتبةً يصير فيها الحُبّ حالةً لا كلمة، الظفر بالحُبّ تجهضُه نزعةُ التعصب المترسبةُ في النفس البشرية، ويجهضُه التلذّذُ المضمَر غالبًا، الذي يتسلط علي المرء من حيث لا يشعر، لحظةَ نكباتِ الغير وانكساراتِهم وآلامِهم وأحزانِهم. الكلُّ يريد أن يحُبّه الكلُّ، ويكون محُبّوبًا للكلِّ، لكن الكائنَ البشري لا يتنبه إلي أنه لن يصبح محُبّوبًا للكلّ، ما لم يكن محُبّا للكل. لن يصيرَ الحُبُّ أصيلًا إلّا أن يصيرَ المرءُ مُحبًّا، العلاقةُ تفاعلية بين حُبّ الآخر لك وحُبّك للآخر. ليس هناك شيءٌ يُمنح مجانًا في الأرض، لن يحُبّك الآخرون مالم تحُبّهم، ولن يهبك الآخرون الحُبَّ، الذي هو أثمنُ عطاياهم، مالم تهبهم أثمنَ عطاياك. سرُّ الحُبّ أنه لا يتحقّق إلا بالحُبّ. لا علةَ للحُبّ إلّا الحُبّ، لا ينتج الحُبّ إلّا الحُبّ، لا ثمرة للحُبّ إلّا الحُبّ. مادام الحُبّ أثمنَ ما يظفر به الإنسانُ وأغلاه، فإن نيلَه يتطلب معاناةً شاقةً وجهودًا مضنية. الطبيعةُ البشرية ملتقي الأضداد، الإنسانُ أعقدِ الكائنات في الأرض، وأغربِها في تناقضاته، وتقلب حالاته. الحُبُّ حالةٌ لا تتكرّس إلا بالتربيةِ والتهذيب، ونحوٍ من الارتياض النفسي والروحي والأخلاقي، والتدريب المتواصل علي تجفيف منابع الشر والعنف والتعصب والكراهية المترسبة في باطن المرء، والعملِ الدؤوب علي اكتشاف منابع إلهام الحُبّ وتكريسها. كلُّ فعلٍ يرتدُ علي فاعله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. الحُبُّ أنجع دواء تحمي به نفسَك وتحمي به غيرَك من الآلام وشرورِ البشر. الحُبُّ يمكنُ أن يكونَ أجملُ دواءٍ لآلامِ القلبِ وجروحِ الروح، جربتُ الحُبَّ في مواقفَ متنوعةٍ فوجدت الحُبَّ يتغلّب علي ضجيج كراهيةِ الأعداء، ويخلّصني من حقدِهم، ويعمل علي فضحِ مكائدهم.كان ومازال الحُبُّ، كما جربته في حياتي، أنجعَ دواءٍ في شفائي وشفاء علاقاتي داخلَ العائلة والعمل والمحيط الاجتماعي من الأمراضِ التي تتسببُ فيها الكراهيةُ. جربتُ ألا دواءَ يخفضُ الآثارَ الفتاكةَ للشر، ولا سبيلَ لتخفيفِ آلام الكراهية، ولا وسيلةَ لتقليل النتائج المرعبة للنزعة التدميرية في أعماق الكائن البشري سوي المزيد من الاستثمار في الحب، بالكلمات الصادقة، والمواقف الأخلاقية النبيلة، والأفعال المهذبة الجميلة، والاصرار علي تجرّع مرارةِ الصفح والغفران، علي الرغم من نفور المشاعر منهما.
محمد توفيق علاوي طرح رئيس الوزراو العراقي مصطفي الكاظمي فكرة احياو مفاعل تموز النووي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتغيير اسمه الي مفاعل السلام، والحقيقة فقد كان هذا الطرح غريباً لَانه لا يمكن اعادة بناو مفاعل تموز الذي تحول الي بيئة موبووة نحاول ان نتخلص منها ومما تنفث من السموم النووية والتي استطعنا في نهاية المطاف وبقدرات عراقية من تفكيكها وطمرها وإزالة خطرها. اما بناو مفاعلات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية لا علاقة لها بمفاعل تموز فهو امر يفتقد للجدوي الاقتصادية حيث كلفة بناو مفاعل نووي واحد ينتج 1000 ميغاوات يكلف بين ثلاث الي خمسة مليار دولار في حين إن بناو محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل علي الغاز وبنفس الطاقة الانتاجية ل 1000 ميغاوات تبلغ بين 700 مليون دولار الي مليار دولار. أي أن الكلفة الاولية لمحطات الطاقة النووية تبلغ بين ثلاث الي خمسة اضعاف محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل علي الغاز، كما ان انتاج الطاقة والوقود النووي والتخلص من النفايات النووية تجعل انتاج الكهرباو من الطاقة النووية اعلي كلفة من كافة البدائل وبالذات انتاج الكهرباو علي الطاقة الشمسية التي هي البديل الامثل لإنتاج الكهرباو في العراق التي اصبحت كلفتها اليوم حوالي خمس (1/5) كلفة انتاج الكهرباو من الطاقة النووية. اما اكبر مشكلة يمكن ان نواجهها في انشاو محطات الطاقة النووية فهي الفترة الزمنية التي تتراوح بين خمس إلي عشر سنوات لإنشاو محطة كهربائية تعمل علي الطاقة النووية، اما بناو محطات من مصادر اخري للطاقة فتستغرق بين سنة إلي ثلاث سنوات، فضلاً عن المخاطر البيئية واستخدام كميات كبيرة من المياه للتبريد بما يؤثر سلباً علي البيئة، واكبر خطر يمكن مواجهته هو حدوث مخاطر غير متوقعة قد تؤدي الي حوادث بيئية ضخمة كما حدث في روسيا واليابان. لقد بدأت دول بايقاف جميع محطاتها النووية كالمانيا، اما فرنسا وسويسرا وبلجيكا فقرروا تخفيض الاعتماد علي الكهرباو من الطاقة النووية وعدم تجديد اي مفاعل نووي عندما ينتهي عمره الافتراضي بحدود الستين سنة، اما دول مثل النمسا وايطاليا واستراليا فقرروا عدم بناو اي محطة نووية لانتاج الكهرباو في دولهم، وفي عام 2017 أعلنت شركة (Westinghouse) أكبر شركة بناو للطاقة النووية في العالم إفلاسها، وسجلت شركة (Areva) التي تملكها الحكومة الفرنسية خسائر بقيمة 12.3 مليار دولار أمريكي، وفقدت شركات الطاقة النووية في كلٍّ من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وكوريا ما يتراوح بين 75- 89 % من قيمة أسهمها، كما سجلت نصف المحطات النووية في الولايات المتحدة خسائر بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار وفقًا لتحليل (Bloomberg).
علي حسن الفواز هذا السؤال الاستهلالي يمكن أن يكون مدخلا لقراءة الخطوط العامة للعملية السياسية في العراق، ولبيان مدي نضجها، وقدرتها علي النجاح والتواصل، وعلي تجاوز تاريخ مركزية الحكم السابق، وتكريس أطر الاستقرار السياسي، والتداول السلمي للسلطة، وخروجها بعيدا عن عشوائية الانقلابات التي لصقت بالذاكرة السياسية العراقية، فـ»ديمقراطيتنا البسيطة» ما زالت تعيش أزمة الفوبيا السياسية، وادارة الديمقراطية ما زالت أضعف من أن تواجه رعب المركزيات الكبري التي ورثها العراقيون منذ عقود طويلة. الديمقراطية وادارة السياسة، ثنائيتان تبدوان وكأنهما نقيضان، لكنهما متلاصقان في الجوهر وفي الوظيفة، لإنهما يخضعان لتوصيف واقع العملية السياسية، ولطبيعة الفاعلين فيها، ولخصوصية النسق الذي تتحرك فيها الفاعليات السياسية، وبيان مستوي نضجها، وقدرتها علي صناعة مشهد سياسي تداولي ونقدي، يرتبط بالمصالح، مثلما يرتبط بحسن الأداء. هذا التلازم، رغم أهميته، إلّا أنه سيكون داعيا لإثارة أكثر من سؤال، وبالاتجاه الذي يتعاطي مع توصيف السياسة بوصفها قوة حمائية، ومع توصيف الديمقراطية بوصفها مجالا لاختبار السياسة، إذ من الصعب علي السياسة أن تفرض قواعدها والياتها دون أن تقوم بحماية تلك القواعد، والمناطق التي تتحرك فيها، بدءا من قاعدة القانون، ومناطق المصالح والثروات والحقوق والسيادة والنظام والأمن وانتهاء بالديمقراطية، بوصفها مجالا أو مظهرا أو سياقا للقبول بتداولية الممارسة السياسية. ربط السياسة بحفظ المصلح فقط يمكن أن يقوّض أي تطور في الممارسة السياسية، ومنها ما يخص الديمقراطية، إذ تتحول السياسة الي سوق، والديمقراطية الي تبادل فاضح في المنافع، وفي المصالح أيضا، وربما لفرض ارادة علي حساب ارادة اخري. الديمقراطيَّة بوصفها مسؤوليَّة إنّ تعريف الديمقراطية اكاديميا يجعل منها أكثر تجريدا في التعبير عن الواقع، ليس لأنّ الديمقراطيات لا تتشابه، بل لأنّ التشابك العميق بين السياسة والديمقراطية هو ما يجعلها بحاجة الي الوضوح، والي التطبيق والي الواقعية، لا سيما أنها تتقنّع دائما بلبوسٍ أخري، فيها من التوافقية، ما فيها من البرغماتية، أو حتي الانتهازية، وهذا ما يجعلها مجالا لتشويه السياسة، ولمعني الديمقراطية ذاتها، وللخضوع الي ممارسات قابلة للتزييف والتزوير، أو للضغط من قبل الجماعات السياسية المهيمنة، حيث العرض والطلب، وحيث اشهار المصالح، وحيث فرضية القوي والضعيف، أو فرضية جودة السلعة وطرائق عرضها، والاعلان عنها. إن واقعية العملية السياسية في العراق تتطلب جهودا استثنائية، ليس لاعادة توصيف الخطاب والجماعة والهوية والسلطة فقط، بل لوضع هذه المفاهيم في سياق فاعل وحقيقي، قابل للنقد والمراجعة، وبما يجعل ممارسة السياسة، وممارسة الديمقراطية مسؤولية وطنية، وعملية واقعية، بعيدا عن الغلو، وعن التناشز السياسي والطائفي والقومي والجماعوي، لأن من ابسط شروط الديمقراطية هو وجود التنوع، والتعدد، والسلم الأهلي والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات، بما فيها حرية الرأي والاختلاف والمعارضة.
عثمان ميرغني «ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل». هذا عجز بيت شعر يصدق على أمور كثيرة، لكنه يعبر تماماً عن التجاذبات التي يعيشها الناس وسط دوامة أخبار كوفيد - 19. فالعالم يعيش حالياً على وقع أخبار التصاعد في الإصابات والكلام عن موجة ثانية من الفيروس المرعب دفعت العديد من الحكومات لفرض قيود جديدة. لكن الصورة لا تخلو أيضاً من بعض بوارق أمل. في بريطانيا التي بدأت أمس تطبيق خطة الثلاث مراحل المتدرجة التي تفرض بمقتضاها القيود على الأنشطة والتجمعات والحركة، وفقاً لفداحة انتشار الفيروس، تتسارع أيضاً وتيرة التجارب على اللقاحات التي وصل بعضها إلى مراحل متقدمة. فقد بدأ مستشفى «رويال فري» في لندن هذا الشهر المراحل النهائية من التجارب على اللقاح الذي طورته شركة «نوفافاكس» والذي كان قد أظهر نتائج إيجابية. وفي هذه المرحلة الثالثة من التجربة يتلقى المتطوعون جرعتين من اللقاح خلال ثلاثة أسابيع يكونون خلالها وبعدها تحت المراقبة الدورية لرصد تأثيره عليهم، وما إذا كانت هناك أي أعراض جانبية. اللافت أن تجربة «رويال فري هوسبيتال» شاركت فيها ضمن المتطوعين السيدة كيت بينغهام رئيسة اللجنة المسؤولة عن شراء وتأمين مخزون بريطانيا من اللقاحات ضد كوفيد - 19، ما يعني اهتماماً كبيراً بالتجربة في مرحلتها النهائية هذه التي يشارك فيها نحو عشرة آلاف شخص وتجرى بالتزامن مع تجارب في دول أخرى حول العالم. تجربة «رويال فري هوسبيتال» ليست الوحيدة التي بلغت مراحل متقدمة في بريطانيا، فهناك تجربة جامعة أكسفورد التي حظيت باهتمام واسع حول العالم بعد النتائج الأولية المشجعة التي حققتها ونُشرت في يوليو (تموز) الماضي. فالتجارب التي أجريت في أكسفورد على 1077 شخصاً توصلت إلى أن اللقاح الذي تم تطويره مع شركة «آسترا زينيكا» تسبب في تحفيز الأجسام المضادة واستجابة جيدة من الخلايا بعد جرعة معززة. وبعد أن بلغ اللقاح المرحلة الثالثة الحاسمة، توقفت التجربة في 8 سبتمبر (أيلول) بعد تعرض أحد المشاركين في بريطانيا لرد فعل سلبي. وأعلن لاحقاً أن رد الفعل الذي عانى منه المشارك في التجربة قد لا يكون ناتجاً عن اللقاح التجريبي نفسه، بل من حالة أخرى يعاني منها ذلك الشخص. لذلك أعلنت جامعة أكسفورد الشهر الماضي أن تجربة اللقاح ستستأنف في بريطانيا رغم توقفها في الولايات المتحدة. إضافة إلى هاتين التجربتين هناك تجارب أخرى واعدة حول العالم من أميركا وألمانيا وفرنسا، إلى الصين وروسيا والهند. فحسب منظمة الصحة العالمية هناك أكثر من 169 لقاحاً قيد التطوير في دول مختلفة، نحو 26 منها بلغت مرحلة التجارب البشرية، بعضها وصل طور التجارب الثلاثة المتقدمة. لكن يبدو أن الحكومة البريطانية تراهن وفقاً لتقرير بثته قناة «سكاي نيوز» الإنجليزية على ست تجارب تراها واعدة. فإضافة إلى تجربتي أكسفور و«رويال فري هوسبيتال» هناك اللقاح الذي تعمل عليه شركتا «بايونتيك» الألمانية و«فايزر» الأميركية، واللقاح الذي تعمل عليه «جونسون آند جونسون» الأميركية، أو ذلك الذي طورته شركتا «سانوفي» الفرنسية و«غلاكسو سميث كلاين» البريطانية. كل هذه اللقاحات بلغت مراحل متقدمة من التجارب ما يعزز الآمال في إمكانية حدوث اختراق مبكر رغم التحفظات السابقة. كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، سير باتريك فالانس، بدا متفائلاً مع طريقته المتحفظة المعهودة، إذ قال مؤخراً إنه ليس مستبعداً أن يتوفر لقاح ضد كوفيد - 19 بنهاية العام الحالي، لكنه سيكون بكميات صغيرة ولمجموعات معينة من الناس. عدا ذلك فإنَّ أي لقاح ينتج على نطاق واسع قد لا يتوفر قبل العام الجديد، هذا بالطبع إذا تخطت التجارب المتقدمة الراهنة عتبة المرحلة الثالثة وحصلت على التصديق اللازم للإنتاج من السلطات الصحية. العالم موعود أيضاً في يناير (كانون الثاني) المقبل بتجربة رائدة ستجرى في «رويال فري هوسبيتال» بلندن حيث يتوقع أن يتم تلقيح متطوعين بلقاح طورته «إمبريال كوليدج»، ثم يعرضون لفيروس كورونا لمعرفة مدى نجاعة اللقاح. مثل هذه التجارب التي يطلق عليها اسم «تجارب التحدي» تثير عادة كثيرا من الجدل الأخلاقي، لكنها تعد خطوة مهمة للحصول على إجابة سريعة حول ما إذا كان اللقاح فعالاً قبل إنتاجه وتوزيعه على نطاق واسع. ومع السباق المحتدم تتبنى منظمة الصحة العالمية مبادرة عالمية للعمل مع مصنعي اللقاحات لالتزام تمكين مختلف دول العالم من الوصول العادل إلى لقاحات آمنة وفعالة، بمجرد ترخيصها والموافقة عليها. والهدف هو ألا يحرم السباق على هذه اللقاحات الدول الفقيرة من الحصول عليها في وجه منافسة غير متكافئة مع الدول الغنية. والمبادرة المعروفة باسم «كوفاكس» (اختصار كلمتي لقاح كوفيد باللغة الإنجليزية) تعتبر وفقاً لمنظمة الصحة أكبر محفظة لقاحات لمواجهة الكوفيد -19 وأكثرها تنوعاً في العالم وتشمل تسعة لقاحات مرشحة، مع تسعة لقاحات أخرى قيد التقييم، وتجري المحادثات مع دول وشركات أدوية أخرى لضم منتجاتها إلى المحفظة. وحتى الآن فإنَّ مشاورات مبادرة كوفاكس تشمل 172 بلداً ومؤسسة. في انتظار تطوير لقاح لا ننسى الإشارة إلى أن الطب أحرز تقدماً كبيراً في مجال العناية الصحية بمرضى كوفيد - 19 مقارنة بالفترة الأولى من انتشار الفيروس. فمنذ ذلك التاريخ بدأ العلماء والأطباء يفهمون أكثر عن المرض ونجحوا باستخدام أدوية متوفرة مثل «ريميديسفير» و«ديكساميثازون» في تقليل فترة العلاج وفي مساعدة كثير من المرضى في تجاوز الفترة الحرجة والتغلب على المشاكل التنفسية من دون الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي إلا في الضرورة القصوى. وقد أدى ذلك إلى انخفاض نسبة الوفيات بشكل مطّرد. صحيح أن المرض أودى بحياة أكثر من مليون إنسان حول العالم، وهو رقم مفزع، إلا أن عدد من تعافوا منه يتجاوز 26 مليون إنسان. ومع ذلك يبقى مرضاً خطيراً لأنَّ الفيروس المسبب له سريع الانتشار، لهذا تشدد كل الحكومات والجهات العلمية والطبية على ضرورة توخي الحذر واتباع إرشادات الوقاية. المشكلة الكبرى تكمن في الضغوط التي تواجهها الحكومات لتحريك عجلة الاقتصادات التي تعرضت إلى ضربات عنيفة بسبب الجائحة. ففي الآونة الأخيرة صدر بيان باسم «إعلان بارينغتون العظيم» حمل توقيع 15 ألفا من العلماء والعاملين في القطاع الصحي من بينهم أساتذة طب في هارفارد وأكسفورد وستانفورد. ومنذ البداية كان واضحاً أن الإعلان سوف يثير الجدل ويواجه انتقادات لأنه أخذ توجهاً مخالفاً للإجماع العالمي والتوجه الذي اتبعته معظم الحكومات التي قررت إغلاق الاقتصاد وتعطيل كثير من الأنشطة لكبح جماح الفيروس، وتقليل الوفيات الناجمة عن كوفيد - 19. فالموقعون على الإعلان يرون أن الاستراتيجيات الحالية في الإغلاق سببت أضراراً هائلة للاقتصادات ومعاناة رهيبة للناس، وفشلت في الوقت ذاته في كبح جماح الفيروس الذي يبدو أنه يعود الآن في موجة ثانية. ولذلك فإنَّهم يجادلون بأن الشباب الذين تقل نسبة مخاطر إصابتهم بالفيروس، يجب أن يسمح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية من دون قيود أو معوقات، على أن توجه الحكومات مواردها للتركيز على حماية كبار السن والفئات التي تواجه خطراً أكبر بسبب حالتها الصحية. ورغم التشكيك في صحة أسماء وردت بالبيان، فإنه وجد صدى بين الداعين إلى فتح الاقتصاد، ورفع كل القيود، والمراهنة على استراتيجية مناعة القطيع. لكن في بريطانيا رد وزير الصحة مات هانكوك أمام البرلمان على هذه الدعوات بقوله «إن العديد من الأمراض المعدية لا تصل أبدا إلى مناعة القطيع، مثل الحصبة والملاريا والإيدز والإنفلونزا، ومع تزايد الأدلة على الإصابة مرة أخرى، لا ينبغي أن نثق بأننا سنصل إلى مناعة القطيع لكوفيد - 19، حتى لو أصيب الجميع به». وأضاف: «مناعة القطيع هدف معيب من دون لقاح، حتى لو تمكنا من الوصول إليه، وهو ما لا نستطيعه. وبالتالي من غير المحتمل، حتى مع وجود نسبة عالية من الأشخاص المصابين بالعدوى، أنه ستكون هناك حماية جيدة عبر مناعة القطيع». الرهان إذن يبقى على اللقاح والآمال تتعزز مع بلوغ عدد من التجارب الجارية مراحل متقدمة. فحتى لو لم يمكن القضاء تماما على كوفيد - 19، وهو المرجح، فإنَّ الناس سوف يستطيعون التعايش معه، من دون الرعب السابق الذي شلَّ العالم. الشرق الاوسط
شيروان الشميراني اتفاقية الادارة في شنكال بعد اندحار داعش منذ حوالي ثلاث سنوات، صورة جيدة للغاية لاعادة الدولة والسلطة الي البلدة، لها الكثير من التاثير علي طبيعة سير الامور في كل العراق و ليس محافظة نينوي فقط، ممكن اختصار تأثيراتها ويَثارها في نقاط قليلة وبشكل مختصر كالتالي: 1- انهاو حالة الفوضي واللادولة التي تعيشها البلدة نتيجة الاحداث التي تلت القضاو علي داعش، حيث مع وجود قائممقام او قوات عراقية الا ان الوضع في المدينة كانت شبه مستقلة وتدار عبر القوة من خلال ما يسمي بإدارة شنكال الذاتية الحرة في حين ان العراق كل العراق يدار عبر القائمقامية والمجلس المحلي المنتخب، ولا وجود في اي مكان في العراق لشيو بعنوان الادارة الذاتية التي تستقل بالادارة في اي قضاو او ناحية، ان الادارة المشكلة الحاكمة في البلدة هي استنساخ لما هو موجود في كوردستان سوريا، من ادارات ذاتية مستقلة لكل المنطقة ونزولا الي البلدات الصغيرة ومن بناة افكار حزب الاتحاد الديمقراطي او حزب العمال الكوردستاني، وهي تشكيل هيكل اداري من جميع المكونات علي ان تبقي هو المسيطر والاخرون لا يتعدي حضورهم الدوران في الفلك المرسوم. 2- انهاو حالة فوضي السلاح والادارة الامنية وانهاو المجموعات المكونة أثناو حرب داعش واستمرت وتوسعت بعدها، وبما ان البلدة تابعة لإدارة محافظة نينوي، فان القوات العراقية التابعة للحكومة الاتحادية هي التي تتولي السيطرة الامنية، وهي خروج من الخلاف من جانب يَخر حول قبول او عدم قبول حضور قوات البيشمركة، وهي التي تحاول الادارة الذاتية القريبة من حزب العمال اثارته عبر بيانات اعتراض ومحاولات المسيرات المحتجة، وكذلك ما يتعلق بوجود الحشد الشعبي في تلك المناطق وسهل نينوي، كما انه يشدد قبضة اليد الامنية المركزية النظامية علي التراب الوطني. 3- انها ازالة للحجة التركية بسيطرة حزب العمال علي المدينة، حيث في السنوات الماضية هددت انقرة بالهجوم علي جبل سنجار، بذريعة ان قوات الحزب المعارض لتركيا هي التي تتحكم، ومن هنا يأخذ هذا الاتفاق بعدا دوليا وجعل من الدول في مقدمتهم تركيا عبر سفيرها في بغداد ارسال التهنئة للطرفين. 4- ان حضور ممثلة الامم المتحدة في الجلسة التي انتجت الاتفاق، يعني ان المسألة تحتل اهمية لدي المنظمة الدولية، وتحتل عودة النازحين الي سكناهم مرتبة اولوية، ان سيطرة قوات امنية غير نظامية وكذلك ادارة مدنية شبه عسكرية وشبه مستقلة عن الدولة العراقية مع تبعية البلدة الي محافظة نينوي ادت الي تشكل الادارة الحاكمة غير المماثلة الي القائممقامية، ان تنظيف شنكال من السلاح غير النظامي التابع لوزارتي الداخلية والدفاع سيعبد الطريق امام النازحين او المهجرين قسريا لرحلة العودة الي منازلهم. ان شنكال عانت اكثر من اي بلدة عراقية من تداعيات الحرب مع داعش، فقد جمعت كل اسس المعاناة من طائفية دينية، ومن نزاع عسكري بين المكونات وسيطرة قوات غير حكومية التي منعت الاهالي من العودة، ومن نزاع سياسي وهيمنة بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والعمال الكوردستاني التركي، وكذلك بين مجموعات من الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكوردية، واكثر مدينة ذاقت ويلات التنظيم المتطرف من جميع النواحي المادية المعيشية والعمرانية والبشرية، تجلت كل ذلك في الهدم والتدمير للبني التحتية ومن قتل وذبح واختطاف للَاسر الشنكالية. هذه الاتفاقية تخفف من سياسات تركيا ومن سيطرة حزب العمال ومن قبضة الميليشيات، وتسحب البساط من تركيا، وتعيد الهيمنة والنفوذ الي السلطة الاتحادية في بغداد والادارة في الاقليم، وتزيل عقبة امام او في طريق الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بسط السيطرة والتخطيط للانتخابات المقبلة. كما ان مهاتفة السيد مسعود البارزاني لرئيس الوزراو العراقي تحمل العديد من الدلالات حول الاتفاقية وكذلك اهتمام دول الجوار، ويبقي التحدي الحقيقي المتمثل في تنفيذها.

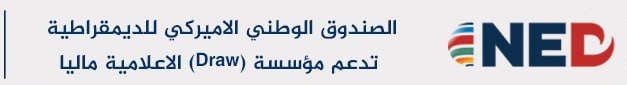
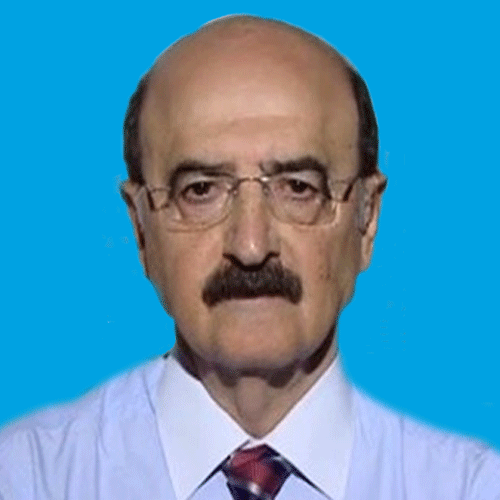













.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)