الحصاد: يكتنف الغموض قادة حركة طالبان التي يبدو أنها في طريقها للعودة إلى السلطة في أفغانستان بعدما سيطرت على الجزء الأكبر من البلاد خلال أيام، كما حدث تماما عندما حكمت البلاد بين 1996 و2001. الملا هيبة الله أخوند زاده، القائد الأعلى عُيِّن الملا هيبة الله أخوند زاده قائداً لحركة طالبان في أيار/مايو 2016 أثناء انتقال سريع للسلطة بعد أيام على وفاة سلفه أختر محمد منصور الذي قُتل في غارة لطائرة أميركية مسيرة في باكستان. قبل تعيينه، لم يكن يُعرف سوى القليل عن أخوند زاده الذي كان اهتمامه منصبا حتى ذلك الحين على المسائل القضائية والدينية أكثر من فن الحرب. كان عالم الدين هذا يتمتع بنفوذ كبير داخل حركة التمرد التي قاد الجهاز القضائي فيها، لكن محللين يرون أن دوره على رأس طالبان سيكون رمزيا أكثر منه عمليا. وأخوند زاده هو نجل عالم دين وأصله من قندهار قلب منطقة البشتون في جنوب أفغانستان ومهد طالبان. وقد بايعه على الفور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. وقد أطلق عليه المصري لقب "أمير المؤمنين" الذي سمح له بإثبات مصداقيته في أوساط الجهاديين. تولى أخوند زاده المهمة الحساسة المتمثلة بتوحيد طالبان التي مزقها صراع عنيف على السلطة بعد وفاة الملا منصور وكشف عن إخفائها لسنوات وفاة مؤسسها الملا محمد عمر. وقد نجح في تحقيق وحدة الجماعة وكان يميل إلى التحفظ مكتفيا ببث رسائل سنوية نادرة في الأعياد الإسلامية. الملا عبد الغني برادر أحد مؤسسي الحركة عبد الغني برادر ولد في ولاية أرزغان (جنوب) ونشأ في قندهار. وهو أحد مؤسسي حركة طالبان مع الملا عمر الذي توفي في 2013 لكن لم يكشف موته إلا بعد سنتين. على غرار العديد من الأفغان، تغيرت حياته بسبب الغزو السوفياتي في 1979 وأصبح مجاهدا ويُعتقد أنه قاتل إلى جانب الملا عمر. في 2001 بعد التدخل الأميركي وسقوط نظام طالبان، قيل إنه كان جزءا من مجموعة صغيرة من المتمردين المستعدين لاتفاق يعترفون فيه بإدارة كابول. لكن هذه المبادرة باءت بالفشل. كان الملا برادر القائد العسكري لطالبان عندما اعتقل في 2010 في مدينة كراتشي الباكستانية. وقد أطلق سراحه في 2018 تحت ضغط من واشنطن خصوصا. ويلقى برادر احتراما لدى مختلف فصائل طالبان ثم تم تعيينه رئيسا لمكتبهم السياسي في العاصمة القطرية الدوحة. من هناك، قاد المفاوضات مع الأميركيين التي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان ثم محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية التي لم تسفر عن شيء. سراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني سراج الدين حقاني هو نجل أحد أشهر قادة الجهاد ضد السوفيات جلال الدين حقاني. وهو الرجل الثاني في طالبان وزعيم الشبكة القوية التي تحمل اسم عائلته. تعتبر واشنطن شبكة حقاني التي أسسها والده إرهابية وواحدة من أخطر الفصائل التي تقاتل القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في العقدين الماضيين في أفغانستان. وشبكة حقاني معروفة باستخدامها العمليات الانتحارية، ويُنسب إليها عدد من أعنف الهجمات في أفغانستان في السنوات الأخيرة. وقد اتهم أيضا باغتيال بعض كبار المسؤولين الأفغان واحتجاز غربيين رهائن قبل الإفراج عنهم مقابل فدية أو مقابل سجناء مثل الجندي الأميركي بو برغدال الذي أطلق سراحه في 2014 مقابل خمسة معتقلين أفغان من سجن غوانتانامو. ومقاتلو حقاني المعروفون باستقلاليتهم ومهاراتهم القتالية وتجارتهم المربحة، هم المسؤولون على ما يبدو عن عمليات طالبان في المناطق الجبلية في شرق أفغانستان، ويعتقد أن تأثيرهم قوي على قرارات الحركة. الملا يعقوب، الوريث الملا يعقوب هو نجل الملا محمد عمر ورئيس اللجنة العسكرية التي تتمتع بنفوذ كبير في طالبان حيث تقرر التوجهات الاستراتيجية للحرب ضد الحكومة الأفغانية. ويشكل ارتباطه بوالده الذي كان مقاتلو الحركة يبجلونه كزعيم لحركتهم، عامل توحيد لحركة واسعة ومتنوعة إلى هذا الحد. مع ذلك، ما زال الدور الذي يلعبه داخل الحركة موضع تكهنات. ويعتقد بعض المحللين أن تعيينه رئيسا لهذه اللجنة في 2020 كان مجرد إجراء رمزي. مونت كارلو الدولية MCD
الحصاد: البيان أبدت وكالة علمية أمريكية قلقها إزاء ازدياد الظواهر الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي، وذلك بعد تصنيفها شهر يوليو على أنه الشهر الأكثر حراً المسجل على كوكب الأرض. وقال رئيس الوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي ريك سبينراد في بيان الجمعة "في حال كهذه، فإن المرتبة الأولى هي الأسوأ". وأوضح أن "شهر يوليو هو عموماً الشهر الأشد حراً في العام، لكن يوليو 2021 تجاوز ذلك ليصبح الشهر الأكثر حراً الذي يُسجل على الإطلاق". ويضاف "الرقم القياسي الجديد" وفق سبينراد، إلى "المسار المقلق والمزعج الذي بات يشهده الكون بسبب التبدل المناخي"، في وقت تجتاح حرائق وفيضانات وظواهر مناخية قصوى مناطق عدة في أنحاء العالم، من سيبيريا إلى الجزائر ومن تركيا إلى كاليفورنيا. وارتفعت الحرارة العامة لسطح الكوكب 0,01 درجة مئوية بالمقارنة مع يوليو السابق الأشد حراً والذي تم تسجيله عام 2016، علماً بأن الأخير تساوى بنظيريه في العامين 2019 و2020، وفق الوكالة. وكانت 0,93 درجة مئوية فوق متوسط درجة الحرارة في القرن العشرين. وأوضحت الوكالة أن تسجيل المعطيات بدأ قبل 142 عاماً. من جهتها، أوردت الخدمة الأوروبية للتبدل المناخي (كوبرنيكوس) الأسبوع الفائت أن الشهر الماضي كان يوليو الثالث الأشد حرا على الكوكب. ويعدّ بعض التباين بين معطيات الوكالات المناخية أمراً مألوفاً. وأوضح عالم المناخ في معهد "بريكثرو" زيكي هوسفاذر، المتخصص في سجلات درجات الحرارة، أنه لدى الوكالة الأمريكية "تغطية محدودة أكثر في القطب الشمالي" وهو ما قد يفسّر الاختلاف. وقال "بغضّ النظر عن المكانة التي يحتلها شهر يوليو في التصنيف، فإنّ الاحترار المسجل في العالم هذا الصيف هو نتيجة واضحة لتغير المناخ". أجيال المستقبل جاء الإعلان بعد أيام من نشر خبراء المناخ في الأمم المتحدة تقريراً جديداً، أكّد أن مسؤولية البشرية عن ظاهرة الاحتباس الحراري "لا لبس فيها"، وأن التغير المناخي يحدث بوتيرة أسرع مما يُخشى. وتوقع التقرير أن يصل الاحترار العالمي إلى 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية قرابة العام 2030، ما يهدد بحصول كوارث جديدة "غير مسبوقة" في الكوكب الذي تضربه موجات حرّ وفيضانات متتالية. وقال خبراء الأمم المتحدة إنّ البشر "ليس لديهم خيار سوى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير" إذا كانوا يريدون الحد من التداعيات. وفيما ارتفعت حرارة الكوكب 1,1 درجة مئوية حتى الوقت الحالي، يشاهد العالم العواقب المترتبة على ذلك، من الحرائق التي تجتاح الغرب الأمريكي واليونان وتركيا مرورا بالفيضانات التي غمرت بعض المناطق الألمانية والصينية وصولا إلى تسجيل درجات حرارة قياسية في كندا وصلت إلى 50 درجة مئوية. وأوصى اتفاق باريس الموقع عام 2015 بضرورة حصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، وصولا إلى درجة ونصف درجة مئوية إذا أمكن. وتتكثف الدعوات الى التحرّك سريعاً بينما تتوجّه الأنظار إلى مؤتمر غلاسكو، حيث سيجتمع في نوفمبر قادة العالم أجمع في قمة حول المناخ (كوب 26). وكتب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز على تويتر "شهدنا للتو الشهر الأكثر حراً على كوكبنا على الإطلاق". وأضاف "لا أريد للأجيال المقبلة أن تعود الى هذه اللحظة وتسأل لما لم نفعل كل ما بوسعنا للتصدي تغير المناخ".
الحصاد: تقرير: العربي الجديد أحكمت حركة "طالبان" سيطرتها على المناطق المحيطة بالعاصمة الأفغانية، اليوم السبت، حيث استولت على ولاية لوغار، بينما يفرّ اللاجئون من مناطق المعارك. ودفعت واشنطن بمشاة البحرية الأميركية (المارينز) للإشراف على عمليات الإجلاء السريعة. وقال النائب من ولاية لوغار، هوما أحمدي، وفق "أسوشييتد برس"، إن "طالبان" تسيطر على الولاية بأكملها، بما في ذلك عاصمتها، ووصلت إلى منطقة في مقاطعة كابول المجاورة اليوم السبت. ميدانياً أيضاً، شنّت "طالبان" هجوماً متعدد الجبهات في وقت مبكر من صباح اليوم السبت على مزار شريف، وهي مدينة رئيسية في شمال أفغانستان يدافع عنها أمراء حرب أقوياء سابقون. وقال المتحدث باسم حاكم ولاية بلخ في شمال البلاد، منير أحمد فرهاد، إن "طالبان" هاجمت المدينة من عدة اتجاهات، ما أدى إلى اندلاع قتال عنيف على مشارفها، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات. بدوره، قال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في تغريدة عبر "تويتر"، إن مسلحي الحركة شنوا هجوماً كبيراً من أربعة أطراف على مدينة مزار شريف، مركز ولاية بلخ، وتستمرّ معارك طاحنة بين قوات الأمن ومسلحي الحركة على عدة محاور. وادّعى مجاهد حصول تقدم كبير على الأرض، علاوة على تكبيد مسلحي الحركة خسائر كبيرة لقوات الأمن الأفغانية، مشيراً إلى أن تفاصيل العملية قادمة. إلى ذلك، أحرزت الحركة تقدماً كبيراً داخل مدينة خرنه مركز ولاية بكتيكا الجنوبية المحاذية للحدود الباكستانية. وتحدث مجاهد، في تغريدة عبر "تويتر"، عن تقدّم مسلّحي الحركة داخل المدينة، مشيراً إلى أن مسلحي الحركة تمكنوا من كسر الخطوط الأمامية للقوات الأفغانية والسيطرة على مواقع أمنية عدة داخلها، وهم يتقدمون صوب مقر حاكم الإقليم. ولم تقدم الحكومة الأفغانية أي تعليق لحدّ الآن على إعلان "طالبان". من جانبها، أعلنت الداخلية الأفغانية، في بيان، مقتل أكثر من 30 عنصراً من الحركة، بينهم قائد ميداني فيها، إثر قصف جوي لسلاح الجو الأفغاني في أطراف مدينة مزار شريف، مشيرة إلى أن استهداف مسلحي الحركة متواصل في مختلف مناطق البلاد. ومع سقوط ثاني وثالث أكبر مدن البلاد بأيدي "طالبان"، أصبحت كابول فعلياً محاصرة، وآخر موقع للقوات الحكومية التي لم تبدِ سوى مقاومة محدودة في بعض الأماكن ومعدومة في مناطق أخرى. ويتمركز مقاتلو طالبان الآن على بعد خمسين كيلومتراً فقط عن كابول، ما جعل الولايات المتحدة ودولاً أخرى تهرع لإجلاء رعاياها جواً قبل هجوم يثير مخاوف كبيرة. وتلقى موظفو السفارة الأميركية أوامر بإتلاف أو إحراق المواد الحساسة، مع بدء إعادة انتشار ثلاثة آلاف جندي أميركي لتأمين مطار كابول والإشراف على عمليات الإجلاء. وأعلنت دول أوروبية عدة، بينها بريطانيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا، سحب أفراد من سفاراتها الجمعة. وشكل حجم تقدم "طالبان" وسرعته صدمة للأفغان والتحالف بقيادة الولايات المتحدة، الذي ضخ مليارات في البلاد بعد إطاحة الحركة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول قبل نحو عشرين عاماً. وقبل أيام من انتهاء الانسحاب الأميركي الذي أمر به الرئيس جو بايدن، استسلم الجنود ووحدات وحتى فرق بأكملها، وسلموا المتمردين المزيد من المركبات والمعدات العسكرية لتغذية تقدمهم الخاطف. ويشعر سكان كابول وعشرات الآلاف من الذين لجأوا إلى العاصمة في الأسابيع الأخيرة، بالارتباك والخوف مما ينتظرهم. وقال خير الدين لوغاري، أحد سكان العاصمة لوكالة "فرانس برس": "لا نعرف ما الذي يجري". من جهته، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بأنه يشعر "بقلق عميق" إزاء روايات عن سوء معاملة النساء في مناطق استولت عليها حركة "طالبان"، التي فرضت شكلاً متشدداً من الإسلام على أفغانستان خلال فترة حكمها من 1996 إلى 2001. وقال غوتيريس: "إنّ من المروع والمحزن أن نرى تقارير تشير إلى أن حقوق الفتيات والنساء الأفغانيات التي حُصِل عليها بشق الأنفس تسقط". تقارير دولية السفارة الأميركية تتلف الوثائق الحساسة مع اقتراب "طالبان" من كابول وتسارعت وتيرة هجوم "طالبان" في الأيام الأخيرة، مع استيلاء مقاتلي الحركة على هرات في الغرب، ثم بعد ساعات فقط على قندهار معقل "طالبان" في الجنوب. وقال عبد النافع من سكان قندهار لـ"فرانس برس" إن المدينة هادئة بعدما تخلت عنها القوات الحكومية التي لجأت إلى منشآت عسكرية خارجها، حيث كانت تتفاوض على شروط الاستسلام. وأضاف: "خرجت هذا الصباح ورأيت أعلام "طالبان" البيضاء في معظم ساحات المدينة"، موضحاً: "اعتقدت أنه قد يكون أول أيام العيد". وعلى الرغم من جهود محمومة لإجلاء الرعايا، تصرّ إدارة بايدن على أن سيطرة "طالبان" على البلاد بأكملها ليست حتمية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي الجمعة إن "كابول ليست حالياً في بيئة تهديد وشيك"، لكنه أقرّ بأن مقاتلي طالبان "يحاولون عزل" المدينة. وحلّقت مروحيات ذهاباً وإياباً بين مطار كابول والمجمع الدبلوماسي الأميركي الواسع في المنطقة الخضراء التي تخضع لإجراءات حماية مشددة، بعد 46 عاماً على إجلاء مروحيات الأميركيين من سايغون في نهاية حرب فيتنام. وتشمل عملية الإجلاء التي تقودها الولايات المتحدة آلاف الأشخاص، بينهم موظفون في السفارة، وأفغان مع عائلاتهم يخشون مواجهة أعمال انتقامية بعدما عملوا مترجمين فوريين أو في وظائف أخرى لحساب الأميركيين. وقال المتحدث باسم البنتاغون إنّ الجزء الأكبر من القوات التي ترعى عملية الإجلاء ستكون جاهزة بحلول الأحد، و"ستكون قادرة على نقل آلاف الأشخاص يومياً" من أفغانستان، مؤكداً أنه "لن تكون هناك مشكلة في القدرة" على إجلاء الرعايا. وتشيد حسابات مؤيدة لـ"طالبان" على وسائل التواصل الاجتماعي بغنائم الحرب الهائلة التي استولى عليها المتمردون، ونشرت صوراً لآليات مدرعة وأسلحة ثقيلة وحتى طائرة دون طيار استولى عليها مقاتلو الحركة في قواعد عسكرية مهجورة.
الحصاد: BBC بموجب اتفاق مع طالبان، وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو على سحب جميع القوات، مقابل التزام الحركة بعدم السماح للقاعدة أو أي جماعة متطرفة أخرى بالعمل في المناطق التي يسيطرون عليها. وحدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن موعدا نهائيا في 11 سبتمبر/أيلول، الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، لكن التقارير تشير إلى أن الانسحاب قد يكتمل في غضون أيام. وقالت حركة طالبان لبي بي سي إن أي قوات أجنبية تبقى في أفغانستان، بعد الموعد النهائي لانسحاب الناتو في سبتمبر/أيلول، ستكون معرضة للخطر بصفتها "محتلة". ويتزايد القلق بشأن مستقبل كابول في الوقت الذي تستعد القوات الأفغانية لتولي مسؤولية الأمن في البلاد منفردة. وكانت حركة طالبان الإسلامية المسلحة قد أثبتت أنها قوة قتالية هائلة في أفغانستان وتهديد خطير لحكومتها. تخطى مواضيع قد تهمك وواصل القراءة مواضيع قد تهمك طالبان: فرار نحو ألف جندي أفغاني إلى طاجيكستان مع سيطرة الحركة على مناطق في شمال أفغانستان الحرب في أفغانستان: كيف يمكن للغرب أن يحارب الإرهاب بعد رحيل القوات الغربية؟ حركة طالبان: مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان تعرب عن قلقها من مكاسب الحركة جو بايدن يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب في أفغانستان مواضيع قد تهمك نهاية كما هددت طالبان بزعزعة استقرار باكستان، حيث تسيطر على مساحات في شمال غربي البلاد، واتهمت بالمسؤولية عن تنفيذ موجة من التفجيرات الانتحارية وهجمات أخرى. فما الذي نعرفه عن حركة طالبان؟ ظهرت حركة طالبان في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، شمالي باكستان، عقب انسحاب قوات الاتحاد السوفيتي السابق من أفغانستان. وبرز نجم طالبان، وأكثر عناصرها من الباشتون، في أفغانستان في خريف عام 1994. ويعتقد على نطاق واسع بأن طالبان بدأت في الظهور لأول مرة من خلال المعاهد الدينية، التي تمول في الغالب من السعودية، والتي تتبنى نهجا دينيا محافظا. صدر الصورة،AFP/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، طالبان شنت سلسلة من الهجمات على كابول في السنوات الأخيرة ووعدت طالبان، التي توجد في مناطق الباشتون المنتشرة في باكستان وأفغانستان، بإحلال السلام والأمن وتطبيق صارم للشريعة بمجرد وصولها للسلطة. وفي كلا البلدين، طبقت طالبان عقوبات وفقا للشريعة مثل الإعدامات العلنية للمدانين بجرائم القتل أو مرتكبي الزنا أو بتر أيدي من تثبت إدانتهم بالسرقة. وأمرت الحركة الرجال بإطلاق لحاهم والنساء بارتداء النقاب. وحظرت طالبان مشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الموسيقى وارتياد دور السينما، ورفضت ذهاب الفتيات من سن العاشرة إلى المدارس. ونفت باكستان مرارا أنها هي من أسست طالبان، لكن لا يوجد شك كبير في أن العديد من الأفغان، الذين انضموا في بادئ الأمر إلى صفوف الحركة، تلقوا تعليما في المعاهد الدينية في باكستان. وكانت باكستان أيضا واحدة من ثلاث دول فقط، بالإضافة إلى السعودية والإمارات، اعترفت بطالبان حينما وصلت للسلطة في أفغانستان في منتصف التسعينيات وحتى عام 2001. وكانت باكستان آخر دولة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان. صدر الصورة،AFP/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013 أفادت تقارير بمقتل زعيم حركة طالبان في باكستان حكيم الله محسود في غارة جوية قيادات تولى زعامتها الملا عمر، رجل الدين الذي فقد إحدى عينيه خلال قتال القوات السوفيتية في ثمانينيات القرن الماضي، وفي أغسطس /آب 2015 اعترفت طالبان أنها أخفت لمدة عامين خبر وفاة الملا عمر. وفي سبتمبر/أيلول عام 2015 أعلنت طالبان أنها توحدت تحت قيادة الملا منصور الذي كان نائبا للملا عمر لفترة طويلة. ولقي الملا منصور حتفه في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في مايو/آيار عام 2016 ليحل نائبه المولوي هيبة الله أخنوزاده، وهو رجل دين متشدد، محله. وقتل على الأقل ثلاثة من أبرز قادة طالبان باكستان في غارات شنتها طائرات أمريكية بدون طيار، من بينهم الملا نظير وولي الرحمن. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013، أفادت تقارير بمقتل زعيم حركة طالبان في باكستان، حكيم الله محسود، في غارة جوية أيضا. ووقع الهجوم الذي يمكن أن يقال إنه أثار أكبر قدر من الانتقادات الدولية لحركة طالبان في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2012، حينما هاجمت الحركة منزل الطالبة ملالا يوسف زاي في بلدة منغورا. صدر الصورة،REUTERS التعليق على الصورة، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2012 هاجمت الحركة منزل الطالبة ملالا يوسف زاي في بلدة منغورا ملاذ القاعدة دخلت حركة طالبان في أفغانستان بؤرة اهتمام العالم عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 على مركز التجارة العالمي بالولايات المتحدة. واتهمت الحركة بتوفير ملاذ آمن في أفغانستان لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن وأعضاء التنظيم الذين اتهموا بالمسؤولية عن هذه الهجمات. وبعد فترة قصيرة من هجمات سبتمبر، أطاح غزو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحكم طالبان في أفغانستان، لكن لم يتم اعتقال زعيم الحركة الملا محمد عمر. صدر الصورة،EPA التعليق على الصورة، الملا عمر أول زعماء طالبان وبزغت طالبان من جديد خلال السنوات القليلة الماضية في أفغانستان ونمت حتى أصبحت أكبر قوة في باكستان، ويقول مراقبون إنه لا يوجد تنسيق محكم بين الفصائل والجماعات المتشددة التابعة لطالبان. وكان حكيم الله محسود قائدا لفرع طالبان الرئيسي في باكستان، وأنحي باللائمة على حركته التي تعرف باسم حركة طالبان الباكستانية، في ما يتعلق بتنفيذ عشرات الهجمات الانتحارية والهجمات الأخرى. وكان الأفغان، الذين شعروا بالقلق من زيادة أعداد المجاهدين على نحو مفرط والاقتتال الداخلي في أعقاب طرد السوفييت، قد رحبوا عموما بطالبان عندما ظهرت على الساحة للمرة الأولى. ونمت شعبيتهم الأولى بدرجة كبيرة نتيجة ما حققوه من نجاح في القضاء على الفساد، والحد من الانفلات الأمني، وجعل الطرق والمناطق الخاضعة لسيطرتهم آمنة لازدهار التجارة. هجوم أمريكي وسرعان ما امتد نفوذ طالبان من جنوب غربي أفغانستان، واستولت على إقليم هرات الذي يحد إيران في سبتمبر/ أيلول عام 1995. وبعد عام بالتحديد، استولوا على العاصمة الأفغانية كابول بعد الإطاحة بنظام حكم الرئيس برهان الدين رباني ووزير دفاعه أحمد شاه مسعود. وبحلول عام 1998، كانوا قد سيطروا على نحو 90 في المئة من أفغانستان. صدر الصورة،AFP التعليق على الصورة، حكومة الملا عمر سقطت عام 2001 ووجهت إليهم تهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والثقافة، وكان أبرز مثال على ذلك في عام 2001 عندما دمرت طالبان تمثالي بوذا في باميان بوسط أفغانستان على الرغم من موجة غضب دولية ضد ذلك. وفي السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2001، غزت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان. وبحلول الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول انهار نظام طالبان. ولاذ الملا عمر ومساعدوه بالفرار. ويعتقد بوجه عام أنهم لجأوا إلى مدينة كويتا الباكستانية التي كانوا يوجهون منها حركة طالبان. لكن إسلام أباد نفت وجود ما يعرف باسم "شورى كويتا". عودة طالبان وعلى الرغم من وجود أكبر عدد على الإطلاق من القوات الأجنبية في تاريخ البلد، استطاعت طالبان توسيع نطاق نفوذها على نحو مطرد، مما جعل مساحات شاسعة من أفغانستان غير آمنة وعاد العنف في البلاد إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2001. وأدى تراجعهم خلال السنوات العشر الماضية إلى الحد من خسائرهم البشرية والمادية والعودة بروح الثأر. وكان هناك العديد من الهجمات التي شنتها طالبان على كابول خلال الأعوام الأخيرة، كما نفذت في سبتمبر/ أيلول عام 2012، غارة كبيرة على قاعدة كامب باستيون التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو". وفي الشهر نفسه سلم الجيش الأمريكي السلطات الأفغانية الإشراف على سجن باغرام المثير للجدل الذي يضم ما يزيد على 3 آلاف مقاتل من طالبان وإرهابيين مشتبه بهم. صدر الصورة،REUTERS التعليق على الصورة، هناك أكثر من 9 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان وخلال السنوات القليلة الماضية، زاد اعتماد طالبان كذلك على تفجير عبوات ناسفة على جوانب الطرق كسبيل لمحاربة الناتو والقوات الأفغانية. ومن الصعب تحديد عدد من قتلوا في تلك الهجمات على وجه الدقة، لكن وزارة الداخلية الأفغانية تقول إن طالبان مسؤولة عن قتل ما يزيد على 1800 فرد من قوات الشرطة الوطنية الأفغانية عام 2012. كما قتل نحو 800 فرد من جنود الجيش الوطني الأفغاني في تفجير قنابل على جوانب الطرق خلال الفترة نفسها، وفقا للتقديرات. وفي سبتمبر/ أيلول عام 2015 سيطرت طالبان على مدينة قندوز الاستراتيجية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها سيطرتها على عاصمة إقليمية في البلاد منذ هزيمتها عام 2001. ويوجد نحو 9 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان، ولكن ليست هذه القوة هي مصدر التهديد الوحيد لطالبان التي تواجه أيضا صعود جماعة تنظيم الدولة المتشددة في أفغانستان. وبعد مرور نحو 19 عاما على الإطاحة بحكمها وصرف مبالغ خيالية للقضاء عليها إلا أن الحركة صمدت وباتت تسيطر عمليا على نحو 40 في المئة من مساحة البلاد.
الحصاد: معهد واشنطن - عُلا الرفاعي, هارون ي. زيلين يستند اندفاع عدد من الدول العربية في الآونة الأخيرة إلى تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد إلى فرضية خاطئة مفادها أن الحرب قد انتهت، وأنه من الضروري إعادة العلاقات مع دمشق للضغط عليها لتغيير علاقتها مع إيران. على الإدارة الأمريكية أن تشرح لحلفائها في المنطقة أن إعادة تمكين عميلٍ إيراني هي حتماً ليست سبيلاً مقبولاً لاحتواء طموحات طهران الإقليمية، مهما كانت صعوبة المسار لتنفيذ انتقال ديمقراطي في سوريا والسعي لتحقيق العدالة ضد مجرمي الحرب. يستند اندفاع عدد من الدول العربية في الآونة الأخيرة إلى تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد إلى فرضية خاطئة مفادها أن الحرب قد انتهت، وأنه من الضروري إعادة العلاقات مع دمشق للضغط عليها لتغيير علاقتها مع إيران. وفي هذا الصدد، هناك دور للديناميكيات الأخرى في المنطقة: على سبيل المثال، ترى الإمارات في هذا التطبيع ثقلاً موازناً ضرورياً تجاه ما تعتبر أنها أعمال معادية من قبل تركيا مع «هيئة تحرير الشام» - الجماعة الجهادية السورية في إدلب. إلّا أن هذه الأسباب المنطقية لإعادة تأهيل نظام الأسد خاطئة تماماً. فالسلبيات وعواقب السياسة لن تؤثر على الدول العربية فحسب، بل ستضر بالمصالح الأمريكية أيضاً، مما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة التركيز بشكل كامل على معالجة التهديد المتزايد من الصين. لن تُغير سلوك النظام لا يخفى أن روسيا وإيران، باعتبارهما أقرب حلفاء نظام الأسد، دعمتا حافظ وبشار الأسد خلال فترات مختلفة من عزلة النظام السوري. ففيما يتعلق ببشار، أيدتا محاولته البقاء في السلطة إزاء الحشد الجماهيري ضد حكمه. ويدين بشار ببقائه في الحكم لروسيا وإيران وشبكة الوكلاء التابعة لهذه الأخيرة. وحتى لو قامت الدول العربية بتطبيع العلاقات، فالأسئلة التي تطرح نفسها هنا، لماذا يثق الأسد بأي من هذه الدول، بالنظر إلى أن العديد منها في منطقة الخليج عارضته بشدة خلال الحرب؟ وكيف سيؤدي التعامل مع الأسد إلى إخراج إيران من سوريا بينما تساعد طهران في السيطرة على العديد من المحاور [التي تتحكم] بالدولة والأراضي في أجزاء مختلفة من البلاد؟ كما لن يؤثر التطبيع على الديناميكيات في إدلب مع «هيئة تحرير الشام» لأن تركيا هي الجهة الفاعلة الرئيسية هناك. ولن يؤدي التطبيع إلّا إلى إضفاء شرعية زائفة على نظام الأسد وانتصاراً دعائياً له لكي يحافظ على الوضع الراهن. وكما يتضح من 50 عاماً من الأدلة، فإن هذا النظام لا يغيّر سلوكه بناءً على الدبلوماسية الخارجية. وحتى في أضعف جوانب نظامه خلال الحرب الأهلية، بقي الأسد مخلصاً لسبب وجوده: البقاء في السلطة بأي ثمن. تُقوّض القواعد الدولية سيؤدي التعامل مع نظام الأسد إلى مزيد من تآكل المعايير الدولية. وكانت صفقة الخط الأحمر للأسلحة الكيميائية في عام 2013 فاشلة حيث شنّ النظام بعد ذلك مئات الهجمات الأخرى. وحتى في حالات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الآونة الأخيرة في صربيا ورواندا ودارفور، كانت هناك بعض مظاهر السعي لتحقيق المساءلة والعدالة، مهما كانت العملية معيبة. إن أي شكل من أشكال التطبيع سيقوّض إمكانية تقديم النظام إلى العدالة بسبب الإبادة الجماعية المستمرة. وسوف يصبح الأسد أكثر جرأة من خلال استمراره في استخدام الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة وجميع الوسائل الممكنة ضد المدنيين السوريين لقمع الدعوات المحلية للحرية والديمقراطية. وستكون الدول العربية أيضاً متواطئة في الانتهاكات المستقبلية المحتملة في سوريا لأن دعمها المالي سيؤجج بالتأكيد فظائع أخرى. وبدورها، يمكن لاستراتيجية تقويض المعايير الدولية أن تبرر الانتهاكات المحلية من قبل هذه الدول العربية بسبب إفلات الأسد منها ببساطة من خلال أفعاله. تؤثر سلباً على الحملة المناهضة لتنظيم «الدولة الإسلامية» إذا أضفت دول عربية الصبغة الشرعية على الأسد، سيبدأ نظامه بحملة ضغط لإخراج الولايات المتحدة من سوريا. وسوف يستغل حلفاؤه، جنباً إلى جنب مع الجماهير في الولايات المتحدة المعارضة لما يسمى بـ "الحروب الأبدية"، هذا "النصر" المزعوم لنظامٍ لا يسيطر على جميع الأراضي السورية، ناهيك عن السيادة على معظم حدوده. وتم أساساً استخدام قواعد اللعبة هذه في العراق، ولكن على عكس العراق، لا تتمتع واشنطن بنفس العلاقة والديناميكية مع دمشق. ووفقاً لقواعد اللعبة هذه، من المرجح أن تبدأ إيران وشبكتها العميلة في شرق سوريا بإطلاق الصواريخ باتجاه القواعد الأمريكية وإثارة عدم الاستقرار في المناطق التي تنشط فيها «قوات سوريا الديمقراطية» على الجانب الآخر من نهر الفرات. وبدون مساعدة واشنطن، لن تواجه «قوات سوريا الديمقراطية» سيلاً من الميليشيات الشيعية في الشرق فحسب، بل المزيد من القوات المدعومة من تركيا من الشمال أيضاً. ومن المرجح أن يشجع كلا السيناريوهين التجنيد الذي يقوم به تنظيم «الدولة الإسلامية» نتيجة البيئة المتساهلة المتمثلة بـ احتلال إيران لدير الزور أو احتفاظ القوات المدعومة من تركيا بوجود ضعيف. فبعد انسحاب الولايات المتحدة من العراق في عام 2010، حدث انهيار أمني في المناطق التي نشط فيها تنظيم «الدولة الإسلامية» في البلاد (2012-2014)، مما يوضح الطبيعة قصيرة النظر لتلك الخطوة. وفي النهاية، أرغمت [تلك التطورات] واشنطن على نشر قواتها مجدداً ضد عدو أقوى بكثير من الخصم الذي تركته قبل ذلك بسنوات قليلة فقط. تُشجع حلفاء النظام في المنطقة ترى روسيا وإيران أن سوريا هي مسرح اختبار للقوة في المنطقة. وقد استخدمت روسيا سوريا لتوسيع علاقاتها مع دول الخليج ومصر وليبيا. وفي حين تتقلب مواقف الولايات المتحدة وفقاً [لسياسة] الإدارة الحاكمة أو الديناميكيات المحلية، إلّا أن روسيا تقف وراء حلفائها. وقد عملت إيران أيضاً على تعزيز استراتيجية شبكة وكلائها في المنطقة من خلال تقوية «حزب الله» اللبناني عبر مهارات جديدة اكتسبها على المسرح السوري، وتشديد قبضتها على لبنان وتوسيع وجودها في العراق واليمن - الأمر الذي يقوض الأمن في تلك الدول. وبما أن إيران هي دولة ثورية، فإن منح الأسد هدية التطبيع لن يؤدي إلّا إلى دفع طهران إلى الاعتقاد بأنها تسيطر على السياسة الإقليمية، مما يضع حلفاء أمريكا في مختلف الدول العربية، وخاصة في منطقة الخليج، في موقف دفاعي مع فرصة ضئيلة للخروج منه. وفي الواقع، صرح بشار الأسد بشكل مباشر وعلني أن المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، هو "زعيم العالم العربي". ومن المعقول أيضاً أنه مع تخفيف الضغط عن سوريا وإمكانية تخفيف العقوبات من العودة الأمريكية إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة»، يمكن لإيران أن تواصل المزيد من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في البحرين والسعودية من خلال ميليشياتها الشيعية وحلفائها هناك. ويبدو أن إيران انتصرت في حرب الـ 42 عاماً مع السعودية لأنها حالياً أقوى جهة فاعلة في المنطقة وتطوّق أعدائها المختلفين. وفي المرحلة القادمة، قد يؤدي ذلك إلى تمكين روسيا وإيران من إملاء الأجندة الإقليمية مع ترك الولايات المتحدة مع القليل من النفوذ لمتابعة ديناميكيات تناسب مصالحها أو مصالح حلفائها العرب بشكل أفضل. إسرائيل في دائرة الضوء تُشكل [المواجهات التي اندلعت] في الشهر الماضي بين إسرائيل والفلسطينيين [في غزة] تلخيصاً مثالياً لما سيحدث عندما تنفصل الولايات المتحدة عن المنطقة. وحتى إذا أرادت واشنطن التركيز على الصين بطريقة أكثر قوة، إلّا أن الصراعات في الشرق الأوسط ستستمر في جذب الولايات المتحدة سواء شاءت أم أبت. ولا تزال إسرائيل من أقرب حلفاء واشنطن وتتلقى مساعدات بمليارات الدولارات سنوياً. وعندما تنفجر هناك أعمال عنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فستعمل الدوائر المحلية والحلفاء في المنطقة على حث أي إدارة أمريكية في السلطة على اتخاذ إجراء ما. بالإضافة إلى ذلك، من خلال التطبيع مع نظام الأسد، من المرجح أن تتلاشى القضية التي هي على كل شفة ولسان حول سوريا في العالم العربي، مما يعني أنه ستكون هناك مساحة أكبر للنشاط حول فلسطين والتركيز عليه. لذلك، من المرجح أن تتعامل الدول التي وقّعت مؤخراً على "اتفاقيات إبراهيم" مع ضغوط داخلية أكبر بسبب استمرار صدى القضية الفلسطينية، كما رأينا سابقاً مع السلام البارد مع مصر والأردن. وبشكل غير مباشر، قد يؤدي التطبيع مع نظام الأسد إلى قيام حشد أكبر ضد الأنظمة العربية المحلية حيث سيُنظر إليها على أنها متواطئة مع ما تُعتبر جرائم إسرائيلية ضد الفلسطينيين. وسيؤدي ذلك إلى وضع إيران في مكانة تُمكِّنها من استغلال [التطورات] بسبب تحالفها مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي في فلسطين» و «حزب الله» ونظام الأسد، مما يوفر لها فرصاً أكبر لفتح جبهة ضد إسرائيل ودفع أجندتها الإقليمية المهيمنة باستخدامها الدعم للقضية الفلسطينية كحصان طروادة، في الوقت الذي تقوّض فيه شرعية الدول العربية. التداعيات منذ اندلاع الاضطرابات الثورية في سوريا عام 2011، ارتكبت الولايات المتحدة عدداً من الهفوات. وفي حين كان بعضها ناتجاً عن مخاوف وحسابات مشروعة، إلّا أن السماح بإعادة إضفاء الشرعية على نظام الأسد سيشكل خطأً استراتيجياً فادحاً لا يمكن تفسيره، وخطأ من شأنه أن يقوّض الوعد المتكرر لإدارة بايدن بوضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية. وعلى هذا النحو، يجب على الإدارة الأمريكية أن تولي اهتماماً وثيقاً باندفاع حلفائها لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وأن تعمل جاهدة على ثنيهم عن اتباع هذا المسار الخطير وغير الحكيم وقصير النظر. على الإدارة الأمريكية أن تشرح لهم أن إعادة تمكين عميلٍ إيراني هي حتماً ليست سبيلاً مقبولاً لاحتواء طموحات طهران الإقليمية، مهما كانت صعوبة المسار لتنفيذ انتقال ديمقراطي في سوريا والسعي لتحقيق العدالة ضد مجرمي الحرب. ولربما فات الأوان، لكن يجدر بواشنطن أن تدافع عن موقفها في سوريا وتستعيد مصداقيتها مع الشعب السوري، أو ستواجه عواقب أكبر من تلك التي سبق وأحدثها صراعٌ أثبت مراراً وتكراراً أن ما يحدث في سوريا لا يبقى في سوريا.
الحصاد استطاع يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الإسرائيلي، من كسب مصداقية متزايدة منذ بداياته في السياسة، ليصبح الخصم الرئيسي لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو. وبعد أن اختار الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، النجم التلفزيوني السابق، الوسطي، يائير لابيد، الأربعاء الماضي، لتشكيل الحكومة المقبلة، ازدادت حدة المنافسة بينه ونتنياهو، فمن هو يائير لابيد؟ حياته الشخصية: ولد يائير لابيد في نوفمبر 1963 في تل أبيب، حيث يتركز الدعم له، وكان والده، تومي لابيد، صحافيا ووزيرا للعدل. أما والدته شولاميت، فهي كاتبة روايات بوليسية شهيرة في إسرائيل، أصدرت سلسلة تحقيقات بطلتها صحافية. حياته العملية: تجدر الإشارة إلى أن يائير لابيد بدأ العمل في صحيفة "معاريف"، وبعدها في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأوسع انتشارا بين الصحف الإسرائيلية، ما سمح له أن يصبح اسمه معروفا في إسرائيل، في حين أنه واصل نشاطات متفرقة مع عمله، فكان يمارس الملاكمة كهاو، ويتدرب على الفنون القتالية، كما كتب روايات بوليسية ومسلسلات تلفزيونية، وألف وأدى أغنيات، ولعب حتى أدوارا في أفلام. وفي سياق متصل، يذكر أن برنامج لابيد التلفزيوني الحواري حقق في سنوات الألفين أكبر جمهور، ما سمح لمقدم البرنامج، بفرض نفسه نموذجا للإسرائيلي العادي. واستطاع لابيد، الذي يقدم نفسه على أنه وطني وليبرالي وعلماني، من رص صفوف الوسط، فيما يلقى تنديدا في أوساط اليهود المتشددين. دخوله عالم السياسة: اعتزل الصحفي السابق العمل في التلفزيون عام 2012، لتأسيس حزبه "يش عتيد" (هناك مستقبل). وهذا الأمر دفع منتقديه إلى اتهامه باستغلال شعبيته كمقدم برامج ناجح، لكسب تأييد الطبقة الوسطى. وخاض لابيد الانتخابات التشريعية السابقة في مارس 2020 ضمن الائتلاف الوسطي "أزرق أبيض" بزعامة الجنرال، بيني غانتس (وزير الدفاع الحالي)، غير أنه انسحب منه بعد إبرام غانتس اتفاقا مع حكومة نتانياهو، ما أدى إلى تراجع التأييد لغانتس فيما أصبح لابيد زعيم المعارضة. وكان لابيد قد قال لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق منذ أشهر: "قلت لبيني غانتس..سبق وعملت مع نتنياهو..هو لن يدعك تمسك بالمقود"، إذ أن لابيد يعرف ذلك من خلال توليه وزارة المالية في إحدى حكومات نتنياهو بين 2013 و2014. وأضاف لابيد لـ"فرانس برس": "قال لي غانتس إننا نثق به، لقد تغير..فأجبته بأن الرجل عمره 71 عاما ولن يتغير، وللأسف من أجل البلاد، كنت أنا على حق". التطورات الأخيرة حول الحكومة الإسرائيلية: ومع انخراطه في عالم السياسة، وبعد نحو 10 سنوات، يواصل يائير لابيد مسيرته السياسية، خصوصا بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رييفلين، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أخفق نتنياهو في المهمة، حيث أن حزب لابيد الوسطي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية في 23 مارس، حاصدا 17 مقعدا نيابيا. من جانيه، يهدف لابيد وبشكل علني إلى طرد رئيس الوزراء نتنياهو، الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل، من منصبه بعدما وجهت إليه التهمة في قضية فساد، إذ تلقى لابيد، أمس الأحد، دعم رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي اليميني، نفتالي بينيت، حيث أعلن الأخير انضمامه إلى معسكر رئيس حزب "يش عتيد". وقال بينيت: "أعلن أنني سأقوم بكل ما هو ممكن لتأليف حكومة وحدة مع صديقي يائير لابيد"، وذلك بعد تكهنات استمرت أسابيع حول حقيقة موقفه من الانضمام إلى زعيم المعارضة أو عدمه، بهدف وضع حد لحكم نتنياهو. المصدر: "فرانس برس"
الحصاد: مونت كارلو: جالساً خلف مكتبه، يحيي سادات بكر، الزعيم المافيوي التركي الفار، متابعيه على قناته في يوتيوب حيث يبث مقاطع يتابعها الملايين وينشر ما يقول إنها "فضائح" تطال حاشية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. من تهريب المخدرات والاغتيالات السياسية والاغتصاب إلى اتهامات بالفساد على أعلى مستوى في البلاد، يقول بكر كل شيء دون أي مونتاج أو ضبط على القناة التي أنشأها لهذه المناسبة والتي يعكس نجاحها الكبير تراجع شعبية إردوغان. علقت صحيفة "جمهوريت" اليومية على مدى انتشار مقاطع الفيديو، والذي سجل أحدها 15 مليون مشاهدة، بالقول "مرة أخرى، فإن انحطاط الدولة والمخاوف التي تنشأ عن ذلك هي على جدول الأعمال" الطارئة، مما يسلط الضوء على علاقة تحالف "غريبة" تظهر إلى العلن شيئاً فشيئاً بين حزب إردوغان الإسلامي القومي الحاكم وعصابات الجريمة المنظمة. ومن بين الأهداف الرئيسية للمافيا التركية يبرز وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو الذي أقسم بابكر على "تدميره" لأنه خانه بعد أن قام بحمايته لبعض الوقت. بكر الذي فر أولاً إلى الجبل الأسود ثم الإمارات يهاجم أيضاً بلا هوادة بيرات البيرق، صهر أردوغان، ونجل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، إركام، المتهم بالتورط في قضية تهريب الكوكايين الكولومبية. وزير العدل والداخلية السابق محمد أغار لم يسلم من اتهامات بكر الذي يقول إنه متورط في مقتل صحفي قبرصي في عام 1990 وفي مقتل صحفي استقصائي تركي شهير عام 1993. يضيف بكر "لم ينته الأمر، سنتحدث عن الأمر مرة أخرى"، كما يعد في كل حلقة يبثها على يوتيوب. رجل العصابات السابق ذو الشعر الرمادي البالغ من العمر 49 عاماً يملك موهبة الاستعراض، حيث يبث فيديوهاته من مكتبه ذي الجدران الخالية من أي لوحات والإضاءة الطبيعية وتبدو وكأنها غرفة فندق. وكانت تركيا قد أصدرت مذكرة توقيف جديدة بحق بكر الذي يتهم الآن بالضلوع في مجموعة إرهابية يترأسها فتح الله غولن. وبدأ بكر بتسجيل الفيديوهات بعد أن دهمت الشرطة منزله في تركيا في نيسان/أبريل الماضي، وأساءت معاملة أسرته كما قال. وبعد أن لزم الصمت لوقت طويل، اضطر إردوغان للخروج والدفاع عن أعوانه دون أن يذكر اسم بكر. وقال "خلال 19 عاماً سحقنا المنظمات الإجرامية الواحدة تلو الأخرى"، مؤكداً وقوفه "إلى جانب" وزير الداخلية. وأضاف "نلاحق افراد العصابات الإجرامية في أي مكان يفرون إليه في العالم". يقول الصحفي التركي المخضرم مراد يتكين أن بكر "ليس معارضاً تم دفعه إلى المنفى لأسباب سياسية، وهو ليس روبن هود الذي يأخذ من الأغنياء ليعطي للفقراء، كما أنه ليس بطلاً للناس كلف نفسه بالمهمة النبيلة لتنظيف البلاد، بل عضو في العالم السفلي". اشتهر بكر بميوله اليمينية المتطرفة وتخصص على مدى عقود في الابتزاز وتهريب المخدرات كما أظهر منذ فترة طويلة دعماً مذهلاً لرجب طيب أردوغان. نظم لقاءات سياسية في مسقط رأسه لدعم إردوغان وشجعه على ملاحقة منتقديه. وعندما خاض الرئيس التركي حرباً في عام 2016 ضد الأكاديميين الأتراك الذين وقعوا "عريضة من أجل السلام" تطالب بإنهاء العمليات العسكرية التركية في كردستان، علّق بكر حينها بالقول إنه "سيستحم بدمائهم". لكن في عالم المافيا، المليء بتصفية الحسابات والتحالفات ذات الهندسة المتغيرة، سرعان ما يصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم. وتنافس بكر مع اسم مشهور آخر في عوالم اللصوصية التركية هو علاء الدين كاكيتشي الذي سُجن بسبب سلسلة من جرائم القتل بما في ذلك قتل زوجته وأفرج عنه في نيسان/أبريل 2020. ويتمتع كاكيتشي بحماية زعيم حزب الحركة القومية التركي المتطرف الذي أصبح حليفاً لا غنى عنه لسلطة أردوغان. في مواجهة "فضائح" بكر المتفجرة، كررت صحيفة "صباح" اليومية الموالية للحكومة بأن الأمر مؤامرة غربية ضد أنقرة وبأن إدارة بايدن تحاول زعزعة النظام لأن تركيا تشكل عقبة كبيرة أمامها. قدم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو شكوى ضد بكر بتهمة الإهانة والتشهير وتعهد أردوغان بمحاكمته وبمحاربة الجريمة المنظمة رغم مقاطع الفيديو خالية من الأدلة المباشرة. ويمتنع بكر حتى اللحظة عن استهداف أردوغان بشكل مباشر وشخصي والذي يواصل تسميته بـ"الأخ طيب"، ويركز اتهاماته على دائرة الرئيس المقربة.
الحصاد: معهد واشنطن تكثر المشاكل والمخالفات في سوريا، حيث يترشح بشار الأسد الآن لولاية رئاسية رابعة بموجب نظام ينص على أنه يحق للرئيس بولايتين فقط، مستغلاً بذلك ثغرة دستورية أوجدها هو بنفسه. وبالنظر إلى الجوّ السائد حالياً في سوريا، يدرك العديد من المراقبين أن الانتخابات التي تجري حالياً ليست نزيهة. ومع ذلك، فهي لن تكون ذات مصداقية حتى لو كان السلام يعمّ البلاد. "في 21 أيار/مايو، عقد معهد واشنطن منتدى سياسي افتراضي مع فلاديمير بران، وحنا روبرتس، ووائل سواح، وزهرة البرازي، وإميل حكيم، وإيما بيلز. وبران هو مستشار أقدم في قسم الشرق الأوسط في "المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية". وروبرتس هي متخصصة في شؤون الانتخابات تعمل مع نفس المؤسسة. وسواح هو باحث سياسي أقدم في منظمة المجتمع المدني "إيتانا سوريا". والبرازي هي مديرة مشاركة لـ "برنامج التطوير القانوني السوري". وحكيم هو زميل أقدم لشؤون أمن الشرق الأوسط في "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". وبيلز هي مستشارة أقدم للشؤون السورية في "المعهد الأوروبي للسلام". وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهم". فلاديمير بران بالنظر إلى الجوّ السائد حالياً في سوريا، يدرك العديد من المراقبين أن الانتخابات التي تجري حالياً ليست نزيهة. ومع ذلك، فهي لن تكون ذات مصداقية حتى لو كان السلام يعمّ البلاد، وقد تكون أسباب ذلك أقل وضوحاً بالنسبة لبعض المراقبين. فما الذي يجب إصلاحه على وجه التحديد، وكيف يتم ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال، لا بد من تقييم عدة عوامل، هي: الدستور، قوانين الانتخابات، الإطار التنظيمي، تشكيل إدارة الانتخابات، قواعد الترشح / الحملات الانتخابية، وبالطبع كيف يتم تنفيذ كل ذلك عملياً. وأحد التعقيدات هو أن الجوانب الرئيسية لعملية الانتخابات الرئاسية في سوريا خاضعة للدستور، مما يجعل الإصلاح الانتخابي الشامل مستحيلاً من دون إصلاح الدستور. وفي الوقت نفسه، تم سن مجموعة من التدابير الإضافية خارج الإطار الدستوري لتقويض إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة - من المراسيم الرئاسية وإلى التشريعات البرلمانية والأحكام القضائية. وتتفاقم جميع هذه المشاكل بسبب الحرب المستمرة التي تجاهلتها العملية الانتخابية الجارية على ما يبدو. وعلى الرغم من أن قانون من عام 2006 حاول تحديد الحقوق الانتخابية للنازحين داخلياً، إلا أنه لا يوجد إطار للتعامل مع التصويت لجميع اللاجئين الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين نازح وغيرهم من السوريين الذين يعيشون في الخارج. وتكثر المشاكل والمخالفات الإضافية، حيث يترشح بشار الأسد الآن لولاية رابعة بموجب نظام ينص على أنه يحق للرئيس بولايتين فقط، مستغلاً بذلك ثغرة دستورية أوجدها هو بنفسه. وسوف تتم إدارة الانتخابات من قبل مجلس الإدارة الذي عيّنه. وتشكّل "المحكمة الدستورية العليا" السلطة الأساسية للفصل في أي نزاع، وكان الأسد هو الذي اختار أعضاءها. وحتى مسؤولي الانتخابات المحليين يتم تعيينهم من قبل المحافظين الذين يختارهم الأسد شخصياً. وبالإضافة إلى هذا التلاعب الهيكلي المتعمّد، لم تُظهر الحكومة أي إشارة على تدريب مسؤولي الانتخابات أو إجراء عملية تسجيل الناخبين، لذلك من غير الواضح أي من السوريين يُسمح لهم بالتصويت. وهناك قيود أخرى جعلت من الصعب للغاية على المرشحين ترشيح أنفسهم. وللتأهل لانتخابات ما، يجب أن يكون لدى المرء سجل خالي من الجنايات، وأن يحصل على خمسة وثلاثين دعماً من أعضاء البرلمان، وأن يكون مقيماً في سوريا لمدة عشر سنوات على الأقل - وهو مطلب يستبعد الشتات بأكمله. ونتيجة لذلك، لم يُسمح سوى لثلاثة فقط من أصل واحد وخمسين مرشحاً ممن تقدموا بطلبات للترشح هذا العام، دون وجود شفافية بشأن سبب رفض الثمانية والأربعين الآخرين. حنا روبرتس اقتراع الشتات الذي بدأ في 20 أيار/مايو ليس جديراً بالثقة في تصميمه أو تنفيذه. فمن ناحية التصميم، يقتصر التصويت في الخارج على السفارات التي تديرها الحكومة السورية، مما يثير قضايا تتعلق باللوجستية والحماية. على سبيل المثال، ليس من المجدي لملايين السوريين الذين يعيشون في لبنان وتركيا السفر إلى عاصمة أي من البلدين والتصويت في مبنى واحد. وتفتقر العديد من الدول كلياً إلى سفارة سورية، لذا ليس أمام المهاجرين المقيمين هناك سبيل للتصويت. ويُطلب من الناخبين المؤهلين أيضاً إبراز جواز سفر ساري المفعول مع ختم خروج سوري، والذي يمتلكه عدد قليل من اللاجئين. علاوة على ذلك، يضمن الإعداد لعملية التصويت انعدام الأمن أو خصوصية البيانات، وانعدام مراقبة مستقلة أو تغطية إعلامية، وعدم وجود وسيلة لتقديم الشكاوى. وجاء التنفيذ مع قائمة كبيرة من المشاكل أيضاً. فقد أعلنت سفارات قليلة عن المواعيد النهائية للتسجيل أو مواعيد التصويت. ففي لبنان، أُرغم العديد من الأفراد على التسجيل والتصويت. وفي تركيا، أفادت تقارير بأن بعض الأفراد مُنح العفو مقابل التصويت. وفي مناطق مختلفة، تم اكتشاف أشخاص يدلون بأصواتهم دون بطاقات هوية، ودون حبر لمنع تكرار التصويت، ويقومون بتخزين بطاقات الاقتراع بطريقة غير آمنة، وما إلى ذلك. باختصار، هذه الانتخابات هي خدعة، وأي شخص ينظر إليها بالتفصيل سيرى أنها غير ملائمة للهدف التي أُقيمت من أجله. وائل سواح بما أن غالبية السوريين ليس لديهم خيار حقيقي لصالح مَنْ يدلون بأصواتهم، فقد اتحدت المعارضة داخل البلاد وخارجها ضد هذه الانتخابات بشكل لا مثيل له. ووصفها النقاد بأنها مسرح، وخدعة، ومكافأة لقاتل، بينما أكد البعض أنها تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ولن يشارك سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب والشمال الشرقي من سوريا في هذه الانتخابات. وفي الوقت نفسه، واجه السوريون الذين يعيشون في الخارج ضغوطاً شديدة للتصويت في هذه الانتخابات حتى لو لم يرغبوا في ذلك، وكان الكثيرون خائفين للغاية من مقاطعة الانتخابات. وكان الاختلاف الملحوظ الآخر هو محاولات النظام إضفاء نكهة غربية على الحملة الانتخابية هذا العام باستخدامه المزيد من اللوحات الإعلانية والشعارات الملونة والمقابلات التلفزيونية والميزات المماثلة. وفي الماضي، كان الجمهور المستهدف لأي حملة انتخابية هو الشعب السوري، حيث سعى النظام إلى إقناع أبنائه بأنهم "يختارون" الأسد بشكل ما. لكن الهدف هذا العام هو إقناع العالم الخارجي وتحقيق الشرعية على الساحة الدولية. وقد يكون الأسد قادراً على ادّعاء مثل هذه الشرعية من خلال مجرد "فوزه" في الانتخابات وقيام دول مثل روسيا وإيران والصين بتأكيد النتائج. ومن شأن مثل هذه النتيجة أن تقوّض عملية الانتقال التي تقودها الأمم المتحدة وتعزز المسارات البديلة مثل عملية أستانا، مما يساعد النظام وحلفائه على التركيز بشكل أكبر على المنتديات التي يكون لموسكو رأي أكبر فيها. زهرة البرازي من الواضح أن الانتخابات الحالية مزيفة، لكن بالنسبة للسوريين الذين يريدون مستقبلاً عادلاً وديمقراطياً، ما الذي يجب فعله للإعداد لانتخابات نزيهة في المرة القادمة، أي في عام 2028؟ قبل كل شيء، يجب أن تكون الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. كما أن إنشاء عملية قابلة للتطبيق لغير المقيمين يُعَد أمراً بالغ الأهمية. وتحتاج الدول المجاورة و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" والمنظمات غير الحكومية إلى الانخراط في تسهيل مشاركة الناخبين السوريين في الخارج. ويمثّل الأفراد غير المسجّلين مشكلة كبيرة أيضاً - فمئات الآلاف من السوريين يفتقرون إلى التسجيل الحكومي المناسب لكنهم ما زالوا بحاجة إلى وسيلة للتصويت. وتقوم "اللجنة الدستورية السورية" بدور رئيسي في إشراك الجمهور وإيجاد مسارات قانونية لمعالجة هذه المخاوف. باختصار، عندما تُمنح فرصة واقعية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل، على المجتمع الدولي أن يكون مستعداً وفي جعبته حلول لجميع هذه المشاكل. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يكون المسؤولون ساذجين بحيث يتوقعون بروز هذه الفرصة من تلقاء نفسها. فالحرب مستمرة منذ عشر سنوات، وفي هذه المرحلة يسأل الناس "حسناً، ماذا الآن؟" وقلة هم الذين يعتقدون أن هناك تغييرات سريعة في الأفق، ولكن يجب على جميع الأطراف البدء في التخطيط للمستقبل بطرق عملية ومرئية. أميل حكيم توفّر الانتخابات فرصة مناسبة للدول المقتنعة أساساً بضرورة التعامل مع الأسد. وفي نظرها، قد تكون العملية الانتخابية هزلية، لكنها تحقق شيئاً ما على الأقل، وعلى الرغم من أن عملية جنيف هي أكثر شرعيةً، إلا أنها لم تحقق أي نتائج [ملموسة] لهذه الدول. وبالتالي، ففي العديد من العواصم العربية، يشكّل التطبيع مع الأسد مسألة متى وليس إذا حدث ذلك. ولا يتعلق الأمر بالاقتصاد، بل بتنمية نفوذ [الدول] العربية في سوريا، حيث أصبحت الدول غير العربية الجهات الفاعلة الرئيسية. وفي ظل إدارة ترامب، كانت الولايات المتحدة قادرة على منع التطبيع العربي من خلال مزيج من العقوبات والدبلوماسية، لكن واشنطن أشارت مراراً وتكراراً إلى رغبتها في الخروج من سوريا. وعلى الرغم من أن المراجعة التي تجريها إدارة بايدن في سياستها ما زالت مستمرة، إلّا أن الكثيرين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي ينظر إلى سوريا على أنها قضية هامشية ومشتتة للانتباه، وعلى الجهات الفاعلة الأخرى حلها. ويريد أعضاء فريقه الاستمرار في الضغط على تنظيم «الدولة الإسلامية»، لكنهم لا يريدون أن يكونوا المخططين الأساسيين للتسوية في سوريا. علاوة على ذلك، أدى تركيز وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين على القضايا الإنسانية إلى خلق تصور بأن الإدارة الأمريكية سوف تستبدل رأس المال السياسي من أجل تأمين أهداف إنسانية، وخاصة توسيع الوصول عبر الحدود. كما أن تعنت الأسد أعاق التطبيع العربي مع سوريا. فـ"جامعة الدول العربية" تريد تنازلاً واحداً على الأقل من جانبه قبل إعادة عضوية سوريا في "الجامعة"، لكن الأسد لا يبدي أي ليونة على الإطلاق. وفي هذه المرحلة، يبدو التطبيع التدريجي أكثر ترجيحاً، حيث تركز الحكومات العربية على إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية والمشاريع الأقل إثارة للجدل بهدف تعزيز وجودها في سوريا. إيما بيلز منذ عام 2019 على الأقل، كان واضحاً جداً أن هذه الانتخابات لن تُجرى وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وفي هذا الصدد، لا يوجد شيء جديد هنا - والخبر الحقيقي الوحيد هو أن دمشق لم تكلّف نفسها عناء الحفاظ على التظاهر بإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذه المرة. وبالتالي، فإن أي حكومة أجنبية تقوم حالياً بتطبيع علاقاتها مع الأسد لا تفعل ذلك بسبب الانتخابات. ومن منظور سياسي، أصبح السوريون في لبنان أحد أكبر الهموم. ويمكن أن يتدهور وضع اللاجئين هناك بسرعة بسبب المضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها أولئك الذين حاولوا المشاركة في الانتخابات، سواء طوعاً أو بسبب الإكراه. وعلى نطاق أوسع، حفزت مجموعة من المخاوف المشروعة تطبيع دول المنطقة مع الأسد، مثل احتواء إيران، والتخفيف من التزامات استضافة اللاجئين وتجنب المزيد من عدم الاستقرار والاضطرابات الناجمة عن تداعيات الأزمة السورية. ولن يتم تخفيف هذه المخاوف من خلال النهج الحالي الذي يتبناه المجتمع الدولي، والذي تضمنت نتائجه فراغاً دبلوماسياً مطولاً وانتشار اللا مبالاة/الفتور الاستراتيجي على نطاق واسع. أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية المستقبلية، فإن الدستور السوري ينص على إجراء انتخابات أخرى في عام 2028، لكن لا يوجد سبب للتعامل مع هذا التاريخ على أنه ثابت. ويمكن تصميم إطار لانتخابات نزيهة بما يتماشى مع القرار 2254 في أقل من سبع سنوات. وعلى الرغم من أنه لا ينبغي للسلطات الدولية أن تقلل من شأن التحديات الكامنة في الوصول إلى هذا الهدف، إلا أنه لا ينبغي لها أن تتمسّك بفترات زمنية طويلة بلا داعٍ أيضاً.
الحصاد: عومير كرمي - معهد واشنطن يبدو أن النظام الإيراني يعمل على إزالة أي عقبة قد تمنع رئيس السلطة القضائية الايرانية إبراهيم رئيسي من الفوز برئاسة الجمهورية الإسلامية، وربما خلافة خامنئي كمرشد أعلى. وقد تؤدي خسارته إلى زيادة تقويض الشرعية المحلية للنظام. شكّلت حملة الانتخابات الرئاسية في إيران هذا الأسبوع "مفاجأة شهر أيار/مايو" حيث أعلن "مجلس صيانة الدستور" أنه تمّ استبعاد العديد من المرشحين البارزين من خوض الانتخابات المزمعة في 18 حزيران/يونيو. ورغم أن استبعاد أعداد كبيرة من المرشحين ليس بممارسة جديدة بالنسبة للنظام، إلا أن بعض الأسماء التي تمّ إقصاؤها هذا العام لم تكن متوقعة: فلم تتم الموافقة في النهاية سوى على 7 مرشحين من أصل 40 مرشحاً من الذين استوفوا الحدّ الأدنى من معايير التسجيل في وقت سابق من هذا الشهر، علماً بأن اللائحة النهائية للمرشحين المعتمدين لا تشمل شخصيات بارزة مثل رئيس "المجلس" السابق علي لاريجاني، نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، أو الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وحتى الآن، أعلن لاريجاني وغيره من المرشحين المستبعدين أنهم يقبلون بحكم "المجلس" ولن يطلبوا من المرشد الأعلى علي خامنئي إبطاله. غير أن شخصيات بارزة أخرى وجهت انتقادات علنية. فقد وصف صادق، شقيق لاريجاني، الذي كان رئيس السلطة القضائية الإيرانية بأن القرار "لا مبرر له". أما الإصلاحي المستبعد مصطفى تاج زاده فذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً إنه "لا يجدر بأي مواطن مسؤول الرضوخ" لقرار "المجلس"، ثم أعلن أن القرار يهدف إلى الإطاحة بالجزء "الجمهوري" من الجمهورية الإسلامية. وحتى أن إبراهيم رئيسي - المرشح الأوفر حظاً والذي سيكون أكثر المستفيدين من الاستبعادات - أعرب عن قلقه، مشيراً إلى أنه حاول جعل الانتخابات أكثر تنافسية وتشاركية. ومع ذلك، ربما كانت الغاية من تصريحه هي خدمة مصالحه الذاتية، وبناء شرعيته والرد على الإشارات الشعبية الساخرة للسباق الانتخابي بأنه "رئيسي مقابل رئيسي" - وربما الحفاظ على فرصه في خلافة خامنئي في المستقبل. مَن هم على القائمة النهائية؟ يميل المرشحون السبعة الذين استوفوا المعايير المطلوبة وبشدة نحو المعسكر المحافظ، مع إضافة اسمين ثانويين من غير المحافظين لتمويه أحدث خطوات النظام للسيطرة [على مرشحي الانتخابات]. ومن بين أبرز هؤلاء المحافظين نذكر رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله رئيسي الذي يُعتبر حالياً على نطاق واسع المرشح المفضل لخامنئي بعد أسابيع من التأييد الضمني له وانسحاب العديد من كبار المحافظين (على سبيل المثال، رئيس "الباسيج" السابق علي رضا أفشار، وزير الدفاع السابق حسين دهقان، ووزير النفط السابق رستم قاسمي). وتظهر أربع شخصيات أخرى من المحافظين/المتشددين في اللائحة النهائية، على الأقل في الوقت الحالي وهم: رئيس «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني السابق وأمين "مجمع تشخيص مصلحة النظام" الحالي محسن رضائي، وأمين "المجلس الأعلى للأمن القومي" سعيد جليلي، وعضو "المجلس" السابق علي رضا زاكاني (الذي تم استبعاده من سباقييْن رئاسييْن سابقيْن)، ونائب رئيس "المجلس" الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي. وإذا كان التاريخ مؤشراً، فمن المرجح أن ينسحب معظمهم قبل وصولهم إلى خط النهاية ويتّحدوا وراء رئيسي باعتباره المرشح الرئيسي المحافظ. أما المرشحان غير المحافظين في اللائحة فهما رئيس "البنك المركزي" الإيراني عبد الناصر همتي المتحالف مع حزب الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني ولكن يُنظر إليه على أنه تكنوقراط أكثر من كونه زعيم سياسي، والإصلاحي محسن مهرعليزاده، الذي شغل منصب نائب الرئيس أثناء فترة رئاسة محمد خاتمي. ولا يملك أي من هذين المرشحين قاعدة انتخابية مهمة أو حضوراً بارزاً في الساحة السياسية الإيرانية، خاصة بالمقارنة مع المرشحين الذين لم يُسمح لهم بخوض المعركة الانتخابية. إفساح المجال لرئيسي كان علي لاريجاني من أهم الأسماء وأكثرها مفاجأة من الذين استبعدهم "المجلس" نظراً إلى نسبه وشهرته في الميدان السياسي في إيران. فعائلته هي من الأسر الأكثر نفوذاً في البلاد، ولها علاقات قوية مع كل من رجال الدين في قم والنخبة السياسية في طهران. كما خدم الجمهورية الإسلامية في العديد من المناصب الرفيعة منذ الثمانينيات - كضابط في «الحرس الثوري» الإيراني، ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، وسكرتير "المجلس الأعلى للأمن القومي"، وكبير المفاوضين النوويين، ومؤخراً، كرئيس "المجلس" لثلاث فترات. وقد تأهل للترشح للرئاسة في الماضي (حصل على حوالي 5 في المائة من الأصوات في عام 2005)، ولا يزال من أبرز رموز النظام اليوم. ومنذ تسجيل اسمه لانتخابات هذا العام، كان لاريجاني ناشطاً للغاية على تطبيقات "كلوب هاوس" و "إنستغرام" و "تويتر" ووسائل تواصل اجتماعي أخرى، حيث كان ينشر عدة مرات في اليوم ويهاجم بعض منافسيه المتشددين، من بينهم رئيسي وجليلي. واقترح البعض أن تحوّله العملي يهدف إلى اجتذاب قاعدة الرئيس حسن روحاني من الناخبين الأصغر سناً والأكثر ثقافةً، الذين لا يرغبون عموماً في أن يصبح إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية. ولم يتم نشر السبب الرسمي لإقصاء لاريجاني - وفقاً لبعض التقارير، حاول "مجلس صيانة الدستور" إلقاء اللوم على ابنته بسبب دراستها المزعومة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فمن الأرجح أن سجله الحافل المثير للاهتمام وإمكانية أن يكون مرشح تسوية نافذاً هما ما تسبب بإقصائه. كما أزال "المجلس" عقبات أخرى من أمام رئيسي من خلال قطع الطريق أمام مرشحين بارزين مرتبطين بالإصلاح أمثال جهانغيري وتاج زاده ومحسن هاشمي رفسنجاني (نجل الرئيس السابق). وسجلت جبهة الإصلاح عدة مرشحين على أمل أن يُسمح لعدد قليل منهم على الأقل بخوض الانتخابات، ولكنهم كانوا يتوقعون بلا شك أن تتمكّن شخصية أهم من مهر علیزاده (الذي لم يكن أحد المتقدمين من قبل جبهة الإصلاح) من تخطي عتبة الترشح. ورداً على القائمة النهائية لـ "المجلس"، غرد المتحدث باسم الجبهة، عازار المنصوري، بأنهم لن يدعموا أي مرشح لأن جميع الإصلاحيين قد تم استبعادهم. أما بالنسبة لأحمدي نجاد، فلم يلبّ المعايير المطلوبة تماماً كما حصل خلال الانتخابات السابقة؛ وعلى الرغم من أن هذا القرار كان متوقعاً، إلّا أن بعض التقارير أفادت بأن النظام نشر قوات الأمن في الحي الذي يسكنه تحسباً لأي ردّ فعل عكسي على الإعلان. كذلك، تمّ رفض ترشح المسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني سعيد محمد لخوض الانتخابات. قد يؤدي تأمين مستقبل رئيسي إلى تآكل شرعية النظام عندما استبعد "مجلس صيانة الدستور" شخصيات بارزة خلال الانتخابات السابقة، حاول بذلك إرساء توازن من خلال السماح لمرشحي تسوية أقل "خطورة" بالترشح. وتمثلت الفكرة بتقديم شخص يتوافق معه الناخبون العمليون وتقليص فرصة نسب المشاركة الضئيلة بشكل محرج. ففي عام 2013، على سبيل المثال، مُنع رفسنجاني الأكبر من الترشح باعتباره مرشحاً عملياً نافذاً، في حين نجح روحاني "باعتباره الخيار الأكثر أماناً" وفاز بالرئاسة في النهاية. وأخيراً، يمكن للعديد من الخطوات التي لا يمكن التنبؤ بها أن تقلّص رد الفعل المحلي لإعلان "المجلس". على سبيل المثال، قد يقرر خامنئي إعادة بعض المرشحين غير المؤهلين كما فعل أحياناً في الماضي، أو قد يعتمد فقط على المصلحة الشعبية في الانتخابات البلدية المتزامنة لضمان مشاركة محترمة في التصويت الرئاسي. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يبدو النظام مستعد لإبعاد بعض مؤيديه الرئيسيين فقط للحرص على فوز رئيسي بأي ثمن. ويكمن أحد التفسيرات المحتملة لهذا النهج المحفوف بالمخاطر في الإشارات العديدة على أن رئيسي يجري إعداده تدريجياً لخلافة خامنئي كمرشد أعلى. وقد يؤدي فوزه في انتخابات الشهر المقبل إلى تعزيز إرثه التنفيذي لهذا المنصب، في حين أن خسارته السباق الرئاسي الثاني على التوالي قد ينهي هذا الاحتمال تماماً. وفي كلتا الحالتين، قد ينتهي الأمر إلى مزيد من تقويض الشرعية المحلية للنظام.
الحصاد: د. حسن محمد صندقجي المعدة والمريء من الأعضاء الحساسة جداً في الجسم، ويناط بهما أداء وظائف مهمة في عملية استقبال وهضم الطعام. وهما يضطران في نفس الوقت إلى التعامل وحدهما، ودون مساعدة منا، بما يتم بلعه من أطعمة أو مشروبات. وتبعاً لذلك تتأثر حالتهما الصحية وقدراتهما على أداء وظائفهما، بعدد من السلوكيات الحياتية التي نمارسها في حياتنا اليومية، سواء منها ما يتعلق بعملية الأكل ومكونات الوجبة الغذائية، أو بممارسات يومية لا علاقة لها بعملية الأكل كالتدخين أو تناول الأدوية المسكنة للألم غير الستيرويدية NSAID. 1- سلوكيات مؤذية ونتيجة لأي تأثيرات سلبية عليهما في طريقة تناول الطعام، يعاني المرء إما من صعوبات وألم في البلع، أو حرقة تسريب أحماض المعدة إلى المريء، أو آلام التهابات وقروح المعدة والمريء، أو اضطرابات الهضم، أو انتفاخ البطن، أو زيادة الوزن. ومن سلوكيات تناول الطعام التي قد تؤذي المعدة والمريء: تناول الطعام قبل الذهاب للنوم. وتناول أي أطعمة قبل النوم، ولو كانت قليلة، يمكن أن يلحق الضرر بالمعدة وبالراحة أثناء النوم. أما تناول وجبة طعام العشاء قبل الذهاب إلى النوم، فيتسبب في مزيد من الضرر، خاصةً الأطعمة الدسمة التي تظل في المعدة وقتاً طويلاً قبل الخروج منها إلى الأمعاء. وتفيد الإحصائيات الطبية أن حوالي 20 في المائة من الناس يعانون من درجات متفاوتة الشدة لحالات تسريب أحماض المعدة إلى المريء. ولذا ولهؤلاء، فإن أحد أهم السلوكيات الصحية لتخفيف هذه المعاناة عنهم، هي أن يكون بين وجبة العشاء وموعد النوم حوالي 3 ساعات. وللأشخاص الذين لا يعانون من هذه المشكلة، يمكن أن يكون وقت وجبة العشاء قبل حوالي 90 دقيقة من موعد النوم، كي يترك وقت كاف لإفراغ المعدة من محتوياتها قبل وضعية استلقاء الجسم للنوم. كما يجدر انتقاء أنواع من الأطعمة التي لا تبقى كثيراً في المعدة، وتحاشي الوجبات الدسمة والمقليات. ومما يساعد على منع الشعور بالجوع أثناء الليل، إضافة أطعمة غنية بالألياف وبالبروتينات الخالية من الدهون في وجبة العشاء، كي يدوم الشعور بامتلاء وشبع البطن. ومن أمثلة الأطعمة البروتينية: لحوم صدور الدجاج والديك الرومي والبيض المسلوق ولبن الزبادي واللبنة وجبنة قريشة Cottage Cheese القليلة الدسم. وهذه الأطعمة البروتينية تحتوي أيضاً على عناصر غذائية تساعد في تسهيل الخلود إلى النوم. 2- اضطراب الوجبات اضطراب وقت وجبات الطعام. أفضل ما يقدمه المرء لمعدته هو تعويدها على استقبال وجبات الطعام في أوقات شبه ثابتة خلال اليوم. ولذا فإن نسيان تناول إحدى وجبات الطعام، أو التناول المفاجئ لوجبات خفيفة، ولكنها ثقيلة بالدهون والسكريات، أمور تؤذي المعدة. وتشير بعض المصادر الطبية أن المعدة إذا تعودت على أوقات ثابتة لتناول الطعام، ربما تقوم كعادتها بإفراز الأحماض لهضم الأطعمة التي تتوقع استقبالها. وعدم تناول الطعام آنذاك قد يؤذي المعدة بالأحماض. كما تشير بعض الدراسات الطبية أن الاختلاف في توقيت الوجبة على مدى فترة طويلة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأعراض جرثومة المعدة Helicobacter pylori والتهاب المعدة. علاوة على ذلك، فإن عدم وجود وقت محدد لتناول أي وجبة في اليوم سيجعل الجسم يفشل في إفراز الإنزيمات الصحيحة، لأن الدماغ يعتريه تشويش عند اختلاف توقيت تناول الوجبات. وتقول بروك ألبرت، مؤلفة كتاب «حمية التخلص من السموم» واختصاصية التغذية: «تخطي الوجبات لحرمان نفسك أو معاقبتها، أو لأنك مشغول جدًا عن تناول الطعام، له عواقب سلبية على جسمك». بينما تفيد بوني تاوب ديكس، مؤلفة كتاب «أقرأها قبل أن تأكلها» واختصاصية التغذية: «عندما يتخطى الأشخاص وجبات الطعام، فإنهم يشعرون أنهم مدينون بشيء ما في وقت لاحق من اليوم، لذا فهم يميلون إلى الإفراط في تناول وجبتهم التالية». وتضيف قائلة: «إذا قسمت وجباتك على مدار اليوم، فسيكون جسمك قادرًا على استخدام هذه العناصر الغذائية بكفاءة أكبر. ولمساعدة جسمك على العمل بشكل صحيح، تأكد من الاستمتاع بثلاث وجبات متوازنة في اليوم، وتناول وجبة خفيفة صحية عندما تكون جائعًا بين الوجبات». 3- عدم مضغ الطعام جيداً لا يتعلق الأمر فقط بوقت تناول الطعام أو ما يأكله المرء، ولكن أيضاً كيفية تناول الطعام لها أهمية لصحة المعدة والمريء. وعدم مضغ الطعام جيداً، والسرعة في وضع الطعام في الفم، وبلع لقم الطعام سريعاً، يتسبب في ضعف قدرة الأمعاء على هضم الأطعمة، لأن اللعاب يحوي عدداً من الأنزيمات التي تبدأ في عمليات هضم الأطعمة. وبعض المصادر الطبية تقول إن: «الجهاز الهضمي يريد أن يتم 50 في المائة من عملية الهضم في الفم». كما أن السرعة في تناول الطعام والطعام غير الممضوغ جيداً وغير الممزوج جيداً باللعاب اللزج، يتسبب في صعوبات في البلع، ويتسبب أيضاً باضطراب في الحركة الدودية Esophageal Peristalsis لأنبوب المريء في دفع الطعام نحو المعدة ودخول الطعام إلى المعدة بتناغم مع فتح العضلة العاصرة في أسفل المريء LES، وعدم قدرة المعدة على التوسع بسلاسة وراحة لاستيعاب الطعام. وحول عدد مرات مضغ اللقمة من الطعام، تشير إحدى الدراسات البريطانية إلى أن غالبية الناس تمضغها ما بين 5 إلى 6 مرات. وأشارت دراسات عدة أن ذوي الوزن الزائد غالباً لا يمضغون الطعام جيداً مقارنة بذوي الوزن الطبيعي. ولزيادة فقدان الوزن، وجدت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين يمضغون كل لقمة 40 مرة فقدوا وزنًا أكبر من أولئك الذين يمضغون كل لقمة أقل من 10 مرات. وذكرت دراسة سابقة لباحثين من جامعة برمنغهام، أن المضغ الجيد للطعام لمدة نصف دقيقة على أقل تقدير لكل لقمة من الطعام، يقلل من كمية الطعام الذي يتناوله المرء في وجبة الطعام ويقلل من احتمالات الرغبة في تناول الطعام لاحقاً. ومضغ الطعام جيداً يحسن من صحة المعدة عبر ضبط كمية الأحماض التي تفرزها، ويزيد من قدرة الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، ويقلل من اضطرابات الإخراج (وخاصةً الإمساك)، ويقلل من غازات البطن، ويساعد في خفض وزن الجسم. 4- طريقة تناول الطعام وضعية تناول الطعام عند الأكل وبعده. تحتاج عملية تناول الطعام ومضغه وبلعه، وكذلك هضم المعدة والأمعاء للطعام، أن يكون الجسم في وضعية الجلوس المعتدلة. أي دون الاتكاء على أحد الجانبين أو الانحناء الشديد إلى الأمام، وأيضاً دون الوقوف. وبالمقارنة بين الوقوف أو الجلوس أثناء تناول الطعام، تقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC: «الوقوف أثناء الأكل قد يؤدي إلى الأكل بلا وعي أو بسرعة كبيرة». ذلك أنه وفق ما تشير إليه نتائج الدراسات فإن الجلوس يساعد في بطء تناول وجبة الطعام وزيادة اليقظة الذهنية أثناء تناول الطعام Mindful Eating وتقليل كمية الطعام المتناولة، مقارنة بالوقوف. وفي دراسة لباحثين من جامعة أوترخت في هولندا، تبين أن الوقوف أثناء وبعد تناول وجبة الطعام يسرع بالشعور بالجوع لاحقاً، مقارنة بالجلوس. وأيضاً يزيد من احتمالية سوء هضم الكربوهيدرات، وخاصةً منها الكربوهيدرات المتسببة بالغازات. وبالتالي الوقوف أثناء الأكل قد يزيد من الغازات والانتفاخ من خلال التأثير على: سرعة الأكل، وزيادة كمية الطعام المتناولة، وبلع مزيد من الهواء، وعدم هضم الكربوهيدرات بشكل كافي، وذلك مقارنة بالجلوس. وقارنت إحدى الدراسات سرعات الهضم لدى الأفراد الذين استلقوا أو جلسوا أو تحركوا بعد تناول وجبة الطعام. واستغرق الأمر لدى الذين استلقوا بعد الأكل مدة أطول بنسبة 100 في المائة، مقارنة بمن جلسوا أو تحركوا. ولم تجد دراسات أخرى فرقاً زمنياً واضحاً في مدة الهضم بين الجلوس أو الوقوف بعد تناول الطعام. وبعد تناول الطعام، يكون الهضم أبطأ عند الاستلقاء وأسرع عند الوقوف أو الحركة، وكذلك يزيد تسريب أحماض المعدة إلى المريء عند الاستلقاء. وفي إحدى دراسات باحثين من جامعة أوتاه، وباستخدام التصوير النووي لإفراغ المعدة، تبين أن وضعية الاستلقاء تبطئ بشكل كبير من إفراغ المعدة مقارنة بجميع الأوضاع الأخرى. هذا بالإضافة إلى أن الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد تناول وجبة الطعام يزيد من احتمالات تسريب أحماض المعدة إلى المريء، لأن الاستلقاء يحرم من ميزة تأثير الجاذبية الأرضية للمساعدة في الحفاظ على محتويات المعدة في المعدة. متى تكون كمية الأكل كبيرة على المعدة؟ > المعدة أنبوب عضلي طويل. وعندما تكون فارغة، فلها شكل الكمثري ومتوسط وزنها حوالي 135 غراما، وقطرها حوالي 5 سنتيمترات. وهي قابلة للتمدد إلى خمسة أضعاف هذا الحجم لتسع حوالي ما بين 2 إلى 3 لترات من السوائل والأطعمة. ولكنها تبدأ في إظهار عدم الراحة عند تجاوز كتلة ما يدخلها (سوائل وأطعمة) مقدار حوالي 1 كيلوغرام من الأطعمة والسوائل. والمعدة وإن كانت مثل البالون القابل للتمدد لاستيعاب كمية الطعام والمشروبات المتناولة، إلا أنها، وبمجرد إفراغ محتوياتها نحو الأمعاء، تعود إلى حجمها الطبيعي. واختلاف الناس في القدرة على تناول كميات متفاوتة من حجم وجبة الطعام ليس بسبب «كبر» أو «صغر» حجم المعدة، بل بسبب الـ«تعويد» السلبي للمعدة على سهولة التمدد والتوسع عند كل مرة يتمادى المرء فيها في تناول كمية كبيرة من الطعام. وانتظار الشعور بالشبع قبل التوقف عن تناول الطعام ليس سلوكاً صحياً في التعامل مع المعدة برفق، لأن المعدة عندما تمتلئ جداً بالطعام، ترسل إشارات عصبية إلى الدماغ كي ينبه المرء بضرورة التوقف عن تناول مزيد من الطعام. ولكن هذا التنبيه يتم عبر إفراز هرمون «غرلين» الذي قد يستغرق مدة 20 دقيقة كي يبدأ مفعوله. وهو ما يبرر ضرورة التوقف عن تناول المزيد من الطعام قبل بلوغ حالة الشعور بـ«الشبع». كيف تحسن عادات الأكل؟ تحت عنوان «تحسين عادات الأكل الخاصة بك» تفيد المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: «عندما يتعلق الأمر بالأكل، لدينا عادات بعضها جيد وبعضها ليس جيدا. ورغم أن العديد من عاداتنا الغذائية قد نشأت خلال مرحلة الطفولة، إلا أن هذا لا يعني أن الوقت قد فات لتغييرها. ويتطلب تحسين عاداتك الغذائية بشكل دائم، اتباع نهج مدروس يمكنك من خلاله التفكير والاستبدال والتعزيز». وتضيف موضحة هذه الخطوات الثلاث: «فكر في جميع عاداتك الغذائية، سواء كانت سيئة أو جيدة، والمحفزات الشائعة للأكل غير الصحي لديك. واستبدل عاداتك الغذائية غير الصحية بأخرى صحية. وعزز عاداتك الغذائية الجديدة». > في خطوة «فكر»، تنصح المراكز بوضع قائمة لعادات تناول الأكل لديك، وخاصةً منها التي تؤدي بك إلى الإفراط في تناول الطعام، مثل تناول الطعام بسرعة، وتناول الطعام برغم عدم الشعور بالجوع، والأكل واقفاً، وتخطي بعض وجبات الطعام. ويجب تحديد المحفزات لتناول الطعام دون الشعور بالجوع، مثل: - فتح الثلاجة ورؤية وجبات خفيفة مفضلة. - الجلوس في المنزل لمشاهدة التلفزيون. - العودة إلى المنزل بعد العمل وليس لديك فكرة عما هو موجود لتناول العشاء. - الشعور بالملل أو التعب، والتفكير بأن تناول الطعام سيؤدي إلى انتعاشك. ثم اسأل نفسك: هل هناك أي شيء يمكنني القيام به لتجنب هذه المحفزات؟ وبالنسبة للأشياء التي لا يمكنني تجنبها، هل يمكنني القيام بشيء مختلف يكون أكثر صحية؟ > وفي خطوة «استبدل»، تقول: «قم باستبدال العادات غير الصحية بأخرى صحية. وعلى سبيل المثال، عند التفكير في عاداتك الغذائية، قد تدرك أنك تأكل بسرعة كبيرة عندما تأكل بمفردك. لذلك، التزم بمشاركة وجبة غداء كل أسبوع مع زميل. وأيضًا، قلل من عوامل التشتيت، مثل مشاهدة الأخبار أثناء تناول الطعام، لأن هذه المشتتات تمنعك من الانتباه بسرعة لمقدار ما تأكله». وتضيف: «تناول الطعام فقط عندما تكون جائعًا حقًا. تناول الطعام ببطء أكثر. وإذا وجدت نفسك تأكل عندما تشعر بمشاعر غير الجوع، مثل الملل أو القلق، فحاول إيجاد نشاط غير متعلق بالأكل للقيام به بدلاً من ذلك. قد تجد نزهة سريعة تساعدك على الشعور بالتحسن. وخطط للوجبات في وقت مبكر لضمان تناول وجبة صحية متوازنة». > وفي خطوة «عزز»، تقول المراكز الأميركية: «عزز عاداتك الصحية الجديدة وكن صبورًا مع نفسك. تستغرق العادات وقتًا لتتطور. لا يحدث ذلك بين عشية وضحاها. عندما تجد نفسك منخرطًا في عادة غير صحية، توقف في أسرع وقت ممكن واسأل نفسك: لماذا أفعل هذا؟ متى بدأت بفعل هذا؟ ما هي التغييرات التي احتاجها؟. احرص على عدم توبيخ نفسك أو الاعتقاد بأن خطأً واحدًا «يضر بالعادات الصحية» ليوم كامل.
الححصاد BBC انتهت مهلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة، ما يمنح منافسيه فرصة لتولي السلطة وإنهاء فترته المثيرة للانقسام، في رئاسة الوزراء. وظل نتنياهو يحاول، منذ 28 يوماً، تشكيل تحالف بعد الانتخابات العامة، في 23 مارس/آذار، وهي الرابعة من نوعها خلال عامين. وانقضى الموعد النهائي للتشكيل منتصف ليل الأربعاء. وقال مكتب الرئيس رؤوفين ريفلين في بيان إن نتنياهو "أبلغ (الرئاسة) أنه غير قادر على تشكيل حكومة وبالتالي أعاد التفويض إلى الرئيس". ما الذي يستطيع الرئيس فعله؟ يستطيع ريفلين الآن أن يطلب رسمياً من زعيم سياسي آخر محاولة تشكيل ائتلاف. لكن هذا قد يؤدي إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى. وستكون هذه ضربة لنتنياهو، الزعيم الإسرائيلي الأطول خدمة. ولكن ذلك كان متوقعاً على نطاق واسع، بعد النتيجة غير الحاسمة للانتخابات، بحسب تقرير مراسلة بي بي سي من القدس، يولاند نيل. صدر الصورة،EPA التعليق على الصورة، الرئيس الإسرائيلي عقد مشاورات مع زعماء أحزاب مختلفة. ويستطيع الرئيس ريفلين الآن منح عضو آخر في البرلمان 28 يوماً لمحاولة تشكيل حكومة جديدة. ومن المتوقع أن يختار يائير لابيد، الذي جاء حزبه الوسطي "يش عتيد" في المرتبة الثانية بعد حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، في التصويت الأخير. وسيواجه لابيد تحدياً لرأب الخلافات الأيديولوجية الواسعة بين الأحزاب التي قد يطلب منها الانضمام إلى ائتلاف. وإذا ثبت أن المرشح الذي طلبه الرئيس غير قادر على تشكيل حكومة، فيمكنه تكليف البرلمان باختيار مرشح. وإذا لم يستطع، فستجري إسرائيل انتخابات أخرى. ومما زاد التعقيد خلال تلك الفترة الطويلة من الجمود السياسي في إسرائيل، استمرار محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد. وفيما ينفي نتنياهو التهم الموجهة اليه، يقول خصومه إنه لا ينبغي عليه البقاء في منصبه أثناء مواجهة تهم جنائية. ما الذي عرقل محاولة تشكيل الحكومة؟ لم يستطع حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو (71 عاماً)، الفوز بأكبر عدد من المقاعد في التصويت، لكنه حصل وحلفاؤه على الأغلبية المطلقة في الكنيست الذي يضم 120 مقعداً. ويبدو أن الناخبين اختاروا، بحسب محللين، ألا يكافئوا نتنياهو على حملة التطعيم الناجحة في مواجهة فيروس كورونا. ويعد نتنياهو أطول زعماء إسرائيل خدمة، إذ قاد خمس حكومات منذ عام 1996. وانهارت حكومته الأخيرة (التي تقاسم فيها السلطة مع حزب المعارضة الرئيسي آنذاك، للمساعدة في معالجة وباء فيروس كورونا)، في ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى إجراء الانتخابات الأخيرة. وكان من المحتمل أن يتطلب أي ائتلاف بقيادة نتنياهو تعاوناً ضمنياً بين حزب "القائمة العربية الموحدة" (راعم)، وتحالف الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الذي ألقى تبنى قادته خطاباً معادياً للفلسطينيين. صدر الصورة،EPA التعليق على الصورة، منصور عباس زعيم حزب "راعم" الفلسطيني أبدى الاستعداد للمشاركة في أي ترتيب يساعد في تحسين حياة الفلسطينيين. وقال منصور عباس، زعيم حزب "راعم"، إنه منفتح على أي ترتيب يحسن مستويات المعيشة للأقلية الفلسطينية في إسرائيل التي تبلغ 20 بالمئة. لكن زعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش وصف "راعم" بأنهم "مؤيدون للإرهاب"، وقال إنه يرفض العمل معهم. وكان بإمكان نتنياهو أيضاً أن يتوصل إلى العدد المطلوب من خلال التصالح مع تلميذه السابق المنفصل عنه، القومي الديني نفتالي بينيت، وإقناع المنشقين عن الليكود في حزب "الأمل الجديد" بالعودة إلى حزبه. لكن زعيم "الأمل الجديد "جدعون سار أكد أن حزبه ملتزم بالإطاحة بنتنياهو. وقال بينيت، رجل الأعمال السابق والمليونير، الاثنين، إنه كان بإمكانه تأييد نتنياهو للحفاظ على الحكم اليميني، لكنه لم يرَ أن هناك احتمالاً لرئيس الوزراء لتشكيل ائتلاف قابل للحياة. وانتقد حزب الليكود الأربعاء بينيت لما وصفه "برفضه تشكيل حكومة يمينية". ويُنظر إلى بينيت منذ فترة طويلة على أنه داعم متشدد ومتحمس لتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. لكنه سعى إلى تسليط الضوء على مؤهلاته التجارية والإدارية، بعدما دمرت عمليات الإغلاق الوبائي الاقتصاد الإسرائيلي. وقال بينيت إن أولويته القصوى هي تجنب إجراء انتخابات خامسة، وإنه سيعمل على تشكيل حكومة وحدة إذا لم يتمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف. وقد ينتهي الأمر بينيت بقيادة حكومة وحدة، على الرغم من سيطرة حزبه "يمينا" على سبعة مقاعد فقط.
الحصاد: قال وزير المالية السعودي إن المملكة قد توفر 200 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محليا بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، وسط مساع لخفض التكاليف من أجل تمويل استثمارات. وشرعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في خطة إصلاحات طموح خلال السنوات الأخيرة لتحديث الاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من الاعتماد على إيرادات النفط. وقال الوزير مجمد الجدعان "إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل. "هذا البرنامج سيوفر للحكومة حوالي 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار". وقعت السعودية الشهر الجاري اتفاقات لشراء الكهرباء مع سبع مشروعات للطاقة الشمسية في إطار خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء. وقال الجدعان "بدلا من شراء الوقود من الأسواق العالمية بستين دولارا ثم بيعه إلى المرافق السعودية بستة دولارات، أو استخدام جزء من حصتنا في أوبك للبيع بستة دولارات، سنستبدل فعليا ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة ونحل محلها الغاز والطاقة المتجددة". وتضررت السعودية ضررا شديدا من انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا العام الماضي، وقد أعلنت حديثا عن خطة لتسريع الاستثمار الداخلي ضمن برنامج لإنفاق تريليونات الدولارات تقوده شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو وصندوق الثروة السيادي الضخم، صندوق الاستثمارات العامة، البالغ حجمه 400 مليار دولار. وفي محاولة لرفع عبء تمويل بعض الاستثمارات عن كاهل الخزانة، طُلب من بعض الشركات تقليص التوزيعات التي تُصرف للحكومة وتعزيز إنفاقها الرأسمالي. وقال الجدعان "من الآن وحتى 2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية للاستدامة المالية. نرى أنه لكي نحقق جميع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030، نحتاج لصيانة الاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي". ورؤية 2030 هي خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير السعودية عن طريق الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط وبناء صناعات ومشروعات ضخمة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير ملايين الوظائف. وفي نهاية 2020، انخفض معدل البطالة إلى 12.6 بالمئة من مستوى قياسي مرتفع عند 15.4 بالمئة في الربع الثاني من العام الماضي حين كان الاقتصاد يعاني بسبب الجائحة، لكنه يظل أعلى كثيرا من السبعة بالمئة التي تستهدفها المملكة. وقال الجدعان "لم نغير هدف البطالة للعام 2030، لكن لأننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد فمن الصعب جدا أن نتوقع معدل البطالة للعام 2021. "هدفنا خفض الرقم بحيث ننهي العام عند مستوى أقل مما كان عليه في 2019، قبل كوفيد، لكن لا يمكن أن أقول إنه سيحدث بكل تأكيد".
الحصاد: BBC في تطور جديد يتعلق بملف ما يسمى "مذابح الأرمن"، نسبت وكالة رويترز للأنباء لمصادر القول إنه من المتوقع أن يعترف بها الرئيس الأمريكي جو بايدن رسمياً. ولطالما نفت تركيا المزاعم بارتكاب مذبحة بحق الأرمن خلال الأعوام الأخيرة من عمر الإمبراطورية العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى والتي تعتبرها عدة دول غربية عملاً من أعمال الإبادة الجماعية. وينتظر أن تثير الخطوة الأمريكية حنق تركيا وتفاقم توتر العلاقات بين الدولتين. فقد قالت ثلاث مصادر مطلعة إنه من المرجح أن يستخدم بايدن عبارة "إبادة جماعية" في بيان يوم 24 أبريل/ نيسان عندما تُنظم فعاليات سنوية لإحياء ذكرى الضحايا في مختلف أنحاء العالم. ولكن المصادر حذرت من أن بايدن قد يؤثر في اللحظة الأخيرة عدم استخدام هذا التعبير في ضوء أهمية العلاقات الثنائية مع تركيا. وكان بايدن قد أحيا قبل عام، عندما كان لا يزال مرشحا رئاسيا، ذكرى "مليون ونصف مليون أرمني من الرجال والنساء والأطفال الذين فقدوا أرواحهم في الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية"، وقال إنه سيدعم مساعي وصف عمليات القتل تلك بالإبادة الجماعية. ومرر مجلس الشيوخ الأمريكي في 2019 قراراً غير ملزم يعترف بعمليات القتل بصفتها إبادة جماعية في خطوة تاريخية زادت وقتها من غضب تركيا. وأرسل عضو الكونغرس البارز عن الحزب الديمقراطي آدم شيف ومجموعة من نحو 100 من النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خطابا لبايدن مؤخرا طالبين منه الوفاء بتعهده الانتخابي. صدر الصورة،GETTY IMAGES وتقول تركيا أن كثيرين من الأرمن الذين كانوا يعيشون في الإمبراطورية العثمانية قُتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تشكك في أعداد من قُتلوا وتنفي أن تكون أعمال القتل مدبرة على نحو ممنهج ترقى الى الإبادة جماعية. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو إن من شأن أي تحرك من قبل بايدن لوصف أعمال القتل بالإبادة الجماعية أن يلحق ضرراً أكبر بالعلاقات المتوترة أصلاً بين الدولتين. يذكر أن إجراءات كانت تهدف للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن قد تعطلت لعقود في الكونغرس الأمريكي، وأحجم الرؤساء الأمريكيون عن وصفها بذلك خشية تأثر العلاقات مع تركيا سلبا وبفضل اللوبي الكبير الذي جندته تركيا في الولايات المتحدة ضد تلك الإجراءات. فما هي الحكاية؟ تقول دائرة المعارف البريطانية إن "المذابح" التي تعرض لها الأرمن تمت من خلال عمليات تهجير قسري وقتل جماعي نفذتها حكومة حزب تركيا الفتاة التي كانت تحكم الدولة العثمانية ضد الرعايا الأرمن في الإمبراطورية خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918). ويقول الأرمن إن تلك الحملة كانت محاولة متعمدة لإبادتهم وبالتالي تعد عملاً من أعمال الإبادة الجماعية، وقد قاومت الحكومات التركية المتعاقبة الدعوات للاعتراف بها على هذا النحو معتبرة أنه على الرغم من الفظائع التي حدثت فإنه لم تكن هناك سياسة إبادة رسمية تنفذ ضد الشعب الأرمني. الأرمن في شرق الأناضول كانت الهضبة الجبلية العظيمة في شرق الأناضول، وهي في شرق تركيا حاليا، مأهولة لعدة قرون بشكل أساسي من قبل الأرمن المسيحيين الذين تقاسموا المنطقة مع الأكراد المسلمين، بحسب دائرة المعارف البريطانية. وحكمت المنطقة في العصور القديمة والوسطى سلسلة من الأسر الأرمنية على الرغم من أنها غالبا ما واجهت توغلات من قبل قوى خارجية. وانتهى الاستقلال السياسي الأرمني إلى حد كبير نتيجة سلسلة من الغزوات والهجرات من قبل الشعوب الناطقة بالتركية بداية من القرن الحادي عشر، وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر تم بسط سيطرة الأتراك تماما على تلك المناطق ودمجها في الإمبراطورية العثمانية الشاسعة. وقد احتفظ الأرمن بشعور قوي بالهوية القومية تجسد في اللغة الأرمنية والكنيسة الأرمنية، وتعزز هذا الشعور بفضل نظام الملل العثماني الذي منح الأقليات غير المسلمة استقلالية إدارية واجتماعية كبيرة. صدر الصورة،AFP وفي بداية القرن العشرين كان هناك حوالي 2.5 مليون أرمني يعيشون في الإمبراطورية العثمانية تركز معظمهم في شرق الأناضول. كما عاش عدد كبير من الأرمن خارج الحدود الشرقية للإمبراطورية العثمانية في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. وكانت حياة القرويين وسكان المدن الأرمن في الإمبراطورية العثمانية صعبة حيث كانوا غالبا ما يتعرضون لمعاملة قاسية من قبل الأكراد المهيمنين على المنطقة، كما كانت المحاكم المحلية والقضاة يحابون المسلمين في كثير من الأحيان في أي نزاع، ولم يكن للأرمن ملاذ يُذكر عندما يقعون ضحايا للعنف أو عندما يتم الاستيلاء على أراضيهم أو مواشيهم أو ممتلكاتهم بحسب دائرة المعارف البريطانية. وكانت الغالبية العظمى من الأرمن مزارعين فقراء، لكن القليل منهم حقق النجاح كتجار وحرفيين، وقد أدت مشاركة الأرمن في التجارة الدولية في القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى إنشاء تجمعات أرمنية مهمة في إسطنبول ومدن الموانئ العثمانية وفي مناطق بعيدة مثل الهند وأوروبا. وعلى الرغم من سيطرة المسلمين على المجتمع العثماني، إلا أن عددا قليلا من العائلات الأرمنية تمكنت من الوصول إلى مناصب بارزة في البنوك والتجارة والحكومة. فعلى سبيل المثال، كان كبار مهندسي البلاط العثماني، لعدة أجيال في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، من عائلة البليان الأرمنية. ورغم ذلك، أدى بروز وتعاظم نفوذ النخبة الأرمنية المتعلمة والعالمية إلى إثارة الشك والاستياء بين المسلمين، وفي القرن التاسع عشر، كافح الأرمن ضد فكرة أنهم عنصر أجنبي داخل الإمبراطورية العثمانية وأنهم سيخونونها في النهاية ليشكلوا دولتهم المستقلة. وكان النشطاء الأرمن الشباب، وكثيرون منهم من القوقاز في روسيا، قد سعوا إلى حماية بني جلدتهم من خلال التحريض على إقامة دولة مستقلة، فشكلوا حزبين ثوريين هما هينشاك وداشناكتسوتيون في عامي 1887 و 1890. ولم يكتسب أي من الحزبين دعماً واسعاً بين الأرمن في شرق الأناضول، الذين ظلوا إلى حد كبير موالين للدولة العثمانية، وكانوا يأملون بدلا من ذلك في أن يضغط المتعاطفون معهم في أوروبا على الإمبراطورية العثمانية لتنفيذ إصلاحات وضمان الحماية للأرمن، لكن نشاط الثوار الأرمن أجج الخوف والقلق بين المسلمين. المشاعر المعادية للأرمن وتقول دائرة المعارف البريطانية إن المشاعر المعادية للأرمن تحولت إلى أعمال عنف جماعية عدة مرات في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة، رسم لمذبحة ضد الأرمن في القرن التاسع عشر فعندما رفض الأرمن في منطقة ساسون في عام 1894 دفع ضريبة جائرة قتلت القوات العثمانية آلاف الأرمن في المنطقة. وبدأت سلسلة أخرى من عمليات القتل الجماعي في خريف عام 1895 عندما تحول قمع السلطات العثمانية لمظاهرة للأرمن في اسطنبول إلى مذبحة. وإجمالا، قُتل مئات الآلاف من الأرمن في مذابح بين عامي 1894 و 1896، والتي عُرفت فيما بعد بمذابح الحميدية. وقُتل حوالي 20 ألف أرمني آخر في أعمال عنف ومذابح في أضنة في عام 1909. تركيا الفتاة والحرب العالمية الأولى وصلت مجموعة صغيرة من الثوار العثمانيينمن جمعية الاتحاد والترقي وهي مجموعة داخل حزب تركيا الفتاة الأوسع، إلى السلطة في عام 1908. وقد رحب الأرمن بإعادة العمل بالدستور العثماني، وقد دفع التعهد بإجراء انتخابات خاصة بالأرمن وغيرهم من غير الأتراك داخل الإمبراطورية للتعاون مع النظام السياسي الجديد. ومع ذلك، أصبحت طموحات تركيا الفتاة أكثر تشدداً وأقل تسامحاً مع غير الأتراك بمرور الوقت، وازدادت شكوكهم تجاه رعاياهم الأرمن الذين ينظرون إليهم باعتبارهم متعاونين مع قوى أجنبية. وأخذت تركيا الفتاة تستبد بالسلطة وتهمش خصومها الأكثر ليبرالية على نحو متزايد، وفي يناير/ كانون الثاني من عام 1913 وصل الأعضاء الأكثر تشددا في الحزب وهم أنور باشا وطلعت باشا إلى السلطة في انقلاب. صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة، لاجئون أرمن في عام 1915 وقد ازدادت الكراهية تجاه المسيحيين عندما تعرضت الإمبراطورية العثمانية لهزيمة مذلة في حرب البلقان الأولى (1912-1913) مما أدى إلى خسارة ما تبقى من أراضيها في أوروبا، وألقى قادة تركيا الفتاة باللوم في الهزيمة على خيانة المسيحيين في البلقان. وعلاوة على ذلك، أدى الصراع إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين المسلمين شرقاً إلى الأناضول مما أدى إلى تصعيد النزاع بين المزارعين المسلمين والمسيحيين على الأرض. واستفاد الأرمن الخائفون من هزيمة العثمانيين للضغط من أجل إدخال إصلاحات، وناشدوا القوى الأوروبية إجبار تركيا الفتاة على قبول درجة من الحكم الذاتي في المناطق ذات الغالبية الأرمنية. وفرضت القوى الأوروبية في عام 1914 إصلاحاً كبيراً على العثمانيين تضمن إشرافاً من قبل مفتشين في المنطقة الشرقية، وقد اعتبرت تركيا الفتاة هذا الترتيب دليلا آخر على تواطؤ الأرمن مع أوروبا لتقويض سيادة الإمبراطورية العثمانية. وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى في صيف عام 1914 انضمت حكومة تركيا الفتاة إلى ألمانيا والنمسا والمجر ضد الحلف الثلاثي الذي ضم بريطانيا وفرنسا وروسيا. ولأن الأرمن والآشوريين عاشوا على طول الجبهة الروسية العثمانية فقد حاول كل من الروس والعثمانيين تجنيد المسيحيين المحليين في حملاتهم ضد أعدائهم. وقد اقترحت تركيا الفتاة على حزب داشناكتسوتيون، الذي كان آنذاك الحزب السياسي الأرمني الرائد، إقناع الأرمن الروس وكذلك الأرمن في الأراضي العثمانية بالقتال من أجل الإمبراطورية العثمانية، فأجاب الحزب بأن الرعايا الأرمن سيظلون موالين للإمبراطورية التي يعيشون فيها، وقد اعتبرت حكومة تركيا الفتاة ذلك الرد بمثابة خيانة. صدر الصورة،AFP وقد قاتل الأرمن في الإمبراطورية العثمانية إلى جانب العثمانيين، بينما قاتلت وحدات المتطوعين الأرمن المكونة من رعايا روس مع الجانب الروسي. "مذابح الأرمن" حاول أنور باشا صد الروس في معركة ساري قاميش في يناير/ كانون الثاني من عام 1915 إلا أن العثمانيين منوا بأسوأ هزيمة في الحرب. وعلى الرغم من أن سوء الإدارة العامة والظروف الجوية القاسية كانت الأسباب الرئيسية للهزيمة فقد سعت حكومة تركيا الفتاة إلى تبرير هزيمتها بـ "الخيانة الأرمنية" فتم تسريح الجنود الأرمن وغيرهم من غير المسلمين في الجيش ونقلهم إلى كتائب عمالية، وتم بعد ذلك قتل الجنود الأرمن المنزوع سلاحهم بشكل منهجي على يد القوات العثمانية، وهم كانوا أول ضحايا ما سيصبح لاحقاً مذابح الأرمن، وذلك بحسب دائرة المعارف البريطانية. وفي نفس الوقت تقريباً، بدأت القوات غير النظامية تنفيذ عمليات قتل جماعي في القرى الأرمنية بالقرب من الحدود الروسية. وقد وفرت المقاومة الأرمنية ذريعة للسلطات لاستخدام إجراءات أشد قسوة، ففي أبريل/ نيسان من عام 1915 تحصن الأرمن في مدينة وان في الحي الأرمني بالمدينة، وقاتلوا ضد القوات العثمانية، وفي 24 أبريل/ نيسان أمر طلعت باشا باعتقال ما يقرب من 250 من المفكرين والمثقفين والسياسيين الأرمن في اسطنبول، بينهم عدد من النواب في البرلمان العثماني، وقد قُتل معظم الرجال الذين تم اعتقالهم في الأشهر التالية، وذلك بحسب دائرة المعارف البريطانية نقلا عن مصادر المقاومة الأرمينية. صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة، أمر طلعت باشا باعتقال ما يقرب من 250 من المفكرين والسياسيين الأرمن في اسطنبول وبعد فترة وجيزة من الهزيمة في ساري قاميش، بدأت الحكومة العثمانية في تهجير الأرمن من شرق الأناضول على أساس أن وجودهم بالقرب من الخطوط الأمامية يشكل تهديداً للأمن القومي. وفي مايو / أيار من ذلك العام أصدر البرلمان العثماني تشريعاً يسمح رسمياً بالتهجير القسري، وطوال صيف وخريف عام 1915 نُقل المدنيون الأرمن من منازلهم وساروا عبر الوديان والجبال في شرق الأناضول نحو معسكرات الاعتقال الصحراوية. وقد رافق التهجير القسري، الذي أشرف عليه مسؤولون مدنيون وعسكريون، حملة قتل جماعي ممنهجة نفذتها القوات غير النظامية، وعندما وصل الناجون إلى صحراء سوريا عانوا في معسكرات الاعتقال حيث مات الكثيرون منهم جوعاً. وحسب التقديرات المحافظة فإن ما بين 600 ألف إلى أكثر من مليون أرمني قتلوا أو ماتوا خلال عمليات التهجير. وقد شهد أحداث 1915-1916 عدد من الصحفيين والمبشرين والدبلوماسيين وضباط الجيش الأجانب الذين أرسلوا تقارير حول مسيرات الموت وحقول القتل. صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة، تم تهجير النساء والأطفال فيما عرف بمسيرات الموت ويقول موقع الأرشيف الوطني البريطاني إن شهود عيان، من المبشرين الألمان و المسؤولين القنصليين من الفاتيكان وإيطاليا واليونان، كشفوا عن وقوع أعمال مروعة في جميع أنحاء الأناضول خلال الفترة المتبقية من عام 1915. ولم يكن مصير أولئك الذين نجوا من القتل الجماعي أفضل حيث لم ينج ما يقدر بنحو 400 ألف من المهجرين جنوبا حيث حصد الجوع والمرض المزيد من الأرواح، وذلك بحسب موقع الأرشيف الوطني البريطاني. أسباب ونتائج مهدت تلك المذابح الطريق للدولة القومية الأكثر تجانساً، والتي أصبحت في النهاية جمهورية تركيا الحالية. وبحلول نهاية الحرب، غاب أثر أكثر من 90 في المئة من الأرمن في الإمبراطورية العثمانية وتم محو العديد من آثار وجودهم السابق، وتم منح منازل وممتلكات الأرمن المهجورة في شرق الأناضول للاجئين المسلمين، وكثيرا ما أُجبر الناجون من النساء والأطفال على التخلي عن هوياتهم الأرمنية واعتناق الإسلام، ومع ذلك، وجد عشرات الآلاف من الأيتام بعض الملاذ في حماية المبشرين الأجانب. وذلك بحسب دائرة المعارف البريطانية. وكان للإبادة الجماعية للأرمن أسباب قصيرة وأخرى طويلة الأمد، فعلى الرغم من أن طرد وقتل مئات الآلاف من الأرمن في 1915-1916 كان استجابة فورية لأزمة الحرب العالمية الأولى ولم يكن نتيجة لخطة طويلة الأمد للقضاء على الشعب الأرمني، إلا أن أسبابه العميقة تعود إلى الاستياء من النجاحات الاقتصادية والسياسية للأرمن مما أدى إلى انعكاس التسلسل الهرمي الاجتماعي العثماني التقليدي الذي كان المسلمون متفوقون فيه على غير المسلمين، والشعور المتزايد من جانب قادة تركيا الفتاة والمسلمين العاديين بأن الأرمن عنصر غريب وخطير في داخل المجتمع. صدر الصورة،GETTY IMAGES وقد دأبت تركيا على رفض الاعتراف بأن أحداث 1915-1916 تشكل إبادة جماعية، على الرغم من أن معظم المؤرخين قد خلصوا إلى أن عمليات الترحيل والمذابح تتناسب مع تعريف الإبادة الجماعية وهي القتل المتعمد لمجموعة عرقية أو دينية. "مذبحة الأرمن" التي تحييها فرنسا وتنكرها تركيا ماذا تعرف عن "مذابح الأرمن" التي يُتهم العثمانيون بارتكابها؟ وقد اعترفت الحكومة التركية بحدوث عمليات تهجير قسري إلا أنها أكدت أن الأرمن كانوا عنصراً متمرداً كان يجب ضبطه خلال مرحلة كانت البلاد تواجه فيها خطراَ على أمنها القومي، وقد أقرت بحدوث بعض عمليات القتل، لكنها تؤكد أنها لم تكن بمبادرة من الحكومة أو بتوجيه منها. كما رفضت الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا، وصف الأحداث بأنها إبادة جماعية من أجل تجنب الإضرار بعلاقاتها مع تركيا. وقدم المسؤولون الحكوميون في تركيا في عام 2014 تعازيهم للضحايا الأرمن، لكن الأرمن يطالبون تركيا بالإعتراف بأن جرائم القتل خلال الحرب العالمية الأولىكانت إبادة جماعية.
الحصاد: منذر سليمان - جعفر الجعفري / الميادين نت تشير بيانات البنتاغون إلى تواجد 3،500 جندي نظامي في أفغانستان منذ مطلع العام الجاري، فيما تشير سجلات الخارجية الأميركية إلى تواجد إضافي لنحو 18،000 متعاقد. دخل يوم 30 نيسان/أبريل 1975 التاريخ الإنساني، منصفاً الشعوب المكافحة، ومعلناً هزيمة الولايات المتحدة في فيتنام. الأول من أيار/مايو 2021، "وَعَدت" الولايات المتحدة بأن يكون يوم بدء سحب قواتها "النظامية المقاتلة" من أفغانستان، ضمن منظومة ترتيبات وتدابير تتيح لها البقاء فيها بمسميات وعناوين مختلفة. بعد مرور 46 عاماً على أكبر هزيمة تلقَّتها واشنطن في العصر الراهن، لا يلمس المرء استفادة الأخيرة من الدروس القاسية لتدخلاتها العسكرية وقهر الشعوب. حظي إعلان الرئيس جو بايدن (14 نيسان/أبريل الجاري) انسحاب 3،500 جندي من أفغانستان بمزيج من مشاعر الارتياح الشعبي وتشكيك بعض مراكز القوى ومعارضة كبار القادة العسكريين، رافقه إعلان البنتاغون على الفور أنَّ "قوات إضافية سيتم إرسالها إلى أفغانستان" لضمان أمن القوات المنسحبة وسلامتها. تشير البيانات الرسمية للبنتاغون إلى تواجد "3،500 جندي نظامي في أفغانستان" منذ مطلع العام الجاري، وهم الذين يدور الحديث حولهم. أما سجلات وزارة الخارجية الأميركية، فتشير إلى تواجد إضافي لنحو "18،000 متعاقد أميركي وأفغاني، وآخرين من دول أخرى" في أفغانستان، "جلّهم من المرتزقة"، ولديهم كفاءات عسكرية واستخباراتية، وآخرين من القوات الخاصة، أي ما يعادل 7 أضعاف القوات النظامية. وقد أوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميللي، رؤية البنتاغون ببقاء الوجود العسكري هناك، قائلاً أمام "معهد بروكينغز" إنَّ بلاده ستحتفظ بقاعدتين عسكريتين في أفغانستان بعد الانسحاب الرسمي، وستبقي أيضاً على "عدد من القواعد العسكرية المنتشرة" داخل الأراضي الأفغانية وخارجها (أسبوعية "يو أس نيوز آند وورلد ريبورت"، 2 كانون الأول/ديسمبر 2020). كما تعهّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمام لقاء لحلف الناتو في 15 نيسان/أبريل الجاري، باستمرار "الولايات المتحدة بتمويل قدرات مهمة لأفغانستان" بعد الانسحاب الأميركي، "مثل سلاح الجو الأفغاني والقوات الخاصة، والاستمرار بدفع رواتب قوات الأمن الأفغانية". وأضاف في مؤتمر صحافي للحلف أنَّ بلاده "قد تحافظ على تواجد أميركي لمكافحة الإرهاب في المنطقة". السّؤال المركزي في إعلان الرئيس بايدن عن الانسحاب يتمحور حول حقيقة قرار "مغادرة" أفغانستان وصدقيّته، بصرف النظر عن الجدل اليومي المرافق له. وحذرت يومية "نيويورك تايمز" مراكز صنع القرار من أن الولايات المتحدة "لا يمكنها كسب حرب في أي بلد، فحلفاؤها يعانون ضعف القوة العسكرية، بينما استطاع خصومها التأقلم مع المتغيرات وراكموا قدرات عسكرية" متطورة (9 نيسان/أبريل 2021). وتتالت النصائح والتحذيرات تباعاً من أنصار الرئيس بايدن، وخصوصاً ضمن النخب السياسية والفكرية، عن ضرورة تجاوز مسألة خسارة "الحرب الأطول" والانتقال إلى مواجهة التحديات الدولية الأخرى. وقد أوضحت نشرة "فورين بوليسي" الرصينة أنَّ إعلان الانسحاب يشكّل "إقراراً، ولو متأخراً، بعدم تحقيق الولايات المتحدة نصراً" (14 نيسان/أبريل 2021). وذكّرت النشرة مراكز صنع القرار بالتجربة الأميركية المرهقة، قائلة: "بعد انقضاء 20 عاماً من الحرب التي حصدت آلاف الضحايا، يعترف المسؤولون الأميركيون بأن (حركة) طالبان أضحت أقوى عسكرياً وكثّفت هجماتها بشكل ملحوظ على مدى السنة الماضية". نشير في هذا الصدد إلى دراسة أجرتها وزارة الطاقة الأميركية في العام 2007 تخصّ أفغانستان وترصد ما في جوفها من موارد طبيعية مهمة تثير نهم سيطرة القوى الغربية. وقد قدرت قيمتها بنحو "تريليون دولار" من المعادن الثمينة، وخصوصاً الذهب والنحاس والكوبالت والليثيوم. وفي مذكرة داخلية للبنتاغون، علّقت على الدراسة بالقول إنّ أفغانستان "قد تحتلّ مركز الصدارة في معدن الليثيوم بشكل يوازي موقع السعودية" بالنفط. أيضاً، غزت الولايات المتحدة أفغانستان في العام 2001، استناداً إلى قرار رئاسي أصدره الرئيس جورج بوش الابن في 18 أيلول/سبتمبر 2001، وإرساله وحدات من القوات الخاصّة بعد بضعة أيام من الحادثة. جاء ذلك في سياق صراع سيطرة القطب الواحد على الموارد العالميّة، ولقربها من الصين وإيران وروسيا وما يمثّله ذلك من ثقل جيوستراتيجي لواشنطن، ولدورها المحوري في مرور خطوط أنابيب النفط والغاز المتجهة إلى أوروبا، وما ينتظرها من دور متعاظم في استراتيجية الصين المعروفة بـ"الحزام والطريق". وقد تموضعت القوات والقواعد العسكرية الأميركية قرب حدود خصومها الدوليين. من بين رهانات واشنطن التي أثبتت خطلها الذريع، مراهنتها على "استقطاب" فيتنام ضد الصين وتقديمها شتى العروض المغرية لقاء السماح للبنتاغون بإنشاء "قواعد صاروخية على أراضيها" (2018). واتساقاً مع توجهات واشنطن التاريخية بازدراء القوى الأخرى، تعمدت الأخيرة القفز على كل المؤشرات التي ساقتها فيتنام، وربما تجاهلتها، للدلالة على عدم رغبتها في الدخول في صراع ضد الصين، وهي التي حافظت حتى الآن على مسافة واحدة في صراع البلدين. قرار الانسحاب جاء كمحصّلة لمواقف وأولويات استراتيجية أميركية متجدّدة، حتى إنه تباين مع السردية الرسمية التي حافظت عليها المؤسَّسة الحاكمة بفرعيها العسكري والاستخباراتي، في اتهامها لروسيا بعرض مكافآت مالية على مقاتلي طالبان لقاء مقتل جنود أميركيين (2019)، وارتأى البيت الأبيض الكشف عنها، محمّلاً مسؤولية ترويجها "للأجهزة الاستخباراتية" المختلفة، بعد توصله إلى قناعة بأن مدى اليقين من تلك التهمة كان "متدنياً إلى متوسط"، ما ترجم إلى فقدان المصداقية وشروط الإسناد (بيانات البيت الأبيض 15 نيسان/أبريل الجاري). اللافت في كشف البيت الأبيض عن خطل اتهامات روسيا ونشرها عبر أبرز المنابر الإعلامية المعروفة بعدائها الشديد لها، تسريب لصحيفة "واشنطن بوست" (13 نيسان) ونشرة "ذي ديلي بيست" الإلكترونية (15 نيسان/أبريل)، معزّزة تبريرها بأنَّ أجهزة الاستخبارات الأميركية "استندت إلى اعترافات موقوفين لدى السلطات الأفغانية انتزعت خلال التعذيب، وأحدهم يُدعى ابن الشيخ الليبي". تحميل البيت الأبيض القادة العسكريين والأجهزة الاستخباراتية مسؤولية تقديمهم النصائح لمركز صنع القرار وتملصه من حقيقة تصعيد العداء لروسيا والصين، مع جملة تهديدات عسكرية ضد روسيا وإرسال قطع بحرية أميركية إلى البحر الأسود، ومن ثم انسحابها على عجل بعد توعد موسكو بحماية أراضيها، يشير إلى "اضطرار" الرئيس بايدن معارضة قرار القيادات العسكرية في المرحلة الراهنة وفي ملف محدّد على الأقل. إنَّ ما يعزّز الاستنتاج أعلاه هو خطاب الرئيس بايدن الذي بدى عليه الإعياء، وظهر كأنه ضاق ذرعاً بمماطلة القادة العسكريين وطلب منحهم المزيد من الفرص الزمنية لحسم المعركة عسكرياً، وخصوصاً لتساؤله: "إذاً، متى ستكون الفرصة مؤاتية للانسحاب؟ هل هي سنة أخرى أو سنتان أو 10 سنوات؟". كما دلّ خطابه على تجنيب البنتاغون تكرار هزيمة بلاده في فيتنام والمشهد المحفور في الذاكرة الجمعية بهروب السفير الأميركي هناك عبر طائرة مروحية وسقوطها في رحلة أخرى عن سقف مقر السفارة الأميركية في سايغون سابقاً (مدينة هوشي منه حالياً). ينقل المقرّبون إلى الرئيس جو بايدن ثبات معارضته لاستمرار التدخل في أفغانستان، بالإشارة إلى مذكّرة قدمها بخط يده للرئيس الأسبق باراك أوباما في العام 2009، يناشده فيها رفض توجه القيادات العسكرية لحشد المزيد من القوات الإضافية في أفغانستان، وخسارته أمام إصرار أوباما على التكامل مع قرار البنتاغون (أسبوعية "ذي نيو يوركر"، 14 نيسان/أبريل 2021). وأوضحت المجلَّة أنَّ الرئيس بايدن في خطابه بالانسحاب ذكّر الشعب الأميركي بأن الرئيس أوباما انتدبه في العام 2008 للسفر إلى أفغانستان والتوقّف على الأوضاع هناك مباشرة وتقديم تقييمه بذلك، وبأنه توصل إلى نتيجة مشابهة آنذاك لما أعلنه مؤخراً، مفادها أن "العملية الأميركية، كما يجري تطبيقها، مصيرها الفشل، نظراً إلى أن الوجود العسكري الأميركي اللامتناهي لن يستطيع إنشاء حكومة أفغانية قابلة للحياة أو المحافظة عليها". للدلالة على معارضة القيادات العسكرية السابقة والراهنة لخفض مستوى الوجود العسكري الأميركي، لا لإنهائه، نسوق تصريحاً للمستشار الأسبق للأمن القومي الجنرال إتش آر مكماستر، قال فيه: "قرار الولايات المتحدة الانسحاب من أفغانستان بينما تستمر طالبان في شن هجماتها الدموية ضد المدنيين والقوات الأمنية الأفغانية يشكّل استسخافاً أخلاقياً وكارثة استراتيجية" (15 نيسان/إبريل 2021). وتحفل الأدبيات الإعلامية الأميركية المختلفة بتصريحات شبيهة معظمها من المقربين من البنتاغون والأجهزة الاستخباراتية، أبرزهم القائد الأسبق للقوات الأميركية في أفغانستان ديفيد بيترايوس، ومدير الاستخبارات الوطنية الأسبق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق جون برينان... في هذه الأثناء، أصدرت الأجهزة الاستخباراتية الأميركية تقريرها السنوي حول "التهديدات العالمية" التي تواجهها الولايات المتحدة في 9 نيسان/أبريل الجاري، وفحواه رسم صورة قاتمة لمستقبل التواجد الأميركي في أفغانستان، وبأن "آفاق التوصل لتسوية سلمية ستبقى متدنية، نظراً إلى يقين قيادات طالبان بقدرتها على تحقيق انتصار". تعاظم دور تلك الأجهزة بمختلف مسمياتها في الحياة اليومية للأميركيين الَّذين "تتجسَّس" عليهم بشكل دوري ومفتوح منذ تداعيات هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. كانت أفعالها في التجسّس الداخلي غير منشورة أو متداولة لحين ذاك التاريخ، وأضحت الحواجز الأمنية والتحقيقات على الموانئ والمطارات أمراً مألوفاً ومقبولاً بعض الشيء، إذ يضطر المسافر عبر القطارات والطائرات وحافلات الباصات الداخلية إلى إبراز بطاقات هوية "رسمية" والتعرض أيضاً لتفتيش شخصي، وهي إجراءات كانت محصورة بـ"النظم الديكتاتورية" في الماضي القريب. مهّد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن غزو بلاده لأفغانستان بتحذير الشعب الأميركي من ترقّب "حملة عسكرية طويلة الأمد، وعلى نطاق لم تشهده البلاد في أي وقت مضى"، وربما ستستمر لنحو 50 عاماً، تحت مسمّى مخادع هو "الحرب على الإرهاب". وتطورت "المهمة الأميركية" إلى التصدي لتنامي القوة العسكرية لكل من الصين وروسيا ومحاصرتها، على قاعدة صراع الدول الكبرى. صوت الحكمة أتى على لسان أحد أبرز رموز العداء لروسيا والصين، وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، محذّراً مراكز صنع القرار في واشنطن من تداعيات "استفزاز روسيا والصين"، إذ يتعيّن عليها إما القبول بالمتغيرات الجارية على النظام العالمي، وإما الإيغال في تصعيد منسوب التوتر الّذي "سيؤدي إلى مواجهة مشابهة لما شهده العالم عشية الحرب العالمية الأولى". توجّه كيسنجر(1 نيسان/أبريل 2021) إلى قيادات بلاده السياسية والعسكرية والاستخباراتية، محذراً: "إن لم نستطع التوصل إلى تفاهم عملي مع الصين، فسنكون أمام وضع شبيه بما شهدناه قبل اندلاع الحرب العالمية والأولى". وكان أشدّ وضوحاً في تحذير صقور الحرب في بلاده، قائلاً: "إن كان لديكم تصور بأن العالم سيلزم نفسه بدخول صراع مفتوح الأجل، استناداً إلى بسط الهيمنة من قبل الطرف الأقوى راهناً، فإن زعزعة النظام الراهن ستكون حتمية، وتداعياته ستكون كارثية".
الحصاد DRAW: غيث العمري, روبرت ساتلوف - معهد واشنطن يبدو أن الأزمة في الأردن قد انتهت في الوقت الحالي، لكن الخلاف العلني المذهل في صفوف العائلة الهاشمية هو بمثابة تذكير بأن استقرار الأردن يحتاج إلى رعاية وليس شيئاً يجب أن يعتبره أصدقاء واشنطن أو عمّان في المنطقة أمراً مفروغاً منه. الأنباء التي جاءت من عمّان - حيث تعهد ولي العهد السابق حمزة بن حسين في نهاية المطاف بالولاء لأخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني بعد وضع الأمير في مركز شائعات عن [احتمال حدوث] انقلاب، واعتقال مسؤولين كبار سابقين آخرين - تشكل أمراً غير مألوف للغاية في هذه المملكة الشرق الأوسطية المعروفة بهدوئها والتي تقترب في غضون أسابيع قليلة من الذكرى المئوية لتأسيسها. وفي حين أنه من غير المرجح أن تظهر الصورة الكاملة قريباً، إذا ظهرت بالفعل، فإن هذه التطورات تركز الانتباه على الوضع الداخلي في الأردن وتسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الاستقرار لدى حليف رئيسي للولايات المتحدة بعد فترة من عدم الاهتمام النسبي من قبل واشنطن. المواجهة الملكية المحتملة وسط الاضطرابات الاجتماعية تختلف الإجراءات الأمنية الظاهرة التي اتُّخذت ضد الأمير حمزة اختلافاً حاداً عن الوسائل المعتادة التي تتعامل بها المملكة مع شؤونها الداخلية. وتشمل هذه الإجراءات تجريده من حراسه الأمنيين وتقييد حركته ووصوله إلى خطوط الاتصال والإنترنت. وتظهر أحياناً أخبار التوترات داخل العائلة الهاشمية المالكة، لكن غالباً ما يتم حلها بسرعة وبهدوء بعيداً عن أعين الجمهور. على سبيل المثال، في عام 2017، أعفى الملك عبدالله اثنين من إخوته - أخيه الشقيق فيصل وأخيه غير الشقيق هاشم - من مناصبهما القيادية العسكرية، مما أثار شائعات عن وجود خلاف داخل الأسرة. ومع ذلك، امتثل كلا الأميرين للإعفاء، مما أدى إلى القضاء على المزيد من الشائعات. وكانت قد وقعت حادثة مماثلة في عام 1999 حين أعاد الملك حسين تغيير تراتبية الخلافة قبل أسابيع قليلة من وفاته من مرض السرطان، فاستبدل شقيقه حسن، الذي كان ولياً للعهد منذ عام 1965، بابنه البكر عبدالله، الذي كان حينذاك ضابطاً عسكرياً. وعلى الرغم من الصدمة والضربة الشخصية القوية اللتين تلقاهما الأمير حسن، إلّا أنه لم يحتجّ على ذلك التغيير وعبّر دائماً عن دعمه العلني لابن أخيه كعاهل الأردن. وفي الواقع، يحتاج المرء إلى العودة إلى الأيام المتوترة التي أعقبت اغتيال مؤسس المملكة، عبدالله الأول، عام 1951، ليجد أي سابقة للأمراء الأردنيين الذين يعلنون عن نزاعاتهم علناً - وحتى في ذلك الحين لم يكن هناك حديث عن التخطيط لانقلاب. والأمير حمزة هو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الحالي والإبن الأكبر من زواج الملك حسين من زوجته الرابعة الملكة نور. وعند اعتلاء عبدالله الثاني العرش عام 1999، قام بتعيين حمزة ولياً للعهد بناءً على رغبة والدهما المحتضر. وقيل أن الملك حسين كان متعلقاً كثيراً بحمزة، الذي اشتهر بالتقوى والتواضع والتواصل مع قبائل الأردن. ولكن بعد خمس سنوات، نزع عبدالله هذا اللقب عن حمزة ومنحه لابنه الأكبر حسين - وهذا ليس بالأمر غير المألوف بالنظر إلى أن الملك الراحل حسين عيّن ثلاثة ولاة للعهد خلال فترة حكمه. ولم يعترض حمزة علناً على القرار في ذلك الوقت، لكنه وضع نفسه لاحقاً كشخصية متعاطفة وصورة رمزية للإصلاح بين الأردنيين المستائين من الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وخاصة العناصر القبلية الساخطة. وفي البداية، سعى المسؤولون إلى التقليل من أهمية التصرفات الأخيرة للأمير حمزة، التي بدت من بعيد كأنها تقع في مكان ما داخل المنطقة الرمادية بين الانتقادات العلنية والخطوات العملياتية لتنفيذ انقلاب. لكن هذا الوضع تغيّر حين أصدر رسالتين مصوّرتين في 3 نيسان/أبريل، إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية. ووصفت مقاطع الفيديو هذه القيود التي فرضها رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية على تحركاته واتصالاته، وثم انتقد الفساد وسوء الإدارة في المملكة، حيث ادّعى أنها استمرت فترة دامت "بين خمسة عشر وعشرين عاماً" - أي طوال فترة حكم الملك عبدالله وقرار عزله من منصب ولي العهد. وفي أعقاب هاتيْن الرسالتيْن، تبنت الحكومة الأردنية لهجة أكثر صرامة تجاه حمزة، حيث اتهمه وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده في 4 نيسان/أبريل بـ "تصرّفات ... تستهدف الأمن والاستقرار في البلاد". ثم زاد الأمير حمزة بعد ذلك من حدة التصعيد بتعهده علناً بأنه "لن يمتثل" لأوامر [الجيش] بعدم التواصل مع العالم الخارجي. ولتجنب أي صدام مباشر قد يشوّه صورة النظام الملكي، عرض العاهل الأردني على حمزة سبيلاً بديلاً للمصالحة وفقاً للتقليد البدوي المعروف بالصُلحة، وعهد إلى عمه حسن، الذي يحظى باحترام كبير، بتولي المناقشات الحساسة. وأسفرت هذه المساعي عن عقد اجتماع بين كبار الأمراء في منزل حسن، حيث وقّع حمزة على رسالة استثنائية تعهد فيها بالولاء لعبدالله وولي العهد الحالي حسين، جاء فيها: "في ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك". ويبدو أن هذا التنازل يشير إلى انتهاء الحلقة الراهنة [من الخلافات بين الجانبين] على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون الفصل الأخير من الصراع بين الأخوة غير الأشقاء. ومع أن المواجهة غير مستبعدة في النهاية، فحتى هذه ستنتهي على الأرجح برحيل حمزة عن البلاد بدلاً من سجنه وتحويله إلى شهيد للمعارضة. وأعلن المسؤولون أيضاً عن اعتقال باسم عوض الله وحسن بن زيد مع "ستة عشر إلى ثمانية عشر" شخصاً آخر، معظمهم من مساعدي حمزة ورجال الأمن. وعوض الله، الوزير السابق والرئيس الأسبق للديوان الملكي، هو شخصية مثيرة للجدل واسمه مرتبط بالفساد في ذهن الكثير من الأردنيين. ويتمتع هو وبن زيد - إبن حفيد الملك عبدالله الأول وحفيد رئيس وزراء سابق - بعلاقات واسعة في المنطقة وعملا في أوقات مختلفة كمبعوثيْن خاصّيْن للملك الحالي إلى السعودية. وأدت هذه الروابط، إلى جانب التأكيدات الرسمية المتكررة حول الاتصالات مع "جهات خارجية"، إلى إثارة شائعات بأن دولاً أخرى في المنطقة قد تكون متورّطة في الأزمة. وتأتي هذه الأحداث وسط أجواء متوترة تعيشها المملكة على الساحة المحلية. فوباء "كوفيد-19" ينتشر بكثرة في البلاد حيث بلغت عدد الإصابات 633,000 وعدد الوفيات 7,201 حالة [حتى بداية هذا الأسبوع] في بلد يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة، لتصبح بذلك نجاحات الحكومة الأولية في احتواء الوباء مجرد ذكرى بعيدة. وقد تضرر الاقتصاد الأردني، الذي يعاني بالفعل بشدة من الوباء، حيث سُجّلت معدلات بطالة قياسية في نهاية عام 2020، كما أن معدلات الفقر ازدادت بنسبة 39 في المائة خلال العام الماضي. أما الثقة في المؤسسات العامة - مع استثناءات ملحوظة للنظام الملكي والقطاع العسكري/الأمني - فهي متدنية جداً بسبب التصوّرات المنتشرة حول عدم الكفاءة والفساد. وتفاقمت هذه النظرة بسبب سلسلة حوادث مأساوية تُعزى إلى التقصير في أداء الواجب العام خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد وفاة العديد من مرضى "كوفيد-19" في مستشفى حكومي جديد في الشهر الماضي بسبب عدم توفّر الأكسجين. وفي حين لم تحظَ دعوات التظاهر خلال الأسابيع القليلة الماضية بمشاركة واسعة - ويعود ذلك إلى حدٍّ كبير إلى الإجراءات الأمنية الوقائية - إلا أنها أثارت مخاوف من تأجج الاستياء الشعبي تحت السطح. وطوال هذا الوقت، كان يُنظر إلى حمزة على أنه قد وضع نفسه بصورة المتعاطف مع هذه المخاوف وكنقيض للعاهل الأردني. التداعيات المحلية والإقليمية على الرغم من أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات قاطعة، إلا أن بعض الأنماط المألوفة قد بدأت بالظهور. فعادة ما تميل التهديدات المحلية الخطيرة في المملكة إلى إنتاج ديناميكية "التجمع حول الراية". وعلى غرار التفجيرات التي قام بها تنظيم «القاعدة» [لثلاث] فنادق في عمان عام 2005 والهجمات الأخيرة لتنظيم «الدولة الإسلامية» ضد الأردنيين، يتم استخدام قضية حمزة لإحداث تناقض حاد بين حقيقتين، هما: الظروف الأقل مثالية بل المستقرة التي تُميّز حالياً الحياة في المملكة، والفوضى التي ميّزت البلدان المجاورة منذ "الربيع العربي". كما أن الرسائل الرسمية قد سلّطت الضوء على صِلات حمزة المزعومة مع المعارضين الأردنيين في الخارج، وكثير منهم فقدوا مصداقيتهم علانية. وتشير الأدلة السردية إلى أن هذه الرسائل تلقى صدى لدى نسبة كبيرة من الشعب. وبالفعل، لم تُعرب أي شخصية عامة بارزة تقريباً عن دعمها علناً لحمزة باستثناء والدته. وعلى الرغم من أن هذا الموقف قد كشف عن عداوة هاشمية تتأجج منذ زمن بعيد، إلا أن الأمر قد ينتهي بتخفيف الضغط المحلي على البلاط الملكي على المدى القريب من خلال تحويل الانتباه بعيداً عن "كوفيد-19" وغيره من التحديات الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، تبقى مصادر الاستياء الكامنة التي استغلها حمزة حقيقية، وستعاود الظهور حتماً مرة أخرى في المستقبل إذا لم تعالجها عمّان. وتشمل هذه قضايا طارئة مثل الوباء العالمي، فضلاً عن القضايا الأكثر هيكلية مثل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاحات الحوكمة الأوسع نطاقاً. وكما حدث في الماضي، من المرجح أن تشهد التداعيات المباشرة لقضية حمزة تعزيز قطاع الأمن على حساب الإصلاح، كما يتضح من الدور المركزي الذي لعبه رئيس الأركان العامة اللواء يوسف الحنيطي في عزل الأمير. ومن الممكن أيضاً أن يبْطِل هذا الوضع تأثير الرسالة التي وجّهها العاهل الأردني في 17 شباط/فبراير وحظيت بتغطية إعلامية كثيفة إلى رئيس دائرة المخابرات العامة بشأن تقليص دور هذه المؤسسة النافذة في بعض المجالات الاقتصادية والسياسية. وحتى قبل اندلاع الأزمة في بداية هذا الأسبوع، كانت الحكومة الأردنية قد أغلقت أساساً منصة الدردشة الشعبية "كلوب هاوس" لمنع الانتقادات غير المرغوب فيها عبر الإنترنت. وعلى الصعيد الخارجي، غالباً ما شكى المسؤولون الأردنيون من أن الدول المجاورة وواشنطن تعتبر الأردن من المسلّمات. وتحوَّل هذا الشعور إلى خوف في عهد إدارة ترامب، التي حافظت على مساعدات كبيرة للمملكة، لكن كان يُنظر إليها على أنها غير مهتمة بآراء عمّان بشأن السياسات في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ويبدو أن أحداث بداية هذا الأسبوع قد ذكّرت العديد من العواصم بأن التطورات المحلية في الأردن يمكن أن تلعب دوراً مركزياً في الأمن في المنطقة. وعبّرت السعودية بسرعة عن دعمها للعاهل الأردني والتزامها باستقرار المملكة، وتبعتها دول عربية أخرى. وبالمثل، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الملك عبدالله بأنه "شريك رئيسي" يتمتع "بالدعم الكامل" من إدارة بايدن. وإذا كان الماضي أي دليل، فسيكون هذا الدعم السياسي مقدمة لدعم مالي متجدد وحتى موسّع من قبل أصدقاء الأردن، وخاصة في منطقة الخليج - التي هي شريان حياة رئيسي محتمل وسط الركود المستحث الناجم عن وباء "كوفيد-19" في البلاد. وفي هذا السياق، يجب على عمّان التعامل بحذر مع اتهاماتها التي لا أساس لها حتى الآن بشأن ضلوع جهات خارجية مهمّة بالمؤامرة المزعومة. فمن بين البلدان التي تم تناقل أسمائها - السعودية، والإمارات، وإسرائيل - ليست هناك مصلحة لأيٍّ دولة منها في زعزعة استقرار الأردن، ولا يمكن أن تكون أيٌّ منها قد اعتقدت أن مؤامرة رديئة قائمة على أمير ساخط وحفنة من مساعديه ربما تستطيع الإطاحة بعبدالله المحصّن. وإذا أوصلت الادعاءات المحددة بشأن عوض الله وبن زيد إلى أدلة دامغة على تواطؤ مسؤولين سعوديين في مثل هذه المؤامرة، سيكون هذا الأمر مضراً لعلاقات الولايات المتحدة مع الرياض. ومع ذلك، فمع انعدام مثل هذا الدليل، من الضروري أن يتجنب الأردن تحويل علاقة متقلّبة بين العائلة المالكة السعودية ونظيرتها الهاشمية إلى ضربة دبلوماسية كاملة، لا سيما بالنظر إلى الدعم المالي والسياسي الحاسم الذي تقدمه الرياض لجارتها الأفقر بكثير. التداعيات على السياسة الأمريكية لطالما كان استقرار الأردن أداةً قيمة لتعزيز المصالح الأمريكية في المنطقة، بدءاً من توسيع السلام العربي-الإسرائيلي وإلى مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية». ولذلك، على المدى القريب، يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في التعبير عن دعمها الحازم للأردن وحث حلفائها - الدول العربية وإسرائيل وغيرها - على التعبير بشكل ملموس عن هذا الدعم. إن قيام مكالمة هاتفية بين الرئيس بايدن والملك عبدالله ستبعث رسالة قوية لتحقيق هذه الغاية. يجب على واشنطن أن تعمل أيضاً مع عمّان على التحقق من أي أبعاد خارجية جوهرية للأزمة، فإما توضح تلك الأبعاد أو تقضي على شائعات قد تكون ضارة. وفي هذا الصدد، يمكن لمدير "وكالة المخابرات المركزية" الأمريكية ويليام بيرنز - الذي كان السفير الأمريكي السابق في الأردن - أن يلعب دوراً مفيداً. وفي الوقت الحالي، يجب أن تتمثل الأولوية في مساعدة عمّان على تخطي هذه الحادثة بما يضمن الاستقرار. ولكن بالتوازي مع هذا الجهد - وحتى أكثر من ذلك - فبمجرد انحسار القلق الأولي بشأن قضية حمزة - يتعين على واشنطن إشراك عمّان بصورة غير علنية في تسريع سعيها للإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاحات الحوكمة، مع الحفاظ على وتيرة تدريجية وسهلة القبول للتغييرات الجوهرية. ووفقاً لبعض التقارير نقلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مثل هذه النصيحة في محادثة أجرتها مع وزير المالية الأردني محمد العسعس في 1 نيسان/أبريل؛ ينبغي على المسؤولين الأمريكيين الآخرين فعل الشيء نفسه. إن الاهتمام وحده على مستوى رفيع من واشنطن والدعم المناسب من الأصدقاء الآخرين، يمنحان عمان فرصة لإجراء إصلاحات ضرورية أعمق لحماية المملكة من تكرر نوبات عدم الاستقرار، والتي يمكن أن تؤثر سلباً وبمرور الوقت على المصالح الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

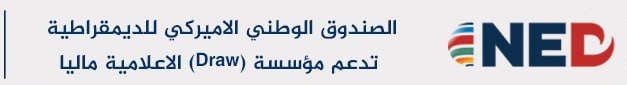
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.JPG)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)